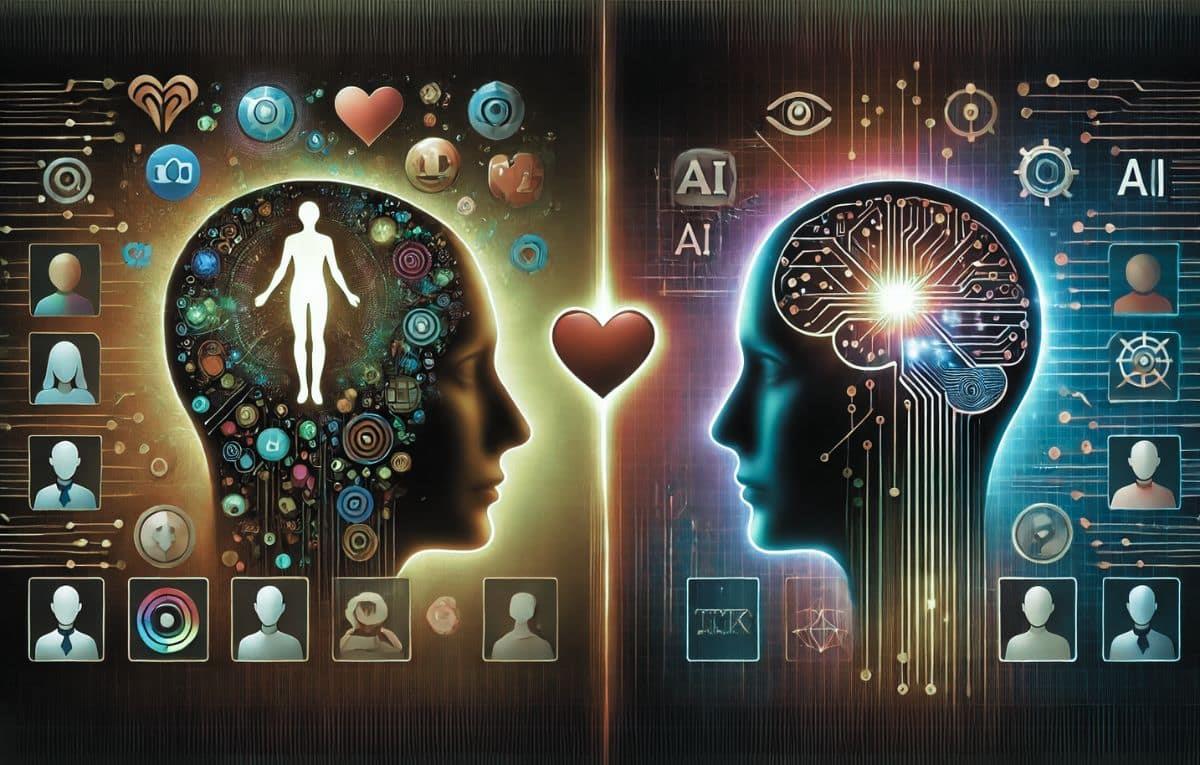عبر مسار طويل ومتشعّب، بدا ذات مرة (لبرهة خاطفة) أن شبكات التواصل الاجتماعي الرقمي باتت إعلاماً عاماً، بل بديلاً للإعلام المؤسساتي الذي بدا مثقلاً بتاريخ من التشابك (بعضه تواطؤ، بل أكثر)، مع الأنظمة الحاكمة والثقافات السائدة.
بدت لحظة انهيار الإعلام العام التقليدي أمام الشعبوية الصاعدة أميركيّاً وأوروبيّاً، كأنها لحظة موت مأسويّة. لكن الأمر لم يدم. ابتدأ الأمر بأن ناءت الـ «سوشال ميديا» باستفادة الإرهاب الإسلاموي منها، سواء للتجنيد أو لإنجاز العمل الإعلامي المستكمل لضربات الإرهاب وأيديولوجيا «التوحش» المعلن في أيديولوجيا «داعش»، وآبائها «النصرة» و «القاعدة». هرعت حكومات إلى شركات الـ «سوشال ميديا»، فدخلت معها في فالس غير مبهج. وعلى إيقاع موسيقى القيود وضرورة التصدي للمحتوى المحرض على الإرهاب والتطرف والعنف، تخبّطت شركات الـ «سوشال ميديا» في مهمات بدت مستحيلة. كيف يمكن معرفة الحد الفاصل بين ضرب حرية الرأي عندما تكون مرفوعة إلى حدود عالية، وبين التطرف والإرهاب؟
وبعد تجارب طويلة، لم تستطع تقنيات الذكاء الاصطناعي (خصوصاً «تعليم الآلات» Machine Learning)، أن تنجز تلك المهمات الهرقليّة العسيرة. وفيما الصراع مع التجنيد الإرهابي عبر الـ «سوشال ميديا» في اشتعال، جاءت الضربة المذهلة من واشنطن: روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسيّة 2016 إلكترونيّاً عبر الـ «سوشال ميديا» التي كانت أداة لمجموعات منظّمة ومتمرسة، للتلاعب بآراء الجمهور الأميركي. وبفضل الذكاء الاصطناعي، شُرّح الجمهور إلى أصناف وأنماط، جرى استهداف الأقرب منها إلى تأييد ترامب.
ثمة تذكير واجب عن الطريقة التي جرى فيها ذلك الاستهداف الذي ما زال يؤرق المؤسسة السياسية الأميركية بأكملها في مسلسل لم تنته فصوله بعد. جرى الأمر عبر نسج مدروس لمجموعة من الحسابات لأفراد ومجموعات صغيرة. وعملت تلك الحسابات على بث أخبار عبر الـ «سوشال ميديا» من النوع الذي يلاقي هوىً عند من عانوا من الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد الأميركي، ومن يملكون خلفيات من الحساسية المفرطة حيال المهاجرين والملونين والمثليين والمنادين بالحريات الجنسية وغيرها.
واستأجرت تلك المجموعات أيضاً مساحات إعلانية على «سوشال ميديا» لنشر أخبارها، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات إعلامية كـ «قناة روسيا». وسرت الرسالة كنار في حقل هشيم جاف: التلاعب بالـ «سوشال ميديا» أمر أكثر من مستطاع، وهي شبكات لنشر «الأخبار الكاذبة» والفبركات الإعلاميّة وما إلى ذلك.
أبعد من «أخبار كاذبة»
بعد أن اتضحت سهولة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سلاحاً للتلاعب بالجمهور، صار الحديث عن تحول الـ «سوشال ميديا» إعلاماً عاماً، شيئاً من الماضي، يثير الحسرة والابتسام سويّة. وحاول «فايسبوك» أن يقاوم خروجه من كونه إعلاماً جديداً. وجرت صياغة تحالفات مع مؤسّسات إعلام تقليدية وشركات من الـ «سوشال ميديا»، لفصل زؤان «الأخبار الكاذبة» عن قمح الأنباء والتغطيات الموثوقة. وجرت تجربة «العلم الأحمر» الذي يفترض به أن يفضح إفك الزيف. لكن، عبثاً. ذهبت أدراج الريح تلك الجهود. ببساطة، ليس هناك مركز معيّن (أو أكثر) يبث أخباراً كي يمنع، ليس هناك حتى من نمط كي تجري متابعته. هناك تواصل ضخم بين مئات ملايين البشر على مدار الساعة، ويفتح ذلك الأمر مجالاً أمام احتمالات شتى.
ودلت السابقة الروسيّة (التي تكررت في شكل أقل في غير بلد أوروبي) على أنّ من يملك إمكانات ضخمة في التقنية الرقمية، يستطيع فعل أشياء كثيرة للتأثير في الآراء المتبادلة عبر الشبكات.
بغض النظر عن الخلاصات النهائيّة، أدت المعطيات السابقة إلى إنهاء تجربة تحوّل الـ «سوشال ميديا» إعلاماً عاماً. أقرّ مارك زوكربرغ بالأمر الواقع، بعد أن لاحظ تدنيّاً في الإقبال على شبكة «فايسبوك»، خصوصاً في قطاع الشباب. وبكلمات لا لبس فيها، أعلن فيها أن «فايسبوك» يعود إلى عمله الأول باعتباره مساحة لتبادل أخبار العائلة والأصدقاء والجيران. وكذلك أعلن أنه سيعتمد على المؤسّسات الإعلاميّة التقليدية الموثوقة في الأخبار التي يقدمها «فايسبوك» لجمهوره، وهو تسليم واضح بعدم قدرته على أن يكون بديلاً لها.