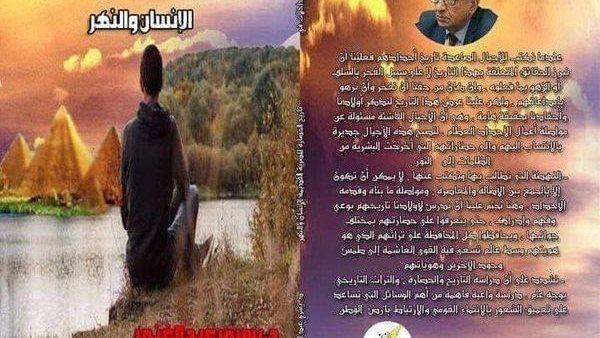ونكتشف بفضل هذه الرؤية الشاملة للمسيرة الإنسانية كيف ساهمت الأركيولوجيا في معرفة شتى المجتمعات، سواء تلك التي كانت تستعمل الكتابة أم التي لم تعرفها أصلا، وكيف مهدت لإقامة حوار جديد بين المصادر النصية والمصادر المادية، كان من أثره إعادة النظر في كثير من المسلمات المتداولة، واكتشاف ملامح تاريخية أخرى كانت مجهولة. مثلما نكتشف أن الإنسان العاقل Homo sapiens ليس وحيدا، بل سبقه بشر آخرون، لولاهم ما كان ليبلغ ما بلغه، إلى جانب نقاط أخرى طالما ظلت حكرا على أهل الاختصاص، ونعني بها فرضيات الاستيطان في القارتين الأميركيتين وأستراليا، والظاهرة العالمية لشيوع العصر الحجري الأخير (النيوليتي) وأثره في منظومات التفكير التي لا نزال نعيش عليها حتى الآن.
وقد شمل الكتاب كل مناحي الوجود البشري منذ ظهور الإنسان ثم خروجه من أفريقيا لغزو العالم، مرورا بالمجتمعات الزراعية في الشرق الأوسط وأستراليا والصين وسواها، وفتح حقول دراسة ومقاربة جديدة لعلم الآثار، بالاستفادة مما تحقق في علم الوراثة وعلم جينات العصور القديمة، واستعمال “الدرون”، ووسائل الاستشعار من بعد، أو بتجديد أساليب التأريخ وأثر الأركيولوجيا في المجتمع.
والمعلوم أن الأركيولوجيا الحديثة ترتكز على ثلاثة مبادئ هي: استخدام التقنيات المتطورة كالحاسوب الذي يستعمل للتحليل البياني والإحصائي للمعلومات، والاستعانة بالوسائل الفضائية والأرضية لدراسة حياة القدماء وتوسيع علوم البيئة الأثرية وتوضيح الأسس المعيشية والاقتصادية في مجتمعات ما قبل التاريخ وما بعده؛ تحديد الحضارات بواسطة منظومات متطورة؛ توثيق العلاقة بين علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) وعلم الآثار (الأركيولوجيا)، ودورهما في دراسة أشكال الاستيطان عبر العصور وتبين المتناظرات الاثنوغرافية، إضافة إلى تتبع مسيرة حياة الإنسان في شتى مراحلها عبر التاريخ.
ومجمل القول إن كتاب “قصة الحضارات” يبين لغير العارف أن غاية الأركيولوجيا ليست البحث عن آثار فنية مدهشة أو أنصاب بديعة، وإنما هي معرفة المواقع والمجتمعات السابقة عبر علامات محفوظة في الأرض منذ الآثار الأولى للحضور البشري إلى العصر الحجري، أي منذ ما لا يقل عن خمسمئة ألف عام قبل التاريخ إلى يوم الناس هذا، بفضل مقاربة تقوم على دراسة التقنيات وأنماط العيش والعلاقات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الاستيطان، ما يسمح حتى بتبين التطورات المناخية، وتحولات المشهد العام وما يطرأ على النباتات من تغيير.
لا جدال أن “الأركيولوجيا أصبحت، بفضل الوسائل التقنية التي اعتمدتها لوضع تأويلات المنظومات الاجتماعية وتطورها، علما معاصرا لا غنى عنه لفهم تاريخ العالم”، كما ذكر جان بول ديمول في مقدمة الكتاب، ولكن كيف السبيل إلى بلوغ تلك الغايات النبيلة الهادفة إلى رسم خارطة صحيحة عن تطور الوجود الإنساني عبر العصور، من خلال الحفر الأركيولوجي عن دقائق آثاره في مختلف القارات، والإنسان لا ينفك يدمّر حتى البادي منها، سواء بشن الحروب وإزالة مواقع أثرية برمّتها.
كما حصل خلال العدوان الأميركي على العراق، أو العدوان الفرنسي البريطاني الأميركي على ليبيا، أو بتحطيم كل ما له صلة بالتاريخ بتعلات عقائدية زائفة كما حدث في تدمر بسوريا ومدينة الحضر بالعراق وتماثيل باميان في أفغانستان، على سبيل الذكر لا الحصر، لأن التدمير شمل المواقع جميعا؟ وما مدى نجاعة الأركيولوجيا الوقائية في بلدان تشهد دمارا متواصلا، إما بسبب الحروب وإما بسبب جشع الشركات العملاقة التي لا تنفك تدمّر البيئة وما تكتنزه من آثار الشعوب القديمة، بموافقة الحكومات في أغلب الأحيان؟
لقد كان من غايات الكتاب إقامة الدليل المادي بأن للبشرية قاطبة جذرا واحدا، وأن ما يقرّبنا أكثر مما يفرّقنا، وأن من الحكمة الإقرار بأن أصلنا واحد وقدرنا واحد؛ ولكن الواقع الملتبس، الطافح بالعنف والعدوان في بقاع كثيرة من الأرض، يخالف ذلك، حتى لكأن قدر الأركيولوجيا أن تبحث في ما خلّفه الإنسان بعد الدّمار.