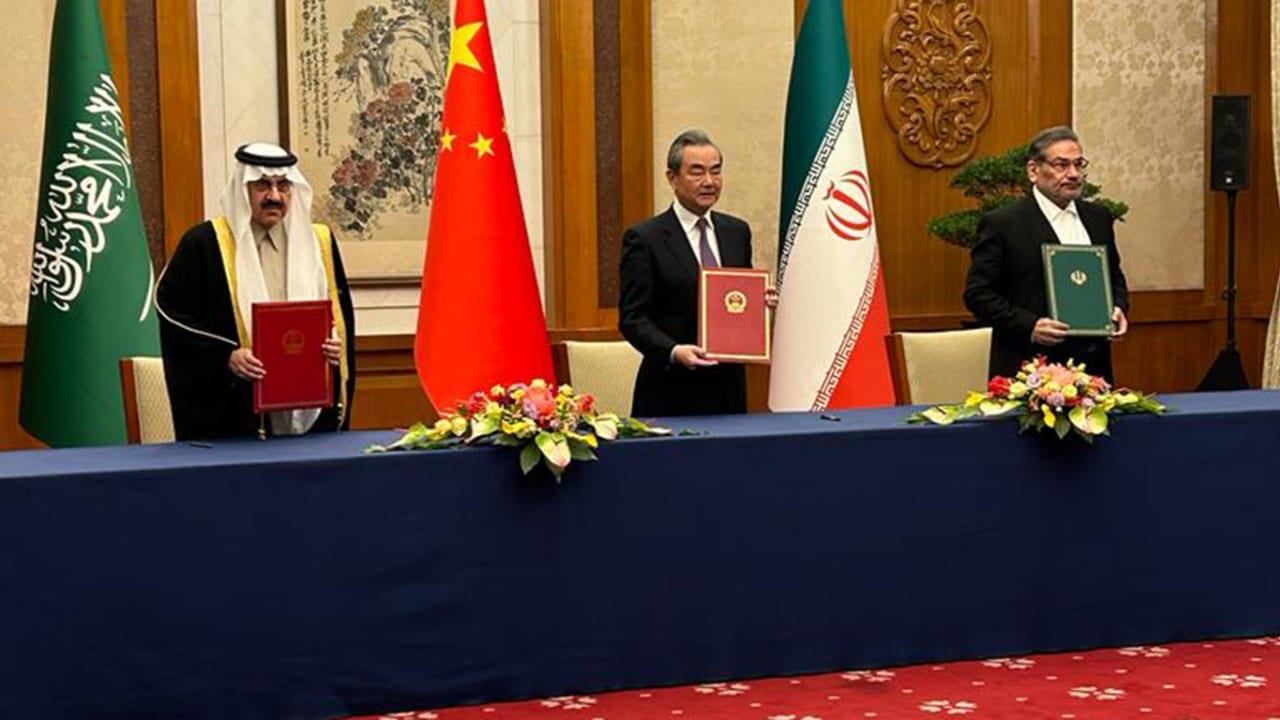لا أظن أن هناك مثقفًا لا يعرف شيئًا عن محاكمة سقراط، باعتبارها المحاكمة الأشهر في تاريخ الفكر: محاكمة الفكر نفسه، الذي لا يزال يتكرر حتى الآن في عالمنا المعاصر. ولذلك لا يكاد يخلو كتاب في تاريخ الفلسفة اليونانية من ذكر هذه المحاكمة، كما أن كثيرًا من الكتابات العامة في حرية الفكر والتعبير غالبًا ما تشير إلى هذه المحاكمة، بل إن هناك العديد من الكتابات المتخصصة في تناول هذه المحاكمة ذاتها، سواء تلك الكتابات من المصادر القديمة المجايلة لفترة هذه المحاكمة أو تلك الكتابات المعاصرة التي تخوض في تفاصيل هذه المحاكمة، وملابساتها، وأسبابها، وسياق عصرها السياسي والاجتماعي والديني.ليس في وسعنا هنا، ولا من أغراضنا في هذا المقام، أن نخوض في مثل هذه التفاصيل التي يمكن أن نجدها على سبيل المثال في كتاب I. F. Stone بعنوان: «محاكمة سقراط»، فنحن لن نستعين هنا إلا ببعض الأمثلة أو الوقائع الجزئية التي ربما تكون دالة وموحية في استخلاص دلالة كلية أو عامة. السؤال الذي يشغلنا إذن، هو: ما الذي يمكن أن نضيفه هنا في هذه العجالة إلى مثل هذه الكتابات. فما يهمنا هنا في المقام الأول هو تأويل معنى الحدث، أعني: محاولة استنطاق دلالته ومغزاه، من خلال بعض التساؤلات.
أسباب
المسألة الأولى هنا تتعلق بأسباب المحاكمة، لأن الوقوف على السبب الحقيقي هنا، يمكن أن يُطلعنا على السياق السياسي والديني والاجتماعي الذي يحكم العصر. كانت التهمة الموجهة إلى سقراط هي «الإساءة إلى دين الدولة، وإفساد عقول الشباب». وهنا نتساءل: هل التهمة هنا سياسية أم دينية اجتماعية؟! إن كتاب «ستون» Stone عن «محاكمة سقراط» يأخذنا إلى العديد من التفاصيل هنا وهناك، لينتهي بنا إلى ما أراد أن يثبته منذ البداية، وهو تبني تأويل سياسي لهذا الحدث، استنادًا إلى أن فكر سقراط كان معاديًّا لسياسة الديمقراطية التي تمثلت في مدينة «أثينا» التي عُرِفت بدولة المدينة Polis، وربما يكون هذا هو الأصل البعيد لمفهوم «الدولة المدنية». ولا شك عندنا في أن سقراط كان ميالًا إلى الحكم الديكتاتوري الذي ينفرد فيه بالسلطة الأكثر علمًا ومعرفة، وليس الأكثرية أو مجرد الأقلية. ولكن تلميذه أفلاطون وآخرين يشاركونه أيضًا في هذا التوجه السياسي، ولكنهم لم ينالهم ما نال سقراط من عقوبة الإعدام. ومع أن البعد السياسي ينبغي أن يؤخذ هنا بعين الاعتبار، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن البعد الديني للمحاكمة.
والحقيقة أن سقراط لم يصدر عنه أي فعل فيه ازدراء لمؤسسات الدولة، أو دينها، ولم يكن ملحدًا كافرًا، كما زعم من رفعوا الدعوى ضده للقضاء، ولذلك فقد نفي سقراط في دفاعه تهمة الفجور وتعليم الكفر بالآلهة، إذ قال على لسان أفلاطون في محاورة «الدفاع»: «ولكن الواقع غير هذا، فعقيدتي في الآلهة قائمة على شعور أسمى جدًّا مما تقوم عليه عقيدة أي مدع من المدعين» (محاورات أفلاطون، ترجمة: زكي نجيب محمود، ص. 70).. ولذلك فإن دوافع محاكمة سقراط لم تكن في حقيقتها تتعلق بالألوهية ونظام الحكم، وهذا يعني أن محاكمته في النهاية كانت محاكمة للرأي في مجتمع ديمقراطي كان لا يليق به محاكمة الرأي. ومع ذلك فقد جرت وقائع المحاكمة وفق الأسلوب الديمقراطي، فانقسمت الأصوات، ورجحت قليلًا كفة المؤيدين لحكم إعدامه على كفة المعارضين له. وقد كفل له القضاء وفقًا لقانون أثينا أن يُعفى من عقوبة الإعدام إذا قبل عقوبة النفي أو دفع الغرامة التي كان أصدقاؤه ومريدوه على استعداد مسبق للتكفل بها، إلا أنه رفض ذلك كله. كما أنه رفض أن يطلب من اللجنة القضائية تعديل الحكم بعقوبة بديلة، قائلًا: «إن تسمية العقوبة يتضمن في حد ذاته اعترافًا بالذنب». ولما صدر عليه الحكم نهائيًّا بالإعدام، تم تخييره في طريقة تنفيذ هذه العقوبة، فاختار الإعدام بأن يتجرع السم بنفسه. وجدير بالذكر هنا كذلك أن سقراط قد رفض أيضًا عرضًا بتهريبه خارج حدود البلاد، بحيث لا يمكن تعقبه، كما تقضي بذلك قوانين الدولة. ولا شك أن هذا كله يدعم وجهة النظر القائلة بأن سقراط قد حوكم محاكمة ديمقراطية عادلة وفقًا للقانون، وأنه كان قادرًا على أن يستفيد من إجراءات المحاكمة في كل خطواتها، ولكنه لم يفعل ذلك، بل كان يستعلي في ردوده على الهيئة القضائية.
شواهد
إن الشواهد على ذلك عديدة في دفاع سقراط عن نفسه، كما صوره أفلاطون في محاورة «الدفاع»، فهو يقول في معرض رده على مبدأ استرحام هيئة القضاء أو طلب العفو: «ودعوكم من العار، فيلوح لي أن في استرحام القاضي واستجدائه العفو في مكان إقناعه وإنبائه بالنبأ الصحيح خطلًا، فليس واجب القاضي أن يمنح العدالة منحًا، بل عليه أن يحكم حكمًا عادلًا، وقد أقسم أن يحكم وفقًا للقانون، دون أن يميل مع الهوى، ولا يجوز له ولا لنا أن نتعود الحلف باطلًا، فلا أحسب في ذلك شيئًا من الورع أو التقوى» (المصدر السابق: نفس الموضع). ولا شك أن هذا الموقف من جانب سقراط يعبر عن شجاعة عظيمة، ولكنه لم يخل من نبرة استعلائية على هيئة المحكمة، توحي ضمنًا بأنه «راعي الفضيلة والحكمة»، وهو ما كان سقراط يؤمن به بحسب ما أنبأته كهنة معبد دلفي التي نقلت إليه رسالة إلهية مفادها أنه أحكم الناس وأكثرهم معرفةً وخُلقًا. رفض سقراط إذن اقتراح عقوبة النفي في أسوأ الحالات، وعقوبة الغرامة المناسبة في أفضلها، بينما كان من الممكن لهذا الاقتراح كما يقول ستون Stone أن يكون مقبولًا لو أن سلوك سقراط جاء مُرضيًا إزاء المحكمة: فلم يكن مطلوبًا من سقراط أن يُبدِي خضوعًا ذليلًا، ولا توسلًا مهينًا، بهدف استجداء الشفقة، وإنما أن يتحدث بلهجة أقل تعظيمًا للذات، وكان يمكن للقليل من سحر سقراط أن يأتي بأثر طيب. ونحن نعلم أن المحاكم الأثينية كانت تشتهر بالخطابة الرشيقة وبما يثير الشفقة. («محاكمة سقراط»: ترجم نسيم مجلي، ص. 218).
كل ذلك صحيح، ما في ذلك شك. وإذا أضفنا إلى ذلك أن سقراط نفسه كان يمثل روح التشدد الأخلاقي والصرامة العقلية، وهي الروح التي كان يعتبرها نيتشة مسؤولة عن ذبول الحضارة اليونانية، باعتبارها معادية لروح الفن والإبداع المتحرر من صرامة العقل، فإن هذا كله يؤدي بنا إلى عدم التعاطف مع سقراط. ولكنني هنا في هذا المقال لا يشغلني «سقراط/ الشخص»، ومن ثم لا ينبغي أن تشغلنا إجراءات محاكمته التي تعددت رواياتها وتفاصيلها، وإنما ينبغي أن ننشغل في المقام الأول بحقيقة هذه المحاكمة باعتبارها أشهر محاكمة للرأي في عالم القدماء، سواء تمثل هذا الرأي في فكر ديني أو في فكر سياسي. فمحاكمة الرأي هي في النهاية محاكمة للفكر، ومن ثم يمكن اعتبار سقراط هو أول ضحايا حرية الفكر والتعبير. ولو أن سقراط قد احتج بهذه الحجة وحدها: وهي أن محاكمته غير عادلة، لأنها محاكمة لحرية التعبير، واستشهد في دفاعه بأن ذلك يتعارض مع التقاليد الأساسية لأثينا: دولة المدينة.. لو أنه فعل ذلك، لاستطاع بسهولة أن يؤثر في هيئة المحكمة. ولكن ما منعه من ذلك هو أن هذا الدفاع سوف يكون بمثابة دفاع عن الديمقراطية التي يحتقرها. لا يعنينا موقف سقراط الآن، فقد أفضنا القول فيه. ما يعنينا هنا هو أن هذه المحاكمة تظل في النهاية هي المحاكمة الأولى والأشهر باعتبارها محاكمة للفكر، ومن ثم محاكمة للعقل ذاته، أعني: العقل الذي لا يميل إلى تقبل الفكر الآخر أو يعاديه، والذي يظن دائمًا إنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وهذا هو الأصل في كل نزعة أصولية. وربما يثير دهشتنا أن هذا قد حدث في عصر لا تزال تحكمه الديمقراطية، فهل يا ترى أكان هذا نذيرًا بشكل آخر غير ما رأى نيتشه من أفول الحضارة اليونانية التي انحدرت تدريجيا بعد قرن من الزمان؟ هل تكون محاكمة الرأي نذيرًا دائمًا بأفول أية حضارة؟!
تطبيق
ذلك هو السؤال. وهو سؤال يستدعي عندنا سؤالًا أهم: ما الذي يمكن أن نستفيده من مجمل تأويلنا السابق؟ كيف نطبق ذلك على وضعنا الراهن اليوم؟ فلا شك أن هذا التطبيق هو ما يمكن أن يؤسس الفهم باعتباره غاية التأويل، أعني: ضرورة فهم معنى واقعة تاريخية ما، باعتباره معنى يمكن أن يتواصل بأشكال متنوعة في مختلف العصور، بما في ذلك عصرنا الراهن. وخلاصة تأويلنا في هذا الصدد ما يلي:
لا يمكننا الفصل بين ما هو سياسي أو ديني؟ فبهما معًا يتأسس البعد الاجتماعي الشامل الذي يحكم الحدث أو الظاهرة الإنسانية. إن ماهية السياسي والديني تكمن في السلطة، أو بمعنى أدق في الصراع على السلطة: فالسلطة السياسية تتبادل دور الهيمنة عبر التاريخ مع السلطة الدينية، وكلاهما يحكمه مفهوم «الهيمنة». ولذلك فإن المجتمعات المتطورة في عالمنا الراهن، هي المجتمعات التي تحررت من مفهوم «السلطة»، فعرفت كيف تتحرر من سلطتي الدين والفن معًا، ومن أية سلطة أخرى. وربما يكون هذا التصور «طوباويًا»، لأن «السلطة» موجودة دائمًا في كل عصر وأوان باعتبارها «ضمانة» لتسيير أمور الحكم والدولة، ولاستقرار المجتمع الذي يلتزم بالقانون الذي تشرِّعه السلطة، ولكن «السلطة» حينما تعبر عن نفسها في شكل «قمع الفكر وحرية الرأي والتعبير»، فإن هذا يكون نذيرًا بأفول الدولة أو الأمة التي تمثلها تلك السلطة. ذلك أن تطور المجتمعات الإنسانية هو في النهاية تاريخ من تحرر الفكر والإبداع في مواجهة أي سلطة. ذلك هو طريق الخلاص لأي أمة تريد تنهض من غفوتها.
ذلك ما حدث في عصر سقراط وأفلاطون، حينما اهتزت قيم الديمقراطية الأثينية، وحينما غلَّب الساسة والحكام مصالحهم الشخصية، حتى إن أحد زعماء حكومة «الطغاة الثلاثين» قد رفع شعار «تطهير المدينة»، وسن قانونًا يسمح للحكومة بمحاكمة كل من يعارضها. وقد كان هذا نذيرًا بأفول عصر، وظهور مدارس فلسفية صغرى لا تهتم في المقام الأول سوى بتعليم الفرد ما يمكن أن يحقق له السعادة العملية في الحياة. ولقد بلغ هذا القمع ذروته في العصور الوسطى، ويكفي استرجاع ما جرى من إعدامات للفلاسفة والعلماء من أمثال جيوردانو برونو الذي سبق أن كتبت مقالا عنه في «الاتحاد الثقافي» وإن أردنا شاهدًا على ذلك من تاريخنا العربي، فلننظر في محاكمات بدأت بالشيخ الإمام محمد عبده، ومرورًا بمحاكمة الشيخ على عبد الرازق،ومحاكمة طه حسين عن كتابه في «الشعر الجاهلي»، ومن بعده فرج فودة، وانتهاءًا بنصر حامد أبو زيد، مع الفارق البعيد بين المكانة الفكرية لهؤلاء الأولين العظام ومكانة هذين الآخرين وغيرهم.
ما يهم في النهاية هو أن نعتبر من هذا كله بأن نؤمن بأن حرية الرأي والفكر هي طريق خلاص المجتمعات والدول التي تطمح في أن تنهض، باعتبارها مجتمعات إنسانية بحق، قادرة على أن تحيا في عالمنا الراهن من خلال الفكر والإبداع.