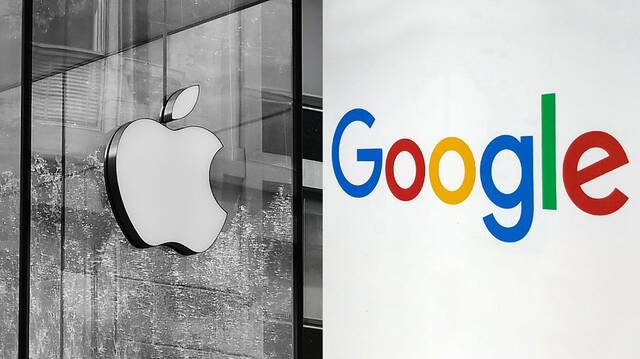يحيلنا صبحي موسى منذ الوهلة الأولى لروايته إلى حقول السيموطيقا عبر العنوان المفارق: "صلاة خاصة"، والذي يستدعي تساؤلات قلقة حول ماهية هذه الصلاة، وهل هناك صلاة خاصة، وصلاة عامة، أم أنه يحيلنا إلى حقول المجاز عبر حدائق اللغة التى تنحو إلى الإيمان وعالم الفضيلة واليقين، والجنة والنار، وغير ذلك مما يستدعيه العنوان، وعبر الرواية – ذات القطع الكبير والتي تصل صفحاتها إلى ما يربو من خمسمائة وخمسين - ونجد الإجابة عن ماهية هذه التساؤلات في آخر سطور الخاتمة على لسان البطل: "لقد آمنت بما قاله بنيامين لتلميذه أنطونيوس من أن كل كتابة هي صلاة خاصة لكاتبها" (الرواية: ص 355).
وعندئذ تتجلي المفارقة، وتتفكك شيفرات النص السيميولوجى للعنوان الذي يحمل إدهاشية أولى للقارىء. والرواية تغوص – بعمق باذخ – في المسألة المسيحية / القبطية، وتطوف بنا عبر ردهات الكنائس والأديرة لتكشف عن جانب للتصوف المسيحى (الرهبنة) لعالم الراهبات والقساوسة، والشمامسة، كما تكشف عن العالم السري للأديرة، والخلافات والصراعات والانقسامات التي يشهدها هذا العالم المسيحي / اللاهوتى / الإنجيلي، والمتمثل – عبر رؤاه – في رأس الكنيسة المصرية وأديرتها، وما يحدث داخلها من صراع على السلطة: رئاسة الدير، الكرسي الرسولي، كرسي البابوية، وما يتمخض عن ذلك من ظلم وتعذيب يفضي إلى حد القتل، وإلقاء المخالفين للتعاليم من خلف الجبل الشاهق، حيث الذئاب والصحراء، وحيث الحكومات التي تهاب الاقتراب، أو التدخل في أمور الكنيسة باعتبار هذه أمور قبطية كنسية تخص المسيحيين والمجمع المقدس، وكأنها – كما صورها – دولة داخل الدولة، أو أنها السلطة الروحية التي لا يجب المساس بها، أو الاقتراب منها!
إنه عالم الواقعية السحرية، حيث أجاد الكاتب رسم صور أبطاله، وتصوير الدير الأسطوري / الواقعي / التاريخي / الآني، وعوالمه عبر المثيولوجيا الدينية المتمثلة في تلك السلطة المتشددة، والتي لا تتفق كذلك مع الإيمان وعظات القساوسة الذين يفقهون الناس، ويتصارعون في الخفاء لأمد يصل إلى حد الجريمة، والشلح من المنصب، وعقد المؤامرات غير ذلك.ولعمري، كيف يصلي القساوسة، ويراهم الناس طواويس النور والأمل وهم يتبركون بالصليب وبالمسيح وبمريم العذراء، وبالإيمان النقي أمام العامة، بينما نراهم – في الرواية – يمارسون العداء في الخفاء، ويقومون بأعمال الخطيئة التي ربما لم تخطر على بال الشرير (الشيطان)، وهذا التطرف والصراع يظهر كمّ التشدد، لا التسامح، والخطيئة، وليس الاعتراف، ويظهر للقارىء الجانب المظلم / التاريخي للأديرة عبر العصور، والاضطهاد والتصارع بين كنيسة السكندرية في مصر، والكنائس الأوروبية في أنطاكيا وروما وغيرها من الكنائس القديمة، كما تظهر بجلاء كذلك وجود إيمان حقيقى لدى بعض القساوسة والرهبان ورفضهم للأمور الدنيوية، وربما كان باخميوس، وأنطونيوس، ودانيال، ودميانة، والأم تريزا، وغيرهم من أبطال الرواية أبرز المثل لصفاء الإيمان المسيحي، مقابل الجلادين والقتلة أمثال: يوساب، يؤانس، والرجال ذوي القامات الطويلة أولئك الذين تدربوا في معسكرات الكشافة ليقوموا بدور قتالي فيما بعد ضد السلفيين المسلمين المتطرفين أيضاً، لتقع البلاد في الفتنة الكبرى، وصراع المذاهب والأديان العنصري: "لقد رغب ثاؤفيلوس في تقوية نفوذ الكنيسة على الأديرة والرهبان، وكانت الأديرة القائمة في الصحارى البعيدة قد تأثرت بديانات الوثنيين الذين دخلوا المسيحية، فاستبدلوا المسيح بآلهتهم، وأخذوا يجسدونه على أشكال شتى، ما بين تماثيل من صخور وأحجار، وما بين رسومات على الأبواب والجدران، وكان ثاؤفيلوس دارساً لكتابات العلامة أوريجانوس ومحاوراته مع الهراطقة، فرفض تجسيد المسيح، موقناً أن ذلك تشبّه بالوثنية" (الرواية ص: 492).
وللحقيقة، فإننا أمام ثلاث روايات – هنا – لا رواية واحدة فحسب، ولقد استطاع / صبحي موسى ببراعة شديدة أن يحكم مسيرة السرد، ويمزج التاريخي بالواقعي والفني، ويسرد لنا الصراع بين الأقباط ومذاهبهم، فالكنائس الشرقية لا تنضوي تحت تعاليم الكنائس الأوروبية، والصراع قائم – طوال الوقت – بين البطريرك في روما، وبطريرك الكرازة المرقسية، وكنيسة الإسكندرية، وان لم يذكر تسمية للكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت والأرمن، إلا أنه صرح برموز وأسماء – ربما تكون معروفة مصرياً وعالمياً - وصولاً إلى القس ساويرس، والأنبا شنودة، وأحداث دير المحرق الحديثة، وكذلك أحداث المطرية، والصراع والتشدد المذهبي بين السلفيين والنصارى في الصعيد، ومحاولات نشر الفتنة الطائفية على الدوام، وما كان من مسألة محاولة قتل دميانة (انجيل) – كما أسموها لاخفائها من السلفيين الذين حاصروها وأرادوا تزويجها من أحدهم، أو حرقها وقتلها لولا تدخل العمدة ورجال الشرطة وشباب المسلمين المعتدلين، رغم فقدها للذاكرة بعد هروبها من محاولات قتلها خارج الدير من قبل يوساب ورجاله، والنجدة التي جاءتها عند ظهور الكلب السماوي الذي طالما تجلى لها أثناء عملها كمحققة في دير الملاح، حيث رفضت كتابة تقرير ضد الراهب أنطونيوس فدبر لها يوساب مؤامرة لقتلها، وكان من قبل قد قام بشنق أستاذه باخميوس في قلايته بعد أن زادت سلطته الروحية في الكنيسة، وقصده الشعب كراع وطبيب، على الرغم من اعتقاده وإيمانه بتعاليم أورجانيوس – ذلك المصلح الكبير الذي أراد تخليص الكنيسة من آراء الهراطقة والوثنيين.
إنه الصراع السلطوى للكنيسة، ليتحول الصراع بين الكفر والإيمان، وبين الآخرة والمطالب الدنيوية مصورين للناس أنهم رسل الرب بينما بين أنفسهم يخفوا خبايا نفوسهم الشريرة.
ولقد نجح الكاتب في مزج الأسطوري بالواقع عبر حكايات اللبؤة وأولادها تلك التي تموت وتستيقظ، وتظهر وتختفي، والكلب السماوي مثلها، وتجلي المسيح ومريم العذراء لأشخاص عبر المثيولوجيا اللطيفة المبهرة التي تشيع أجواء التدين والقداسة والرهبنة، والتصوف المسيحي وغير ذلك.
كما أصاب الكاتب في تصوير العشق الروحي لعلاقة أنطونيوس الراهب بالمحققة دميانة، وما كان من أمر الحب الخالص بينهما، فبعد أن صلى وصام وتأهب للنوم يراها في الحلم /عارية / يتشهاها، وتتجلى الخطيئة عبر الشرير في الحلم، لكن السرد البديع لقصة العشق والهيام قد أكسب تعاطفاً للقارىء وتشاركية روحية مع قصتهما، كما تتجلى جماليات الوصف والتصوير لتجعلانك في قلب الأحداث مباشرة، يقول: "ألقى بجسده الطويل على السرير المبنى من أحجار الهضبة، واستسلم لرطوبة الهواء القادم من فرج النافذة الوحيدة في قلايته، ما أن غمس عينه في بئر النوم اللذيذ حتى رأى المحققة دميانة متجسدة أمامه، رآها واقفة بقدها الممشوق كرمح منتصب في وجه الريح، لم يستطع أن يمنع نفسه من تمرير عينيه على هذا الفرع من الجاذورين الواقف في مواجهته، تمهل قليلاً أمام صدرها المكور كثمرتى باذنجان شهيتين أسفل فتحة صدر تنبىء بمنحدر عظيم، لوهلة قاومت عينه رؤية الانحدار، لكن الشرير أقنعه بإلقاء نظرة واحدة للتعرف على ما قد تخفيه الملابس الصوف السميكة فرفض بورع وإباء، رفض بقوة، وهو مغلق عينيه حتى سمع صوت جرَار السوستة ينطلق من مكانه، حين فتحهما وجد دميانة تخرج من ملابسها كيوم ولدتها أمها، وجد عينه تستقر على بطن كطشت الخمير الفائر، مغطية على دلتا ذات مستنقع ملىء بالعشب الأسود الكثيف، في تلك اللحظة كان جسده قد انفرط من هول المفاجأة، وشعر أن ملابسه الداخلية انغمرت بفيض سائل لزج كثيف، انتفض من نومه واضعاً يده على سرواله وأعضائه موقناً غير مؤمن: كان غضبه من نفسه يزداد كلما شعر أن لديه رغبة فى إعادة استحضار المشهد، لم يكن نافراً مما رأى، وشعر لوهلة أنه كان يتمنى أن يمتد الحلم ساعة أخرى، شعر أنه شخص عاشق للرذيلة، ولن يصيبه خبز الرب ببركته" (الرواية: ص: 21-22).
إنه العشق الأشهى، عبر الحلم الذي راوده منذ رؤيتها وهي تحقق معه، فهو إنسان في كل الأحوال، وإن ترهبن أو تنسك، يحس ويشعر رغم كونه عابدا في محراب الله، يهرب من رغبات الجسد إلى ملذات الروح، ولكنها إنسانيته، المرأة، حواء التي يحتاجها آدم فيترك الجنة ويأكل التفاحة، فكيف ينكرون عليه الحب والعشق، والمسيحية أتت لنشر الحب، وكأنه يذكرنا بقول الشاعر العربي الجميل: قالوا أحب القس سلامة
وهو التقي الورع
فالحب ليس جريمة، والعشق والهيام، وتمنى امرأة في الحلم والواقع، ولكنها تقاليد الرهبنة، والكنيسة التي ترفض ذلك، وكأن الرهبنة نقيض الإنسانية، ولكنه اختار الرهبنة طواعية لا كراهة، وعليه أن يتخلص من الخطيئة بالاعتراف والعودة لطريق الروح بعيداً عن متطلبات الجسد الشاقة والشائقة أيضاً.
ولقد قسم الكاتب روايته – فيما أحسب – إلى ثلاثة أقسام متساوقة، وجعلها تسير في خط متواز، تخالفي، متسلسل، دون أن تتقاطع، وكأننا أمام ثلاث روايات لا رواية واحدة – فحسب -، وقد خالف هارموني التسلسل التشويقي للسرد المألوف، وأحالنا إلى رواية متشظية، تركبية، تغايرية، لمسيرة السرد وهارمونيته التزامنية، فهنا يتقاطع التاريخي مع الواقعي الآني، ويختلف الزمني النسبي التغايري، وكأنه تحقيب للزمنية عبر الأجزاء المتتابعة / المتقاطعة، وكأننا نقف أمام ثلاث روايات منفصلة / غير متتابعة هارمونياً، لكن يجمع خيط الموضوع:
الرواية الأولى: تجسد حكاية انطونيوس ودميانة في دير الملاح.
الرواية الثانية: رسائل، وهي في تسلسلها تمثل رواية بذاتها، وتتقاطع في متن الرواية الأم، لكنها تحمل التاريخ والتعاليم الإيمانية لتاريخ الكنائس القبطية في العالم.
الرواية الثالثة: حكايات الرهبان في كنيسة الإسكندرية، وكنيسة أورشليم، وكنائس روما وأنطاكيا، وحكايات البطاركة والمهرطقين، والأريوسيين، ومواقف اثناسيوس مع البطريرك قسطنطين في روما، وما كان من ديمتريوس، وفرمليانوس وخروجه من كيبادوكيا، واضطهاد الإمبراطور ساويرس، ورسائل اسطفانوس وغيرها، حتى يصل بنا إلى البابا شنودة – الآن – بل إلى قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011.
ومع أنك تستطيع أن تقرأ كل قسم / رواية على حدة منفصلة عن سابقتها بأحداثها وشخوصها وحكاياها وقصصها وعوالمها المثيرة، فأنه خالف تراتبية السرد المعهود ليحيلنا عبر الواقعية السحرية إلى معادلات التاريخ والواقع معاً فتشتبك الزمكانية بين كل قسم لتمثل جسداً ومعماراً شاهقاً للمسألة المسيحية برمتها، وهنا نلمح قصدية الراوي العليم في مزج الماضى بالحاضر، والتأريخ عبر أدب الرسائل والسيرة / وعبر ما هو تخييلي، وإحالات إلى الحاضر وتلك لعمرى مسيرة مرهقة للتأريخ لواقع العالم المسيحي – من منظور أدبي / فني / واقعي وتخييلي وفنتازي أحياناً، فقد أحالنا إلى أقباط مصر من خلال "جمعية الأمة القبطية" التي أسسها صلاح متري – والد دميانة – وزوج الأم تريزا، والذي كان يطمح لتصحيح المسار داخل الكنيسة المصرية رغم اعتماده على تعاليم ورسائل أورجانوس والتي يحاربها غير المصلحين الباحثين عن منافع دنيوية، إذ أن متري كان ينادي بتعميق الإيمان المسيحي وتنقيته مما شابه من هرطقات عبر المناطقة، والقساوسة والوثنيين وغيرهم.
ولعمري، كان المؤلف ذكيا، إذ صدر روايته بعبارة: "إن أي تشابه بين الأسماء والأحداث المذكورة في هذا العمل وبين الواقع ماهو إلا محض مصادفة"، ليخرج – فيما أحسب – من أي مسائلة لسطوة الكنيسة، باعتبار هذا شأن قبطي، ولا يجوز الخوض فيها أمام العامة، أو المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى انحيازية الكاتب لتصوير المجتمع الاسلامي / السلفي بالتشدد والعنف والظلامية، حتى مع وجود شخصيات تؤمن بالوحدة الوطنية والتعايش كالأسرة المسلمة التي أخفت دميانة من هؤلاء المتشددين، ودفاع العمدة والشباب المسلم عنها، فالسلفيون هنا لا يختلفون عن طوال القامة الذين دربهم القس يؤانس في معسكرات الكشافة للاستعداد لقتال المسلمين السلفيين حسبما تتحسن الظروف، فبالغ في وصف المتشددين المسلمين، ولم يظهر عداوة أو نفورا من أصحاب القامات الطويلة الذين يقومون بالقتل والبلطجة.إنها رواية ساحرة، تتقاطع فيها الشخصيات والأحداث لكنها تسير في خط رأسي متتبعا تخالفية للسرد غير مدربة على الذائقة المصرية، وإن استعملت عند كثيرين كذلك – لكنها تحتاج إلى قارىء ناقد، خاص، مثقف، عليم، متثاقف، وتلك لعمري جوهرة الرواية ونقيصتها في ذات الوقت، وكأنه أراد بهذا الخلط المتثاقف التاريخي الواقعي الفني الخروج من المأزق الكبير تجاه المسألة المسيحية برمتها فتجىء على شكل فني تاريخي تخييلي، وكأنها ممسوسة مموسقة يمازج فيها بين كل أولئك لنقف أمام جبل مسيحي إنجيلي قبطي شاهق، ورواية تمزج بين الواقع والسحر عبر هارموني السرد التخالفي، غير التراتبي، المهش والمثير، والجميل أيضاً.
ولقد استطاع صبحي موسى بحذق تطويع اللغة واستعمالاتها ليحيلنا إلى السموق الباذخ عبر معمار اللغة الشائقة / الشيقة / الشاهقة / السلسة التي تخش إلى داخل عقل وروح القارىء لتحدث تشاركية تعاطفية مع الشخوص، والحكايات التي تشبه مغامرات موشاة بأسطورة عبر دهاليز الحنين والحب والإيمان، كما استطاع أن يحكم معمار وشكل روايته / رواياته الثلاث، ويخرجها لنا بشكل متأنق عبر أسلوبية غير زاعقة، وعبر مواقف إنسانية يصفها بروعة مغايرة، فنتمثل الجمال عبر قصة الحب بين أنطونيوس الراهب العاشق ودميانة - المحققة – التي تذوب شوقاً لروحه المتطلعة نحوها، وحيث العشق يسقط الرهبنة ليتضام الجسدان / الروحان في حكاية أشبه بالمستحيل، يتقاطع فيها ما هو حالم بما هو تخييلي، ويتمازج السحري مع الواقعي والأسطوري، وتتلاقى الحقيقة مع اليقين، والتاريخانية مع الروحانية، ونراه بمهارة يعمد كل ذلك بلغة روحية صوفية، ويمسح على أجسادنا وعقولنا بزيت جاذبية سرده الباذخ فلا نترك الرواية إلا بعد أن نشارف نهايتها، وكأنه يجمع هنا بين التفكيكية للأحداث، والتركيبية للمواقف والفصول، والتجانسية للسرد المكتنز الذي يشي بالتاريخ، وبجماليات الوصف وانتقالاته البديعة، فكأنك أمام بحر لا ساحل له من التفاصيل والحكايات الفرعية والجزئية التي تميز هارمونية السرد المتنامي / المتقاطع، ولا تملك هنا – كقارىء إلا أن تتعاطف مع قاطع الطريق / أنطونيوس العاشق الذي تحول إلى راهب معروف بوساطة الإيمان، ثم عشقه لدميانة وخروجه عن تقاليد الرهبنة التي يمكن أن تعرضه للشلح والطرد من الدير.