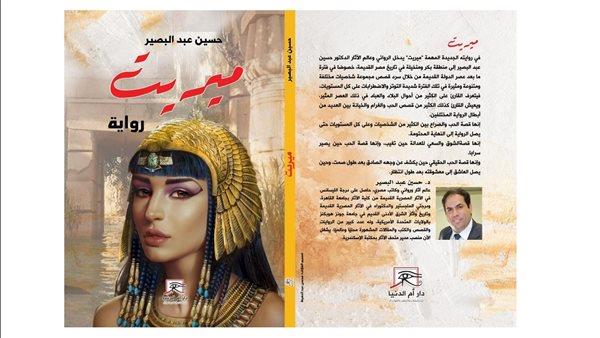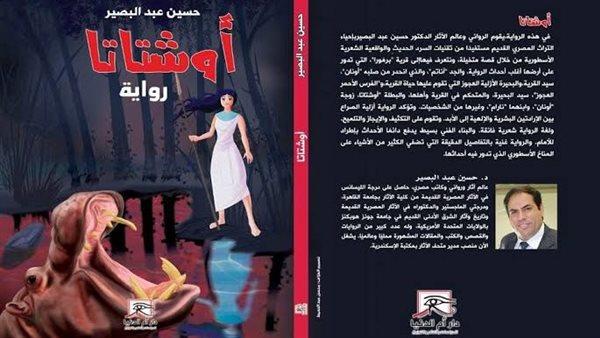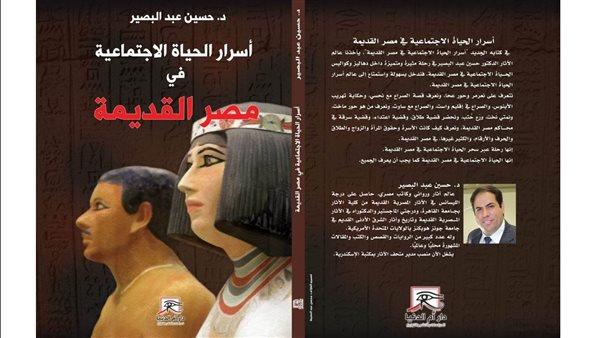أقف على حافة الشاطئ ناظرًا إلى مياه الإنر هاربر «الميناء الداخلى» بعمق فى ظلام الليل الذى يكاد أن يكسو الأفق بكثافة محاولاً تذكر لقائى الأخير مع حبيبتى وزميلتى فى الجامعة، إليزابيث جاك، أو ليزا كما يحلو له أن أناديها.
تتلاطم أمواج المحيط الأطلنطى على المدى البعيد ثم تنكسر بحدة قبل أن تقترب من شاطئ مدينة بلتيمور. فى تلك الليلة التى فارقتنى فيها قبل رحلتها الأخيرة إلى المقر الرئيس للقوات البحرية الأمريكية فى مدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ميريلاند، فى طريقها للمشاركة فى القوات الأمريكية المقاتلة فى العراق.
أطيل النظر إلى معالم المدينة التى خلفى، أراها جميلة صغيرة أسيرة مستسلمة عاشقة للمحيط، وكأن بينها وبينه عشق أزلى، غير أننى حزين لغياب حبيبتى عنى.
أستعيد تفاصيل اللقاء معها. أتذكر عينىّ ليزا الخضراوين وسط وجهها المستدير وهما تدمعان بشدة لفراقى. التقمت يديها الرقيقتين أقبلهما بشكل محموم فأنا لا أريد أن أتركها تفارقنى أبدًا إلى أرض العراق حيث شبح الموت الذى يخيم هناك.
يتطاير شعر ليزا الأصفر المفروق من المنتصف مع هبات الهواء القادمة من ناحية الميناء فى جوف الليل، أمشط شعرها بيدى.
تميل ليزا بخدها على كف يدى. تنام على كفى كقطة صغيرة تتمسح بصاحبها البار بها. لا أقوى على مفارقتها لثوانٍ، فسبحان الذى ألهمنى الصبر على أن أتركها ترحل إلى بلاد بعيدة تاركة الولايات المتحدة الأمريكية ومخلفة وراءها قلبى المشتعل بحبها الكبير بقوة وروحى التى يأكلها الشوق الذى ليس له حدود لها، ويزداد كلما بعدت عنى.
تترك ليزا يدىّ وأحضانى والدموع تنهمر من عينيها. تغادر شاطئ الميناء عائدة إلى المدينة فى طريقها كى تركب الأتوبيس الذى يقلها إلى أنابوليس. تنظر إلىّ بينما تسير بظهرها لا تريد أن تفارق مخيلتها صورتى، تريد أن تكون صورتى آخر ما ينطبع فى ذاكرتها.
فى نفس اليوم والموعد من كل أسبوع، أجىء وحيدًا إلى مكان اللقاء والفراق كى أتذكر كل تفاصيلهما حتى أصل إلى آخر لمسة ونظرة بيننا فاستقل أتوبيس جامعة جونز هوبكنز عائدًا إلى منطقتى التى لا أخرج منها كثيرًا، منطقة تشارلز فليديج، حيث توجد شقتى الصغيرة بالقرب من الجامعة.
يقترب وجهى الأسمر من وجهها المستدير الذى يتوسط شعرها الأشقر. أدقق النظر إلى عينيها الخضراوين فى ذلك المطعم الصغير الكائن فى منطقة الإنر هاربر، تمسك يدى بيدها البيضاء المشربة الحمرة، أتراجع برأسى الكبير إلى الخلف فتقع عيناى على بوستر كبير معلق على الحائط إلى اليمين، يظهر فيه النجم ألفيس بريسلى، بسترته المعروفة، ضاحكًا، أطيل النظر إليه.
فتدير بيدها وجهى ناحيتها فى حنو ورقة. نبتسم. يتقدم النادل نحونا سائلاً:
– ماذا تريدان للعشاء؟
أطلب سندويتش برجر من الحجم الكبير وهى آخر من الحجم الوسط وزجاجتين من المياه الغازية وبعضًا من البطاطس المقلية على الطريقة الفرنسية والكوول سلو والكاتشب والمايونير والمستردة الحارة وقطع ثلج.
كانت هذه هى المرة الأولى التى أواعد فيها ليزا على الحب.
كم كنت أود أن أواعدها من قبل لولا ترددى وخوفى من أن تصدنى رغم أننى كنت أحس أنها ميالة لى، نحضر المحاضرات معًا، نقضى وقتًا كبيرًا فى المذاكرة فى المكتبة وحدنا، أغرق كثيرًا فى عينيها وأذوب فى نظراتها. نهمل المذاكرة بعض الوقت.
ننظر فى عينى بعضنا البعض، نترك المكتبة، أسير بجوارها فى الشارع، أرافقها إلى شقتها التى تسكن فيها وحيدة، فى شارع سان بول، ليس بعيدًا عن الجامعة. أتمنى أن تلمس يدى يدها أو أن أحتضنها.
أظن أنها ترغب فى ذلك أيضًا. تغلق باب المنزل الذى تقيم فيه وراءها بينما وجهها لا ينزل من على وجهى. أبقى واقفًا أنظر إليها. تقف هى أيضًا خلف الباب لا تريد أن تفارقه، أريد أن تدخل معها إلى شقتها، لكنها لم تطلب منى الدخول، ولا أنا جرؤت على ذلك الطلب، نبقى على ذلك الوضع فترة طويلة. وفى النهاية، ألوح لها مودعًا.
تبدو حزينة على فراقى. تودعنى بتلويحة من يدها. أتراجع بظهرى إلى أن تغيب عن عينىّ العاشقتين. أغادر فى طريقى إلى شقتى الموجودة فى نفس الشارع، ليس بعيدًا عن شقتها.
تنحدر حبيبتى الجميلة من ولاية تكساس، كانت قد درست مرحلة الليسانس فى جامعة براون فى مدينة بروفيدنس فى ولاية رود آيلاند.
جاءت إلى جامعتى كى تحصل على درجة الدكتوراه مثلى. ومنذ أن وقعت عيناىّ عليها لا تريد أن تفارقها. ماذا حدث لى؟! لا أعرف.
لم تكن هذه هى المرة الأولى فى حياتى التى أرى فيها بنتًا جميلة مثل ليزا، لكن شيئًا ما شدنى إليها. ربما نظرتها الحالمة؟ ربما رقتك المفرطة؟ ربما جمالها الفطرى الأخاذ الذى لم أره كثيرًا بين الأمريكيات اللائى صادفتهن من قبل؟ ربما سحر وجمال بنات تكساس والجنوب الذى لا يُقاوم؟ ربما.
جاء النادل اللاتينى بالطعام. يعد هذا المطعم من بين أفضل المطاعم التى تقدم البرجر فى الولايات المتحدة الأمريكية. تقضم من ساندويتشها بهدوء.
يتمايل شعرها الطويل الكثيف أينما تحرك وجهها. عندما تبتسم تظهر غمازتاها المثيرتان، مضفيتين جمالاً على جمال خديها الناعمين. تأخذنى ضحكتها إلى عالم آخر. أنسى مصر ودراستى والسياسة والشعر والأدب والسينما. أنسى كل شىء. ولا أصدق أننى على الأرض وفى الولايات المتحدة! هل قامت القيامة؟ هل دخلت الجنة؟
أتساءل كيف إذن يكون جمال الحور العين؟ من كثرة غيابى وذوبانى فيها. تخجل وتنادى علىّ:
-عادل، أين أنت؟! لماذا لا تتكلم؟!
أفيق على صوتها. وأبدأ حديثًا ليس له معنى عن الدراسة والمستقبل وفرص العمل بعد الحصول على الدكتوراه من جامعتنا العريقة.
فجأة تأخذنى الشجاعة والحماسة وأقف وسط المطعم وبحركة مسرحية وبصوت عالٍ لا أعلم من أين جاءنى أقول:
– أحبك يا ليزا. أحبك ولا أستطيع العيش دونك.
يصفق رواد المطعم الكثيرون إعجابًا بما يحدث. فلا ألقى لهم بالاً، أقترب من الطاولة التى تجلس عليها ليزا وأجثو على ركبتى وأقترب منها مقبلاً يديها متسائلاً:
– ما رأيك يا ملكة قلبى؟ هل تقبلين حبى؟
يتهلل وجه ليزا من الفرحة. تهزها رأسها موافقة. ألح عليها قائلاً:
-أريد أن أسمعها منك صراحة.
ترد علىّ بصوت مسموع بينما جميع الرواد يراقبون المشهد سعداء بما يحدث بيننا:
– أنا أيضًا أعشقك من أول نظرة رأيتك فيها، ولا أستطيع العيش دونك يرتفع صوت رواد المطعم بالصياح فرحين بما يحدث. أمسك بيديها.
أوقفها. نتراقص معًا. تخفت الأنوار فى المطعم. يحترم رواد المطعم، والجميع، تلك اللحظة الخاصة بنا. يراقبون فى صمت. تنام ليزا كطفلة صغيرة على كتفى. أربت على ظهرها. أطبع قبلاتى الحانية على رأسها. ألتقم خصلات شعرها أقبلها. تضع رأسك على كتفى. أغمض عينىّ. أنسى كل شىء إلا ليزا. أتمنى أن تدوم هذه اللحظة إلى الأبد.
أنزل من أتوبيس الجامعة فى محطة نورث تشارلز وشارع 29. أترك الأتوبيس سائرًا على قدمىّ فوق الرصيف المجاور للكنيسة العتيقة فى اتجاه شارع سان بول. أعبر ذلك الشارع العريق إلى الرصيف الآخر متجهًا جنوبًا نحو البيت الذى توجد به شقتى التى تقع فى الدور الثانى وتطل على شارع سان بول.
أغلق باب البيت خلفى وأصعد الدرج الخشبى العتيق الذى يصدر صريرًا كلما صعد أو هبط شخص ما عليه. أولج المفتاح فى باب شقتى داخلاً إلى الريسبشن الصغير. أضع نظارتى الطبية على ترابيزة السفرة المستديرة وأخلع حذائى وأركنه بالقرب من الصوفا الصغيرة.
أتجه إلى حجرة نومى، الحجرة الوحيدة فى الشقة، وأرتمى على السرير محملقًا فى سقف الحجرة ومتذكرًا وجه ليزا الذى كان يبكى بسبب فراقى.
أجلس إلى مكتبى الخشبى الصغير. أفتح الكمبيوتر الخاص بى. أتجه رأسًا إلى ملف كبير تركته على الديسك توب وأسميته “ليزا”.
أفتح الملف. أبدأ فى تصفح الملفات الداخلية التى تحوى صورنا وذكرياتنا معًا واحدًا وراء الآخر. هذا الملف الأول الذى يضم أول صور لنا معًا، وخروجنا للتواعد العاطفى سويًا للمرة الأولى، والورد الذى اشتريته لها فى أول زيارة لى لشقتها الصغيرة فى منطقة تشارلز فيلديج أيضًا. إلى أن أصل إلى آخر ملف جمعنا معًا فى وادعنا فى منطقة الإنر هاربر. وعلى الرغم من أن هذا الملف هو الأخير، فإنه يضم عددًا كبيرًا من الصور التى قمنا بالتقاطها معًا ولم نكن نريد أن ينتهى هذا اللقاء بيننا وأن يظل إلى الأبد، أو أن يتوقف التصوير، كنا نريد أن يتجمد الزمن ونحن نتعانق، لا نريد أن نتفرق أبدًا.
أحس باللاجدوى. أغلق الكمبيوتر. تنهمر الدموع من عينىّ. ألقى بنفسى على السرير، أتخيل وجه ليزا يزين سقف حجرتى، يبتسم ثغرى، يتوقف دمعى.