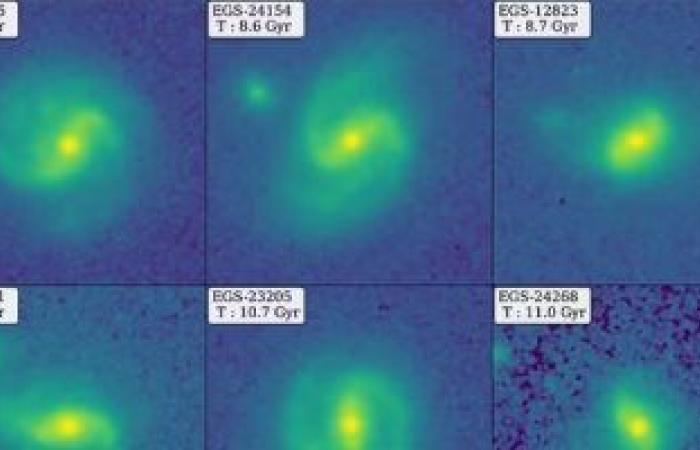ظلت الفلسفة العربية ـ ولا تزال ـ تعاني من الجمود وضيق التأويل لفترات زمنية طويلة، وألقت بظلال الجمود على العقل العربي الذي لم يستطع الهيمنة على النصوص الفلسفية الغربية التي توافدت عليه منذ عشرات القرون، ومنذ لحظة الجمود الأولى أخذت الفلسفة تلهث في صراع أحادي وراء التقاط نقطة التقاء بينها وبين الدين، الأمر الذي دفع بالعقل العربي إلى حالات من التسارع والتصارع على السواء. والفلاسفة الأوائل أخطأوا جدَّ الخطأ حينما أرادوا أن يؤيدوا الدين بالفلسفة، والأولى هو العكس، وظل الأمر هكذا حتى إن بزغت في شمس التكوين العربي إشراقات المعتزلة وتأسيس الصنعة العقلية في الجانب الإلهي أي ظهور الجدل العقلي بصورة متكاملة.
ولعل الجمود الفلسفي الذي أغرق العقل العربي عقودا بعيدة وساهمت الأكاديميات العربية والمعاهد بأساتذتها في البقاء طويلا بمساحات الاستغراق السلبي هو الذي دفع البعض للأخذ بمهمة الاجتهاد والتجديد القائم على التأويل لا على التلقي البطيء، ومشكلة الفلسفة بأساتذتها هي الاقتضاء بالخروج الزمني وعدم الاكتراث بمعاصرية الحدث الآني، هذا عملا بقول الطغرائي وهو يشير إلى معضلة الفلسفة العربية التي أدت إلى عقم العقل العربي:
"وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل"
وظلت الفلسفة العربية التي هيمنت على العقل الراكد تكرس لفكرة الانطلاق من الذات والعودة إليها مرة أخرى، متناسية بفعل التغريب والنقل السلبي والتلقي غير المتجدد البعد الاجتماعي أو التزامنية التي تقتضي بالتسارع، فالتجأت إلى التصارع من حيث المذهب أو الحادثة أو البحث في مضامين ومفهومات تبدو ثابتة مثل السلطة والخلافة والإمامة. ومسألة الذات تلك هي بالأساس مسألة مسيحية تطلبت منذ ظهورها إلى مجهود خرافي مزمن من فلاسفة الواقع المسيحي. وحينما انتقلت فلسفة الذات من المسيحية إلى الفلسفة العربية التي توصف دوما بأنها إسلامية لإضفاء طابع الشرعية عليها، نظر ناقلوها إلى الإيمان باعتباره مشكلة وليس رحمة أو نعمة أو هدية من الله عز وجل.
ولقد رأى "كيرككورد" أنه من الضروري رفض كل برهان عقلي على الإيمان، فالإيمان ـ كما يزعم وأتباعه ـ هو الذاتية، والذاتية هي الحقيقة، ولذلك ظلت الفلسفة العربية التي نقلت نصوصا خارج سياقها تسيطر على العقل الذي بات يكره التجديد ويمقت الاجتهاد رغم أنه يتغزل بكلمة التنوير.
ولهذه الأسباب ظل التنافي المعرفي للفلسفة العربية هو المعادل الموضوعي للهوية العربية الغائبة في ظل مصالح ومخاوف واهتمامات المواطن العربي البسيط الذي يعيش في بيئة متغيرة تتسم أيضا بالتسارع والتصارع. وحالات الغياب للفلسفة العربية بشكل واقعي في حياة المواطن العربي وكونها سجينة في الجامعات والمعاهد وعقول المتخصصين فقط جعلها ـ الفلسفة العربية ـ ظاهرة سياقية وليست اجتماعية، أي الركون مجددا إلى الذاتوية، ولاشك أن فساد تلك الفلسفة يرتكز إلى الانتماء إلى عقيدة فكرية من تأسيس رافد أجنبي لا ينتمي إلى البيئة العربية الأصيلة. فلا غرابة في أن الفلسفة العربية عبر عصورها مارست كافة أشكال السقوط.
فوجدنا الفلسفة بأصحابها وناقليها بالجامعات العربية ومعاهدنا الأكاديمية مرهونة بمسألة تراكم الهويات في ظل غياب وقلة وعي بالبحث أو إيجاد صيغة عربية تميزها، وهذه الفلسفة باستثناء المعتزلة لم تعرف يوما ما كما أشار "جورج طرابيشي" لاهوت نفي الآخر، لأنها باختصار فلسفة ناقلة لغيرها بامتياز دونما تأويل أو إعمال للعقل، وخصوصا أن هذه الفلسفة التي هيمنت لقرون على العقل العربي التزمت بمنطوق الشرع والحرص على تلقي النص الديني الإلهي أو النصوص الدينية البشرية بغير تأويل أو تحليل من زوايا مختلفة، على الأجدر قولا الأخذ بظاهر النص دون الاقتراب من بنيته المضمرة.
لذلك تعد المعتزلة الفرقة الفلسفية الوحيدة في التاريخ العربي التي استطاعت أن تكون لنفسها إحداثيات ومحطات زمنية يمكن تجاوزها من أجل التجديد والرغبة في الاجتهاد وإعمال العقل. وفي الوقت الذي سعت فيه المعتزلة إلى تحرير العقل من جموده ومن سلطة النص الظاهرية لم تفلح الفلسفة العربية في الوصول إلى مرحلة التمكين الثقافي فأصبحت حتى يومنا هذا مجرد شروح لمتون قديمة أو نقولات رمزية بفعل الرقابة الشديدة بل والمشددة أيضا التي ألزمت نفسها بها عبر عصورها المختلفة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى المواطن البسيط، ولعل هذا ما يدفعني وغيري إلى عدم تقبل رواد الفلسفة المعاصرين بطروحاتهم العقيمة لأنهم مجرد أبواق ناقلة لمفاهيم أو مضامين خرجت عن الزمنية ففقدت مزية التسارع المعرفي ووقعت في براثن التصارع بينها البعض.
وفي الوقت الذي لزم على الجامعات والمعاهد الأكاديمية تقديم فكر المعتزلة باعتباره أنموذجا مغايرا للفلسفة التي كانت سائدة لا من باب تثمين الأفكار نفسها، نسمع تلك الأصوات المكرورة التي احترفت التواجد الصحافي والإعلامي واحتلال الصالونات الثقافية تنادي بقضايا الفضاء المطلق والفضاء النسبي والتفتيش عن مرافئ لليقين وهم أشد حيرة لأنهم لا يزالوا أسرى للنقل دونما إعمال للعقل أو إطلاقه من أجل التحرير والتنوير.
ولاشك أن الفلسفة العربية السائدة في الجامعات العربية تعاني الاعتلال والمرض من حيث الدخول في معارك جدلية ليست حجاجية بالقطع، لأنها مخاطبة خادعة لا ترتقي بالإقناع أو المحاججة، وهذا الاعتلال هو الذي دفع بالفلاسفة المعاصرين يميلون إلى الثرثرة وعدم النزاهة واستعمال سياسات فلسفية من مثل الإلغاء والصهر والإلحاق، وكم هو محزن حقا أن أمة مثل العرب امتلكت رصيدا خصبا من أفكار المعتزلة دون الحكم على الفكرة أو أصحابها بالكفر أو بالمروق من الدين وحتى اليوم نجد من أساتذة الفلسفة بالجامعات العربية من ينادي ويصرخ بأن الفلسفة مذهب رغم أنها في قرار اليقين منهج، لكن في الوطن العربي استحالت الفلسفة مذهبا.
وبالرجوع إلى كافة الروافد الفلسفية الغربية، وكذلك طروحات المعتزلة التأويلية الغائبة عن الدرس والبحث المعاصرين نكتشف أن إسهامات الفلسفة الحقيقية هي إسهامات في المنهج وتطوره لا إضافات في المذهب، والأول ـ المنهج ـ يعني أن الفكر يستحيل قضية جمعية اجتماعية لا يمكن الفكاك من الزمنية ونحن بصدد الحديث عنه لأنه طريقة تفكير، بخلاف الأخير ـ المذهب ـ الذي يقتضي الخروج من الزمنية أي كونه نصا لا تاريخي، وهذا يتصل أكثر بالفرد في سياقه الذاتوي الضيق. لذلك وُصفت الأفكار الاعتزالية بأنها انقلاب على طرائق التفكير السائدة التي كانت سجينة المذهب لا المنهج.
وهذا يذكرني بما قاله "تولستوي" وأشار إليه من حيث إنه لم يجد في المذاهب الفلسفية الكبرى لأفلاطون وكانت وشوبنهور وباسكال شيئا مجديا، وأقر في نهاية الأمر: "واضحة جلية دقيقة حيثما تبتعد عن مشاكل الحياة المباشرة، ولكنها لا تهدي الحائر سواء السبيل، ولا تبعث الطمأنينة إلى القلوب الضالة القلقة".
والعقل العربي المسكين الذي كان فريسة سهلة لأنماط عقلانية مثل ذاتية ديكارت، ونقدية كانت، وتاريخية هيغل، واجتماعية ماكس فيبر، وعلمية كارل بوبر، وصولا إلى تواصلية هابرماس لم يستطع أن يجد هوية واضحة له في ظل تصارع علني بين بعض رجال الدين الراديكاليين وليس التنويريين الذين صدروا له إعلانا بتكفير تلك المذاهب وأصحابها أيضا وضلالها بل واقترابها من فتنة المحيا والممات، وبين الفلاسفة العرب المعاصرين الذي مارسوا بلادتهم في شرح تلك المذاهب مستغرقين في سرد الترجمة الذاتية لأصحابها أكثر من الإشارة إلى أفكارهم.
لكن، هل نجحت الفلسفة العربية الراهنة، أعني المعاصرة في مواجهة الاستيطان الصهيوني الغاشم؟، وهل الفلسفة التي تدعي اليوم بأنها عربية خالصة استطاعت تفكيك الجغرافيات الفلسفية القديمة لتأتي بطرح جديد يمكن معالجة واقعنا الحالي؟ الإجابة تأتي دوما بالنفي، لأن مشكلة هذه الفلسفة الحقيقية هي غياب الوعي بمعطيات الحاضر، دونما أدنى عناء بمحاولة تحسين الواقع أو حتى بناء المستقبل.
وغياب الوعي المستدام لدى الفلسفة العربية الراهنة هو الذي دفع أصحابها إلى ممارسة كافة أشكال الإقصاء أو الدمغ أو التهميش وأحيانا الإدانة والاستبعاد لكل رؤية مغايرة لإحداثيات الفلسفة التي لا تعبأ بالتجديد رغم كون الفلسفة تنويرا للعقل والمجتمع، حتى باتت فلسفتنا العربية اليوم سيرة محفوفة بالغموض والحيرة لا تصل بالمواطن العربي إلى مرافئ اليقين، لاسيما وأن السلطة الفلسفية اعتمدت محاور تشبه الشراك المفخخة التي لا تخرج عن أفلاك الثنائية، وهي العقل والنقل، والخلق والقانون، والسلم والحرب، والجبر والاختيار، والخير والشر، وأخيرا العلم والدين، وكأن الفلسفة العربية الراهنة التي نتجت عن إرهاصات عربية أصيلة قديمة، أو منتوج غربي خالص، استمرأت الدور الباهت الذي لا يقضي ويفصل بالحق اليقين.
وكم من مصيبة آنية نجدها في سرديات الفلسفة العربية تحاول من جديد تأويل مشكلة الألوهية، والحديث عن العلل الأولى وطروحات الفارابي وابن سينا مما يدل بقوة وشدة على نضوب العقل العربي الذي في الأساس يسعى جاهدًا إلى التنوير والتجديد. ولا يزال الحديث في مجمله العقيم يتناول مباحث الوجود والممكن، والعالم، وأصل الماهية، وأن النفس الكلية هي الواسطة بين عالمين، عالم الخير والعقل، وعالم الإنسان أو عالم الحس والشاهد، وهي جميعها بمنأى عن واقع المواطن العربي الإيجابي الذي يهرول من أجل التمكين والوصول إلى منصات التتويج المعرفية.
ولطالما أرهق دارسو وأساتذة الفلسفة في معاهدنا الأكاديمية العربية أنفسهم بالبحث عن كنه الوظيفية الفلسفية بعد العبقري العربي الوليد بن رشد، وهذا الإرهاق الذي يتبعه الإحباط وربما الاكتئاب من صعوبة الوصول إلى يقين معرفي للإجابة مفاده أن الفلسفة باختزال شديد واختصار غير مخل بالمعنى هي فن تكوين وإبداع ووضع مفاهيم من شأنها ضبط إيقاع تفكير الفرد والمجتمع على السواء. وما شأنهم الضارب في القدم بحكم الدراسة والتخصص ثم التمكين المهني النظري سوى استيراد الأفكار وإعادة صياغتها وتحديدا في مصر منذ النصف الثاني من القرن العشرين ما عرف بالتمصير الذي أخل بالضرورة بالنظرية الأصلية التي نجمت وفق سياقات سياسية واجتماعية ونظم فكرية ترتبط بمجتمعاتها الوافدة.
ومنذ وفاة النابه العربي ابن رشد والفلسفة العربية لا تزال مغرورقة في تفاصيل التنظير لطروحاته الفلسفية دون عناء البحث عن إيجاد فلسفة تبدو واقعية للمواطن العربي الاعتيادي الذي ينفر بالضرورة من فعل القراءة والتأويل وإعمال العقل، لذا فإن كل الكتابات التي تواترت بغير اتفاق بعد رحيل ابن رشد عن دنيانا مجرد ارتحال اضطراري لتفسير ما خطه الفيلسوف الكبير بغير طرح فكرة الوظيفية أو التطبيق أو حتى هاجس القابلية للتداول المجتمعي، مما أفقد الفلسفة العربية مكانتها الطبيعية التي تحققت بدمغ التاريخ الذي لا يكذب ولا يزيف الحقائق على يد الفارابي وابن سينا وإن كانا قيد ورهن أرسطو وكتابه ما بعد الطبيعة. وربما أجنح بعيدا حينما أظن أن الفلسفة اليوم هي كابوس المعرفة، بعدما كانت لقرون بعيدة ضاربة في القدم فن تكوين وإبداع وصنع المفاهيم من أجل تطبيقها، لكن اليوم وإن تشدق دارسو الفلسفة بكنه علومهم هي مجرد استيراد أفكار ونظريات ومن ثم إعادة صياغتها بصورة تقريرية قد تبدو سخيفة مطلق الأمر.
وكارثية الفلسفة العربية هي الاستغراق المستدام في الأفكار الماركسية التي باتت منتهية الصلاحية وغير جديرة لا بالطرح الفكري أو بالتنظير، أو حتى بنقد تلك الأفكار لأنها بحق أفكار فاشلة وبليدة كشفت عن مرض أصحابها ونوازعهم التحريضية لمجرد التحريض فحسب، وظلت الفلسفة العربية وهي تسبح في بحر الماركسية تفتش عن وجه لخطابها دونما جدوى، ففي كل سطر نجد ملمحا أو رائحة ماركسية لا يمكن الفكاك من أسرها، حتى استقر الأمر بهذه الفلسفة المكرورة بالإيمان المطلق بفكرة توطين التيارات الفلسفية الغربية والاكتفاء بنقلها.
ورغم أن أصحاب الفلسفة العربية المعاصرة طالما تشدقوا بمصطلحات الحداثة وما بعد الحداثة، وصولا إلى ما عُرف بالحداثة السائلة، إلا أن الطرح الفلسفي العربي جاء بعيدا عن واقعنا الراهن المزدحم بقضايا الإنسان ووجوده لا من أجل البقاء بل من أجل الفعالية والإيجابية، وهو ما لم يتحقق في فلسفة العرب المعاصرة، وظل السؤال دائم الاجترار هو: هل يمكن صياغة فلسفة عربية أصيلة في القرن الحادي والعشرين؟
ورغم اتهام الفلسفة العربية الراهنة وأصحابها بأنهم قطاع طرق جدد يسطون على الأفكار الفلسفية العالمية، إلا أن نظرة الفلسفة العربية للفلسفة الغربية نفسها تبدو خاطئة وبحاجة إلى تغيير للمسار أو تحسين لهذه النظرة الضيقة، ومجمل الصيحات المعاصرة الراهنة التي تنادي بتجديد الفلسفة هو خطاب بديل للفكر الكسول الذي اعتاد إعادة التأويل لنصوص فلسفية قديمة لا إيجاد رؤية جديدة يمكن توظيفها لا مجرد نقدها.
ولاشك أن الذي أفقد الطرح الفلسفي العربي المعاصر هو الاستغراق أيضا في الاستعارات والتشبيهات، وتناول القضايا الفلسفية من زاوية المباحث البلاغية الأكاديمية لاسيما عن توظيف أية نظرية فلسفية غربية. وإذا كانت هناك ثمة تشكيلات سياسية تمثلت ولا تزال في الماركسية السجينة أو الليبرالية المتوحشة، والأخيرة هي التي شكلت فلسفة الولايات المتحدة الأميركية وغرب أوروبا، فإن إسهامات الفلاسفة العرب المعاصرين غدت صورة مضللة للواقع الفعلي الذي نحياه، حتى يمكن توصيف الفلسفة العربية الآنية بعودة الإمام الغائب.
والفلسفة العربية الجديرة بالاهتمام حقا هي الفلسفة الإسلامية لأصحابها الأوائل، لأنها فلسفة مرتبطة ومتزامنة بالسلطة الزمنية والمكانية آنذاك، لذا حينما نجد عشرات الباحثين والفلاسفة يعيدون سرد النموذج الفلسفي لابن رشد لدرجة وصلت حقا إلى التقديس العاطفي، فإن هذا يفقدهم الدور الريادي والقيادة الفكرية لمجال الفلسفة إذ يصبحون مجرد أدوات لإعادة تفعيل أو تقديم نموذج فلسفي ارتبط بشدة بالسلطة الزمنية التي انقضت.
وأية عبثية تلك التي تريد تغيير العالم وفكره وتحسين حياة المواطن بفلسفة عقيمة، لا أعني وأقصد فلسفة العبقري ابن رشد، إنما أعني تلك التبريرات التي تدفع الفلاسفة العرب لإعادة نمذجة فلسفة ابن رشد مرة أخرى في ظروف مغايرة ومختلفة بالكلية.
ويؤمن كثيرون من رجال التنوير أن الفلسفة العربية المعاصرة غائبة وهي ليست تلك المحاضرات الأكاديمية التي تقدم بالجامعات والمعاهد المتخصصة، فهي غائبة لأنها بمنأى عن الاشتباك بالأحداث الجارية المتسارعة والمتصارعة أيضا، لذا اتهمت هذه الفلسفة كثيرا بأنها صناعة الوهم. ومن الصعب حقا أن تجد الفلسفة العربية اليوم مكانا لها في منطقة علاج القلق من المستقبل، وإذا ما حاولنا بغير جهد تفكيك الخطاب الفلسفي العربي الراهن لوجدناه متناقضا تماما عن الواقع الموجود والمعاش، وهذا يدفعنا من جديد لطرح السؤال الرئيس لفائدة الفلسفة، والذي أظن إجابته تكمن في كلمة واحدة هي الوعي.
ولأنني بصدد محاكمة عاجلة وسريعة للفلسفة العربية الراهنة التي يمكن توصيفها بالبليدة تارة، وبالمكرورة تارة أخرى، أعتقد أن الفلسفة كطرح ثقافي في المقام الأول بعيد عن حاضر الثقافة العربية الذي أصبح مرتبطا بقوة بوجهات أكثر قياسا وملاحظة واستخداما كاللغة، والترجمة، والفنون، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، حتى فلسفتنا العربية اليوم أصبحت تعاني حالات واسعة من الغياب عن القضايا المصيرية مثل الهوية، والتعليم، والعقلانية الاجتماعية، والدراما، انتهاء بالحريات.
وقلما تجد غير المتخصصين بمتعة وهم يطالعون الكتابات الفلسفية الحالية، لأنها باختصار فلسفة لم تنجح في حل إشكاليات الحياة بمختلف صورها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأنها في حقيقة الأمر فلسفة تدعو في مجملها إلى التشاؤم والاعتزال والانزواء بعيدا عن مشكلات العصر، وفي ظل قارئ محدود الوقت ولا يمتلك رفاهيته تصبح الأصوات الفلسفية العربية غائبة عن المشهد العربي الراهن.
ومن مشكلات الفلسفة العربية الغياب الواضح عن المنصات الرقمية الإلكترونية وكأنها وجدت لتبقى حبيسة الثقافة الورقية فقط، وهذا يدفعنا من جديد لطرح سؤال مفاده: متى تصبح الفلسفة العربية واقعا وتطبيقا وليست مجرد تنظير وترميم لنظريات بائدة؟
هذا فضلا عن ظاهرة ثقافية تخلخل كيان الفلسفة العربية، وهي ظاهرة غياب مفهوم الجماعات الفلسفية أو الكيانات الفلسفية الجمعية ذات الهَم المشترك، وهذا دليل كافٍ على غياب الوعي لدى المشتغلين بالفلسفة أنفسهم وأنهم لا يزالوا مرضى سريريين لحب الحكمة، لذا أطالب بتأميم الفلسفة التي لا تفيد البشر في أحوالهم المعاصرة بالقدر الذي تتحدث فيه ـ الفلسفة ـ عن أمور باهتة فائتة.