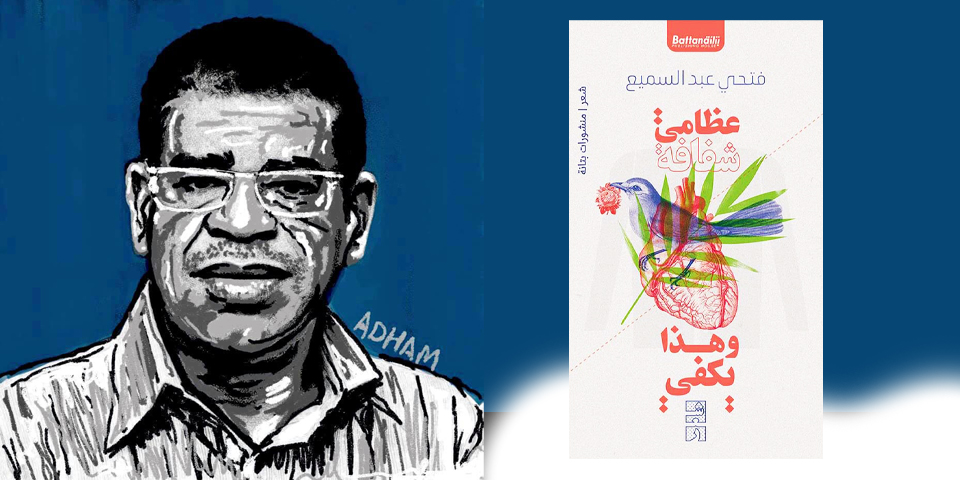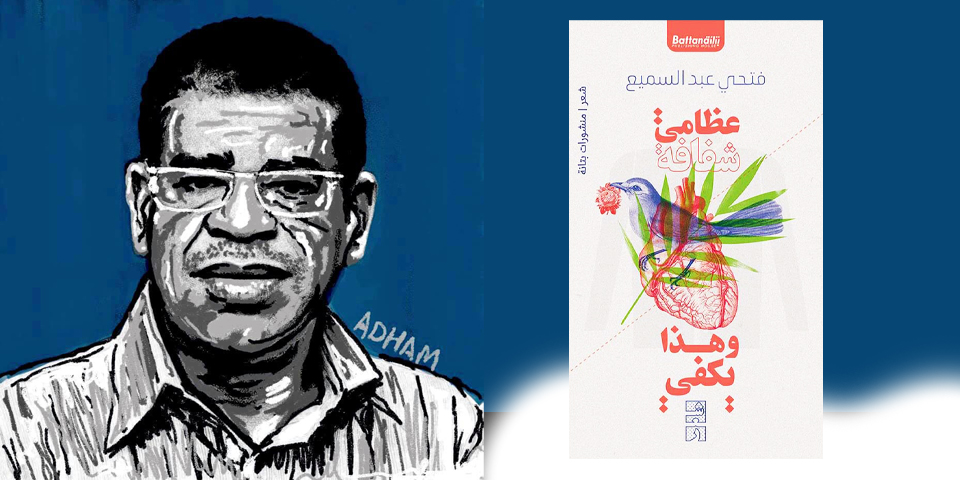
يمثل اللقاء مع شعر فتحي عبد السميع مساحة للتأمل فيما وراء النصوص، فلم تكن قصيدته – أبدًا – منبتة عن جذورها الجنوبية، كما لم يكن صوتُها الحداثي غريبا عن جذورها الكلاسيكية.
يعنيني بداية أن أقرأ رؤية الشاعر لذاته؛ ذات الشعراء، وهو ما يقدمه ليس فقط باستهلال الأقسام السبعة في المجموعة الشعرية (عظامي شفافة وهذا يكفي)، كما في قصيدته (فوق الورقة): “نَحْنُ الشعراءْ / أفْرَاسٌ خَضْراءْ/ لكنَ الأُفْقَ أمامَ سَنَابِكِنَا دَرَقَةْ / نَحْنُ الشعراءَ / عُشَّاقٌ فُقَرَاءْ/ مَسْجِدُنَا الليلُ/ نَجتَمِعُ عَلَ سُلَّمِهِ كلَّ حنين / ونُسمِّر في قُبَّتِه الحَدَقَةْ / نَنْتَظِرُ النَّجْمَ الطيبَ/ لِنُتَمْتِمَ بالدَّعَوَاتِ / ونَلْقَفُ مِن كَفِّيَهِ الصَّدَقَةْ / نَحْنُ الشعراءَ المَنفيين جنوبَ الوقتِ/ جَمْرٌ يَبْزُغُ مِن ماءْ/ نَجْرَحُ كلَّ خرابٍ / ونُعِيدُ بِنَاءَ العالَمِ فوْقَه”، ولكن عبر القصائد كلها، وكأنما (فوق الورقة) مفتاحًا جامعًا، وأن كل قصيدة لا بد وأن تبدأ بفتحته: (نحن الشعراء …)!
إنه ذلك الشاعر الذي يعدو ويَسقُطُ، فلا يَكُفُّ عن السقوطِ ولا القيامِ، وهو يُلملِمُ الورقَ القديمَ مِن الهواءِ، باحثا عن ملاذٍ في ضلوعِ الزوبعة؟ يختصر اللحظةَ في مَوَّالٍ أسود، ويُبَلِّلُ بالعزلةِ ريقَه. لا يملك غير وريقاتٍ يَجفَلُ مِنها الحِبْ، وعِشْقَ امرأةٍ تبتعدُ، وعينينِ مُهشَّمَتين تُطِلَّان على أطلالٍ ورِقَابٍ مُجتثة؟ ” خَذَلَني الوقتُ / وخَسرت كلَّ شيء/ حائطٌ أخيرٌ تَبقَّى / أنتِ يا رَبَّةَ الكتابة / رَمِّمي جسدي/ تَغَمَّدي بحنانِك كلَّ فضائحي/ ولا تَدُقِّي آخِرَ مسمارٍ في نعشي” (ص 67).
المفرداتُ التي استعرتها من قصائده، ودسستها في السطور السابقة، قد تشي بأنه يتحدث عن الآخرين، فهذه قصيدة يهديها لصديق، وأخرى يدبجها لراحل، وثالثة لغائبة، والحقيقة أن هؤلاء جميعا مرايا للشاعر، يتحدث بصوتهم حينا، ويتقمص حيواتهم أحيانا، لكنه معنيٌّ بهم كما هو معني بنفسه، فالألم واحد، والمصير، كما يردد واحد، والمآل – دوما – ليس مبشرا، وكأنها مفردات لأرض يباب.
الآخر، الذي يستحضره الشاعر فتحي عبد السميع، حينا من التاريخ الموغل في الأبدية، وحينا من تحت سقف البيت العائلي، وأحيانا تحت سماء القرى، ليس سوى وجوه له، لأنها وجوه جميعها تمثل تحولاته؛ فحين يقول “لم يكُنْ حمدانُ بهلوانا/ لكنه اشتهى أن يكونَ فراشةً/ ربما أَدْهَشَهم بألوانِه الزاهية/ وأيقَظَ رقصُهُ منارةً في أعماقِه” (ص 87)، ألا يحيلنا ذلك إلى قوله: “يَزْهو بِظِلٍّ غامضٍ / وفَرَاشة تَشي مَعَه” (ص48)، وكذلك: “لا يَنسَى أبدا/ فَراشةً غافلته في ليلةٍ كهذِه/ ونامتْ في فِراشِ طَلقَة”.(ص 174)، “الرَّجُلُ وراءَ البنت /خائِفٌ مِن سقوطِ المِشْبَك / خائِفٌ مِن دَهْسِ فَرَاشةٍ /يمَشي بِحَذّرٍ وانْتِبَاه/ لا يريدُ أنْ يقولَ: /كنتُ مِشْبَكا/ وصِرتُ فَراشةً تحْتَ حِذَائي”.(ص 206)، “غيْرَ أنَّ قبْضَتي/ لا تَملِكُ أكثرَ مِمّاَ يَملِكُ/ ظِلُّ فَرَاشةٍ” (ص 222).
صورة الفراشة، الأثيرة، أكاد أراها معادلا موضوعيا للروح الشاعرة، التي تريد أن تملك خفة الفراشة، ولكنها تستطيع بتواتر أجنحتها، أن تصنع التأثير المرجو، لذلك يلح علينا الشاعر بهذه المفردة، ويلونها، حتى أنها في الحزن ترتدي الحداد حين يضجر من العالم الدنيوي، وفي فرح الطفولة تتكسى بكل لون، تستدعي البهجة بمشابك على هيئتها صبغاتها حمراءُ وخضراءُ وصفراءُ وزرقاء، ولكنها، في الغضب، جمرة رصاصة: ” حين ضَغَطَ على الزِّنَادِ / فانْطَلَقتْ فَرَاشة” (ص 174). يا لها من فراشات سحرية يخرجها من جعبته فتحي عبد السميع، وهو في خيمة الشعر، ينصب سيركه فخا، يصطاد به فراشات عقول القراء وذائقتهم.
هنا سنرى تأثير الفراشة استعارة شعرية يعيد فيها الشاعر تنظيم عالم تسوده فوضى الصراعات وتنكس أعلامه مشاعر الحداد، وكأن تلك الخفقات كضربات الريشة الخفيفة في لوحة مدرسة تأثيرية، ستكون لوحة جدارية كبيرة، وشاملة. نظام الكتابة الذي قدمه فتحي عبد السميع يشبه التطريز اليدوي للموتيفات، غرزة وراء أخرى، لتكتمل الموتيفة الأيقونة، هو يختزل الواقع في تلك الرسوم الموجزة بخطوطها ومفرداتها المقتصدة، لكنها معا، وبمرور الوقت يتحول تأثير أجنحتها فتصبح رفرفة أجنحة الفراشة في جزء من الديوان وراء إعصار في قصائد أخرى.
ماساة الموت، والغياب، والاختفاء، والتلاشي، ثيمة أثيرة لدى شاعرنا، بالمثل، وتعج صور المجموعة الشعرية (عظامي شفافة وهذا يكفي) بالحديث عن هؤلاء، وهو ربما يلومهم، لأن غيابهم قد أثر فيه، وكأنه نجا ليعاني رحيلهم.
لكنني، أرى يعيني قاريء للفن، الكثير من الصور السوريالية، التي رسمها فتحي عبد السميع ساخرا من الأسطورة حينا، ومن الواقع حينا، ومن أشياء أخرى أحيانا. صور سوريالية مركبة، وكأنها أحلام يقظة لروح هربت من أسر الموت. هنا “سريرٌ قديمٌ يموجُ داخلي/ أسناني تَصْطَكُّ مِن أزيزِهِ المتقطِّع” (ص184)، في جسدي عضوٌ ما / يَحتاجُ إلى وخزةِ دَبُّوسٍ/ كي يَتحركَ جِنزيرٌ في الروح/ ويَطحَن تلك الغيبوبةَ طَحنا” (ص 23)، سَرقَ كيسَ أُمِّه / وحَشَا عروقَه بالبارود / وبينما كان يتنقلُ مِن جثةٍ إلى جثةٍ / جرَّهُ الحنينُ مِن قَفَاه.” (ص 68). إنها صور سوريالية، مثلها كثير، وكحال كثير من سوريالية الحياة تكاد تشبه صور الشاعر مشاهد من الكوميديا االسوداء!
في قصائد (عظامي شفافة وهذا يكفي) للشاعر فتحي عبد السميع لا يرد (النجع) إلا مرة، وكذلك (القرية)، و(الجنوب)، و(الترعة)، و(الشط)، ويأتي (الفرن) مرتين، ولكن (النيل) يرد، كمفردة أربع مرات، وكنت أبحث عن مفردات المكان لأكتشف أن المكان في القصيدة يؤسس حضوره في الذهن، لذا تزدحم الأفكار وتتلاقح، فتتحاور حينا، وتتصادم، لأنه يؤسس حضورها في الخيال الشعري. إنه يسرد سيرا حياتية، لكنها يسكنها رأسا يعصف بها الحزن حينا، والحيرة والألم أحيانا. في المقابل جاءت مفردة (الأم) تسع مرات، في إشارة إلى حضورها في مأثوره، ومخيلته وحياته، وليس غريبا هذا الأمر، فهذه الأم حاضرة دومًا في حياة الشعراء وكلماتهم.