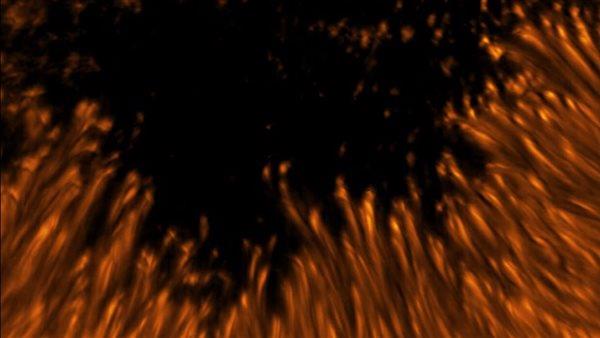يضع كتاب "ميادين التغيير" لمؤلفه شتيوي الغيثي مفاهيم الثورة وتصورات المثقف على محك النقد.
والإشكاليات المطروحة في الكتاب لا تتغافل عن إشكاليات التاريخ والواقع، بل هي أسئلة تحاول اختراق الواقع العربي بكل زخمه الثوري وأحلامه الديمقراطية.
في تقديمه للكتاب يقول مؤلفه شتيوي الغيثي إنه بعد عامين من ثورات العالم العربي في 2011، بدأت تتكشف عدة إشكاليات في فهم سياق الدولة الحديثة. ولم يكن الوضع السياسي في البلدان التي حصلت فيها الثورات العربية بأحسن حالا من الأنظمة السابقة التي ثارت على استبدادها الجماهير.
كما يتحدث كذلك عن تلاشي بعض الأحلام الرومانسية في صناعة دول عربية حديثة على المدى المنظور القريب.
شتيوي الغيثي
ـ كاتب وشاعر سعودي.
ـ صدر له:
قشرة الحضارة، إشكاليات الثقافة السعودية وتحولاتها.
لا ظل يتبعني .. مجموعة شعرية.
سؤال التغيير
مع انتشار ظاهرة الثورات في بعض البلدان العربية التي صنعها الشباب، وليست النخب السياسية أو النخب العسكرية أو الدينية كما في بعض الدول الأخرى سابقاً، أقول: مع انتشار ظاهرة الثورات صار من المهم على الوعي العربي أن يعيد مساءلة ذاته، حيث إنها حوادث جديدة على الفكر العربي، إذ لم يسبق لها مثيل طيلة تاريخ العرب باستثناء ثورات الاستقلال العربي التي تختلف معطياتها عن الثورات الحديثة، فالتغيير في العالم العربي سابقاً كان تغييراً من الأعلى إلى الأسفل، أي من قمة الهرم الاجتماعي السلطوي إلى القاعدة الجماهيرية، سواء كان تغييراً تنويرياً، أو كان تغييراً تقليدياً.
بعد تغيّر موازين القوى الاجتماعية عقب الثورات، انعكست هذه المعادلة، ليصبح رجل الشارع فاعلاً اجتماعياً على (بعض) مجريات الأحداث، وليس رجال السلطة، أو حتى النخب الحزبية. هذه المرة جاءت من قبل الشعب، والشعب نفسه، من غير أي تدخل من أي أحد من النخب العليا، أو الراغبين في التغيير السياسي من داخل السلطات العربية. رجل الشارع قال قوله وأحدث الانقلاب المفاجئ، الذي لم يكن في حسبان أحد حتى أكثر المحللين نباهة.
مع هذه التغييرات الثقافية والسياسية في العالم العربي يعود السؤال القديم/الجديد: من يقود التغيير..؟. السؤال سوف يسقط في مجمله في حال فكرنا في الأوضاع العربية الحديثة، وأنها جاءت من رجل الشارع، ولذلك لا أهمية له من الأساس في نظر من يرفع رجل الشارع بوصفه محرك الأحداث الجارية. هذا صحيح من الجانب النظري، لكن على الجوانب التطبيقية تبرز إشكاليات كثيرة في الإجابة عن مثل هذا السؤال، ففي النظرة الأولى يفترض أن التغيير دائماً يحتاج إلى قيادات ثقافية، أو سياسية، أو دينية، مما يعيدنا إلى ذات النقطة التي رفضها الواقع العربي في الثورات الحديثة؛ كونها جاءت من الشارع وليس من النخبة، ولكن.. هل فعلاً انتهت النخبة هنا بحيث لم يعد لها ذات التأثير على رجل الشارع..؟ الإجابة عن هذا السؤال تدخلنا في متاهة فكرية ثانية، حيث إن بعض النخب الفكرية والسياسية كان لها وجود فعلي في "ميادين التغيير" وإن بشكل غير مباشر.
أسئلة الثورة
انشغل العالم العربي بسؤال الثورة ومآلاتها ونتائجها، حتى أصبحت هي المحور في الأحاديث الدائرة عقب الأحداث العربية عام 2011، والتي تصالح على تسميتها سياسياً بـ"الربيع العربي"، وهي كلمات فتحت النقاش بين الأطياف والتيارات الفكرية في العالم العربي بلا استثناء، ولعلها من أكثر الكلمات إشكالية، حيث الاختلاف الفكري بين التيارات يجعل منها قضايا محورية، حل إشكالياتها هو حل لكثير من القضايا الحياتية ما بعد مرحلة الثورة.
في تصورنا أن بدء الاختلاف بين التيارات يتحدد ليس في نقد الأنظمة السياسية والثورة عليها، فغالبية الأطياف الفكرية تتفق على فساد النظام العام في البلاد التي حصلت فيها الثورات، وإنما يتحدد الاختلاف في الموقف الفكري من "ما بعد النقد" أو "ما بعد الثورة"، وإدارة الحياة، أو تحقيق التنمية والإصلاح في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ذلك أن المشاريع الفكرية التي يتمحور حولها أي تيار يختلف في مرجعيته وأيديولوجيته من حزب إلى حزب أو من تيار إلى تيار.
الثورة كانت تجمع مختلف التيارات تحت رؤية نضالية واحدة، وهي إسقاط النظام السائد، ومن هنا وجدنا التلاحم بين التيارات واصطفافها إلى جانب بعضها البعض ضد الأنظمة القائمة، بل وصل الحال إلى تجاور المذاهب والأديان أحياناً، أما بعد الثورة فقد ارتدت التيارات والمذاهب والأحزاب إلى سابق عهدها، لأن المشترك الذي جمعهم قد زال، ومن هنا يبدأ التنافس بين التيارات في إدارة السلطة.
تأتي الديمقراطية لتصنع النظام الجديد في ظل تنافس التيارات على السلطة، وهو حق مشروع للجميع، يحدد هذا الحق مدى كثرة أصوات الحزب الفائز.
الخيار الشعبي هو الخيار الذي يُعوَّل عليه في البناء الديمقراطي، فعدد الأصوات تعني رغبة الشعب في إدارة حكم البلاد من قبل أشخاص قدموا مشروعهم التنموي، ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة، والشعب نفسه هو الرقيب والحَكَم الأخير في تقييم التجربة سواء بالفشل أو بالنجاح، ما لم يتم التلاعب بالانتخابات كما في الأنظمة التي ثار الشعب ضدها. لكن هذا لا يعني إطلاق يد الشعب في كل شيء، فهناك حقوق عامة لا يمكن التصويت عليها، أو جعلها موضع رغبة شعبية، كما هو الحال مثلاً في عمل المرأة أو في حرية التعبير، أو فرض ديانة محددة، أو مذهب طائفي معيّن يجبر الناس عليه، أو حقوق الأقليات، فهذه الأمور لا يمكن التصويت عليها لأنها حق للفرد قبل الشعب، والحقوق لا تخضع لصوت الأغلبية، لأن الحق فوق التصويت.
ومع اشتراك غالبية الأحزاب في نقد الأنظمة الفاسدة؛ إلا أنه من الطبيعي أن تضع الأحزاب الإسلامية نفسها كأكثر الأحزاب كثافة من الناحية الجماهيرية، مما يمكن أن يعطي ثقلاً لبعض التظاهرات ضد الأنظمة، وهذا التوسع في النشاط الإسلامي والجماهيرية التي تحظى بها أدى إلى التخوف من قبل التيارات الأخرى في اكتساح أكثر المقاعد الانتخابية في السلطة، وهو ما حصل في بعض البلدان، وهو تخوف من قبل التيارات الأخرى لسببين: الأول: هو جماهيرية الأحزاب الإسلامية، مما يمكن أن تتمحور السلطة فيها لسنوات أو حتى احتكارها، والعمل على تغيير بعض الدساتير، والثاني: لأن (بعض) هذه التيارات الإسلامية (السلفيون تحديداً) كانت ترفض الديمقراطية؛ بل وصل الأمر إلى أنها كانت تعتبر العمل الديمقراطي كفراً في سنوات مضت، وها هي بعد سنوات تحصد مقاعد في المجالس النيابية بالطريقة الديمقراطية التي كانوا يحرمونها، مما يمكن أن يجر المنطقة إلى التراجع عن المنجزات الوطنية التي كانت متحققة، أو عدم تصالحها مع العصر على اعتبار أن الكثير منها لديه أزمة في وعي العصر الجديد ومتطلباته، أو هو "سوء فهم للتاريخ"، مما يخلق بؤر توترات عديدة بمسميات دينية يمكن لها أن تقوّض المشروع الديمقراطي من أساسه. هذا تقريباً مختصر ما يتصوره بعض دارسي الحركات الإسلامية وتطوراتها.
تجارب متعددة
ينبغي علينا هنا أن نوضح أنه لا يمكن الاعتماد على تجربة واحدة، أو اثنتين في الحكم بالفشل أو النجاح، فالتجربة التركية مثلاً نجحت بعد عدد من الإخفاقات التي صاحبت تحركها في الواقع الاجتماعي التركي، سواء في رؤيتها للعمل السياسي، أو على مستوى التنمية، في حين فشلت بعض الأحزاب الإسلامية مثل الإخوان المسلمين في مصر، في إقناع الجماهير بجدارتها بالبقاء في الحكم، الذي وصلت إليه بعد انتخابات نزيهة شاركت فيها أطياف المجتمع كافة، لكن هذه الجماهير سرعان ما تظاهرت ضد الحركة، مما أدى إلى سقوط حكمها بعد انحياز الجيش إلى مصلحة رغبات المتظاهرين، فيما اعتبره الإخوان وأنصارهم انقلاباً عسكرياً ضد أول رئيس مدني منتخب في مصر، واعتبره مناوئوهم تصحيحاً لمسار الثورة وإنقاذاً لمصر من "الأخونة".
أما في تونس فما زال الوضع في حالة سكون لا يسمح بدراسة عاجلة إلا بعد اكتمال تجربة الإسلاميين في تونس عن نظيراتها. وبتعبير أكثر وضوحاً يمكن أن نقول: لا يعني نجاح حزب إسلامي أنه سوف يقود إلى تجربة دينية خالصة، كما لا يعني فوزه رفضاً للقيم الديمقراطية العامة التي تتعامل معها معظم سياسيات الدول؛ خاصة الكبرى منها، أو أنه سوف يحقق التنمية للبلد أو يفشلها، لأن كل بلد وكل حزب له تجربته السياسية الخاصة، وفي التجارب التي سقنا بعضا منها (تركيا، مصر، تونس) ما يفرض علينا القول بالتجارب المختلفة.
إضافة إلى ذلك، فإنه ما تزال بعض الأمور في بداياتها، بحكم أن الثورات والعمل الديمقراطي في العالم العربي ما يزال في سنواته الأولى حتى بعد أكثر من سنتين أو ثلاث، لذلك فإن سؤال الثورات العربية ما زال حاضراً، وقد تم طرح الكثير من التحليل ومحاولة فهم ما جرى، ولماذا جرى، ولأي شيء جرى بهذا الشكل الذي لم يكن مسبوقاً من قبل؟! (على الأقل في الحالة العربية)، وما المعنى من كل هذا الهياج السياسي الذي أشغل العالم؟.
الحالة العربية الآن مختلفة، وموازين القوى أصبحت شعبية، فالقاعدة الشعبية، وليست الحزبية، هي المحرك الأول لمن أراد الوصول إلى سدة الحكم. الشعب هو الحكم الأخير في اللعبة الديمقراطية. قد يكون هناك الكثير من الشوائب في العملية الديمقراطية، لكنها شوائب لن تطول - في رأينا - مع تطور وعي المجتمع أكثر فأكثر.
في الحالة العربية كان الكثير من المتنفذين السياسيين يطرحون أنفسهم بوصفهم الأوصياء على الشعب في اتخاذ مصيره، فالمتنفذون من أي اتجاه، أو حزب، أو سلطة هم من يقرر خيارات الشعب دون أن يكون أحد قادراً على أن يرفض على اعتباره مواطناً له حق الاعتراض على السياسيات التي تقرر مصيره، من أجل تحقيق مصالح معينة لفئات حزبية أو تيارات معينة داخل السلطة. هذه الحالة تغيّرت "ربما" إلى سلطة الشعب. أقول "ربما" لأني لستُ على ثقة من أن الخيارات الشعبية سوف تسير في الاتجاه الصحيح، لأن بالإمكانية الالتفاف على خيارات الشعب من أجل مكاسب أخرى، لكن هذه الـ"ربما" لن تطول في مدى وعي الشعب لاستخدام سلطته؛ إذ يمكن له الرفض هذه المرة، فصوت الشعب أصبح عالياً بعد الثورات العربية على كل ما حاولته بعض الأنظمة من قمعها.
الثورات الفكرية والثورات السياسية
التساؤلات حول جدوى الثورات، ومدى تأثيرها على الواقع العربي (وهو واقع كان يُعتَقَد أن زمن الثورات قد رحل) عميقة، وهذا العمق يفترض فيها إعادة مساءلة الواقع مساءلة فكرية قبل أن تكون تغييراً سياسياً. هناك وعي جمعي للمشتركات الحياتية من قيم إنسانية مشتركة يمكن الوقوف عليها. هذا الوعي بالمشتركات الإنسانية في العمل السياسي، أو الحياة اليومية، جعل السؤال حول الرؤى الفكرية للثورات مطروحاً بقوة؛ خاصة في ظل الحديث حول نوعية الفوضى التي تسببها مثل تلك المظاهرات التي كانت تتسع يوماً بعد يوم. هذا الوعي الشبابي هو وعي بالعصر نفسه ومتغيّراته الفكرية والسياسية، مما جعلها تخرج من محدودية المطالبات الحزبية إلى المطالبات الشعبية، والتي أهمها محاربة الفساد وأهله أيّاً كان نوعه. هذا الوعي خلق تعاطفاً شعبياً في دول العالم كافة، وليس العربي فقط، لأنها جاءت برؤى تختلف عن المطالبات الحزبية التي تجاوزها الزمن إلى فضاء أكثر حرية، وأكثر تجذّراً من إصلاحات شكلية سرعان ما ينكشف عورها ومسكناتها الوقتية.
خطاب ثقافي
السؤال الذي كان يدور فكرياً هو ما بعد الثورات: هل سوف تنتج خطاباً ثقافياً عاماً يكون موازياً لحجم الثورة؟ أم إنها تكاد تصبح ثورات معزولة سرعان ما تعيد صياغة نفس الإشكاليات السابقة التي ثار ضدها سيل الشباب في الشوارع العربية؟ ـ بصيغة أخرى أكثر وضوحاً: هل سوف تنتج الثورة ديكتاتورييها، أم إنها سوف تكون حالة عربية ديمقراطية جديدة لها تمثل حقيقي على أرض الواقع بحيث تصبح الإشكاليات القديمة بحكم الدرس التاريخي؟.
ما حصل في الثورات العربية لم يكن يسير في سياق واحد على الرغم من صعود التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم، ففي مصر كان هناك نوع من التفرد بالحكم من قبل تيار الإخوان المسلمين مما أثار احتجاجات لاحقة، أما في تونس فقد كانت أكثر توافقية مما جعل الأوضاع أكثر استقراراً بين جميع ثورات العالم العربي.
في حال الواقع العربي فإنه (حتى الآن) لم يصنع ثورته الفكرية، إذ لا وجود لمفكرين يمكن الاعتماد عليهم في تغيير مفاهيم العلم والدين والكون تمهيداً للتغيير في مفهوم الدولة في العالم العربي، ولذلك فإن احتمالية عودة الدكتاتوريات العربية واردة هنا.
ومن الصعوبة بمكان (حالياً على الأقل) بحث مدى الأسئلة الفكرية التي أنتجتها الثورات العربية أو نتجت عنها. صحيح أن هناك بعض الكتابات الفكرية والمؤلفات التي تعيد مفهوم الدولة قبل الثورات العربية خاصة في المغرب العربي بسنوات مثل عبدالله العروي الذي كان يشدد على أنه "لا ينضج الفكر السياسي في أي مجتمع كان إلا بعد أن يتمثل بجد المفاهيم الثلاثة: الحرية، الدولة، العقلانيةـ في آن واحد"، لكن لا ندري حقيقة مدى تأثير هذه الكتابات على الوعي العام المتشكل، وهل لها تأثير على سياق الثورات العربي أم لا؟
إضافة إلى أننا لا نجد أي وصف للحالة الفكرية للثوار الشباب في الميادين العربية في الكتابات اليومية للثورة من قبل بعض الكتاب، وكل ما نجده هو وصف للحالة الثورية نفسها، بل يبدو أن راصدي يوميات الثورات كانوا يميلون إلى تجاوز المعطى الفكري أو الفلسفي،لقد تم وصف الثورات العربية بغياب المعطى الفكري، كما تم وصف الشباب الثوار بأنهم بلا أيديولوجيا في التداولات اليومية في الإعلام العربي، هذا فيما يخص الثورة ووصفها، أما بعد الثورات فإننا نجد بعض الكتابات الفكرية التي تطرح سؤال الثورة نفسها، بحيث أصبحت واقعاً سياسياً، فتحوّلت الثورة سؤالاً فكرياً يفتح الكثير من الأسئلة التي تبدأ من عندها، ولا تنتهي عند حد، مروراً على مفهوم السيادة والدولة الدينية والمدنية وعلاقتهما بالديمقراطية وغيرهما من الأسئلة التي انفتحت من خلال السؤال حول الثورة. ولعل أهم ثلاثة كتب ظهرت بعد سنة من الثورات العربية كانت تتميّز بأنها تختلف في مرجعيتها الفكرية، وهي: "في الثورة والقابلية للثورة" لعزمي بشارة، وهو فلسطيني قومي التوجه، وكتاب "فلسفة الثورات العربية" لسلمان بونعمان وهو باحث مغربي يميل إلى الفكر الفلسفي، وكتاب "أسئلة الثورة" لسلمان العودة وهو من الاتجاه الإسلامي في السعودية.
ومن الطبيعي أن تلتقي الكتب الثلاثة في محاولة البحث في ماهية الثورة بوصفها قضية منهجية تتكئ عليها المفاهيم الأخرى، فهي عند عزمي بشارة: "تحرك شعبي واسع خارج النية الدستورية القائمة أو خارج الشرعية، يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة".
في حين يرى بونعمان أنه "لا يوجد إجماع بين علماء الاجتماعية على ماهية الثورة وتعريفها"، معرجاً على عدد من المفاهيم المختلفة حول الثورة ليؤكد بعدها أن "هناك تعميم خاطئ ومبالغ فيه في إطلاق تعبير "الثورة" على جميع الأحداث الحاصلة في الوطن العربي... إذ غالباً ما يستعمل هذا التعبير لوصف انقلاب عسكري أو انتفاضة أو هبة شعبية مؤقتة"، فالثورة لديه معطى فكري، إذ هي "حصيلة تفاعل جدلي بين الاستقراء والتأمل الفكري من جهة، وبين الممارسة والفعل من جهة أخرى".
أما العودة فتتعدد لديه مفاهيم الثورة بشيء من الارتباك أحياناً، فهي مرة "بناء على ما مضى وتطوير ومراجعة، وليست هدماً أو تقويضاً سياسياً"، أو هي مساءلة للواقع بوضعه على محك الاختبار والفرز والتحوير، وإعادة البناء بلبنات جديدة أو بلبنات سابقة"، وهي مرة مفهوم خاص كـ"ظاهرة اجتماعية ذات علاقة بتغيير الأنظمة السياسية عبر الفعل الاجتماعي العام... (فهي هنا) قفزة وليست تدرّجاً، أو هي محصلة تراكم طويل من النقمة .. تدفع إلى إلغاء تجربة ماضية بأكملها"، في حين نجدها في مكان آخر "محاولة تجاوز الفرق القائم بين الحاكم والمحكوم... وأحياناً هي احتجاج على المسافة بين الواقع القائم وبين القانون أو النظام المفترض".
لكننا نجد أن بونعمان يتفرد عن الباحثين الآخرين (بشارة والعودة) في محاولة الوصول بالثورات العربية إلى فلسفة جديدة بشيء من الفأل، ويضعها في مصاف الثورة الفرنسية والأميركية رغم أنه يقرر اختلافها عنهما.