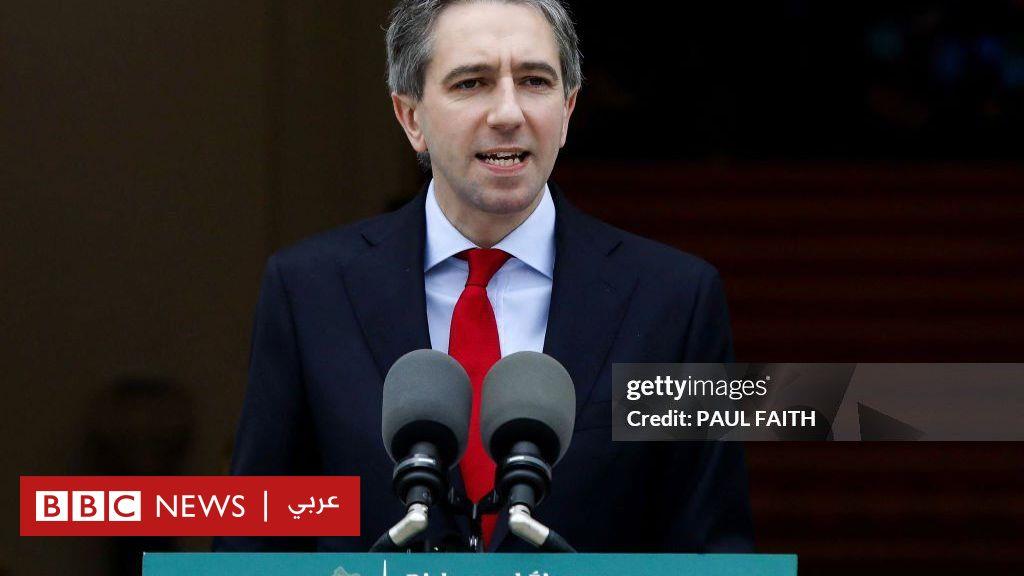ما الذي يمكن للمثقف أن يقوم به من أجل خدمة أمته وقضاياها؟ هذا سؤال نسمع به، بصيغة أو بأخرى، وبصورة متكررة. على أنه يلزمنا طرح سؤال آخر: سؤال يسبقه، بل ويفضحه من حيث هو -أو الجواب المفروض مسبقا عليه- تعبير لا واع عن حاجات وأغراض سياسية واجتماعية لفئة ما أكثر من كونه تعبيرا عن الحقيقة والموضوعية! وهو: من هو الذي يمتلك الحق بتحديد مفهوم الأمة وقضاياها؟ أليس مفهوم «الأمة» يظل – كغيره من المفاهيم العامة – ملتبسا وغامضا وإشكاليا؟! بل إنني أكاد أجزم أن كثيرا من الجدل السجالي الذي يشتعل بين حين وآخر على ساحة الفكر العربي ليس إلا نتيجة لهذه الطبيعة الإشكالية التي تتصف بها المفاهيم العمومية والمجردة.
نعم. فما الذي يفصل بين هذا التيار الفكري وذاك سوى التباس المفاهيم، أو لنقل اختلافها على المستوى المعرفي والأيديولوجي والأخلاقي من تيار لآخر؟ وأرى أن سبب الاختلاف في المفاهيم العمومية (الأمة، المواطنة، الحرية، الدولة، العدالة، حقوق الإنسان...) راجع بالضرورة إلى اختلاف في المنطلقات الفكرية والأسس المعرفية التي ينبني عليها هذا المذهب أو ذاك.
إن الالتباس الذي يثيره مفهوم «الأمة» هو التباس طبيعي، أي أنه راجع كما أسلفت إلى اختلاف الأسس والمنطلقات (والمريب ألا تختلف!)، وإضافة إلى ذلك فإن من شأن هذه المفاهيم أن تثير مثل هذا الالتباس؛ لأنها أكثر عمومية: أي أكثر تجريدا للوقائع وبعدا عن الأحداث والتفاصيل اليومية من غيرها من المفاهيم... وهذا العامل الأخير يمكن معالجته من الناحية المنطقية والإبستمولوجية، أي الفلسفية وليس من الناحية التاريخية والاجتماعية.
لماذا نطالب مثقفا يساريا – على سبيل المثال – بأن يكون مخلصا لمفهوم «الأمة» الذي صاغه الخطاب الأصولي، والذي يتحدد تبعا لمنطلقاته الخاصة القائمة في النص الديني، مما يعني أنه لا ينفي أي تحديدات تنطلق من الخطاب اليساري فحسب، بل ويصادر حقّه في التفكير والتعبير والمساهمة في إبداع مفاهيمه الخاصة أو لنقل: تحديد ملامحها انطلاقا من رؤيته ومبادئه المختلفة مع مبادئ ورؤى الأصوليين؟
إن بنية الخطاب الأصولي -بطبيعتها- طاردة، وعلى «المختلف» أن يذوب فيها لكي يكون له حق المساهمة في بناء المفاهيم وتحديد المبادئ والقيم... أي عليه أن يكون أصوليا تماما ليصبح مشروعا لمثقف مخلص! أما المثقف الذي يشتغل خارج هذا الإطار ويفكر خارج هذه البنية فهو متآمر يكيد لـ «الأمة»... وليس له الحق في التعبير والاتصال مع الجماهير الذين يتخذون هم أيضا تحديدا أصوليا ملائما لهذه البنية «عباد الله، المؤمنون، المسلمون، المقتدون بالسلف...» على خلاف مفهوم «الجماهير» في الخطابات الأخرى.
وكذلك الحال بالنسبة للمثقف القومي. فما يخرج عن الأطر المرسومة التي تميزه عما عداه فهو لا يملك هذا الحق، ولا يمكن أن يكون (مخلصا) وهو العميل، الخائن، المتأمرك، أو هو الرجعي المتضامن مع الاستعمار والإمبريالية.
كيف أكون مثقفا مخلصا للأمة إذن؟ وهل الإخلاص شرط للمثقف؟ ألا يجر هذا المعنى وراءه عبئا ثقيلا من المعاني والمفاهيم الشائكة الأخرى: كالالتزام، والنضال، والدفاع عن الأمة والتعبير عن مطالبها ومفهوم «المثقف العضوي مثلا.. أو المثقف الداعية»؟ وهي مفاهيم ومعان ضررها – حسب التجربة – أكبر من نفعها.. أو أنها أصبحت شعارات تزايد بها التيارات الإيديولوجية على الجماهير وعلى الثقافة نفسها.
لقد أصبح المثقف، تأسيسا على هذه المفاهيم، مجرد أداة، يفتقر لأهم ما يجب على المثقف الحفاظ عليه ألا وهو: حرية التفكير المستقل والتعبير عنه بصراحة ووضوح وجرأة. وهل الإخلاص شرط أخلاقي ضميري أم هو شرط سياسي – اجتماعي، أي إيديولوجي واجب، هو بمثابة الضوء الأخضر للسماح له، ليس بالتفكير والتعبير بحرية، بل والحياة الكريمة بعيدا عن الملاحقة والمطاردة والتضييق؟ ولكن.. هل يعني «عدم الإخلاص» شيئا آخر سوى الخيانة والكفر والتآمر على الأمة؟
في ختام المقال أود أن أقول إنني لا أملك حلولا أو أجوبة، بل أثير هذه التساؤلات من أجل الوقوف على أزمة تجتاح الخطاب العربي المعاصر، هي أزمة المصطلح.
والأزمة تكمن ليس في اختلاف المصطلحات، فهذا شيء طبيعي، بل وصحي.. ولكنها تكمن في عدم القدرة على إدراك هذه الطبيعة الاختلافية، أو على تحملِ هذه الحقيقة بشجاعة وقلب جسور وعقل منفتح وراق يرى إلى «الآخر المختلف» باعتباره، ليس عدوا كما هو الحال في الفكر العربي، بل امتدادا حضاريا للذات وثروة لا تقدر بثمن. وأراها مشكلة أخلاقية أيضا، أي: هل تمتلك رصيدا أخلاقيا إنسانيا يستطيع أن يحتمل وجود المختلف وجودا فاعلا، أم أنك من التعصب والتشدد وضيق الأفق والضعف بحيث لا تحتمل أحدا يتكلم بغير ما تريد؟