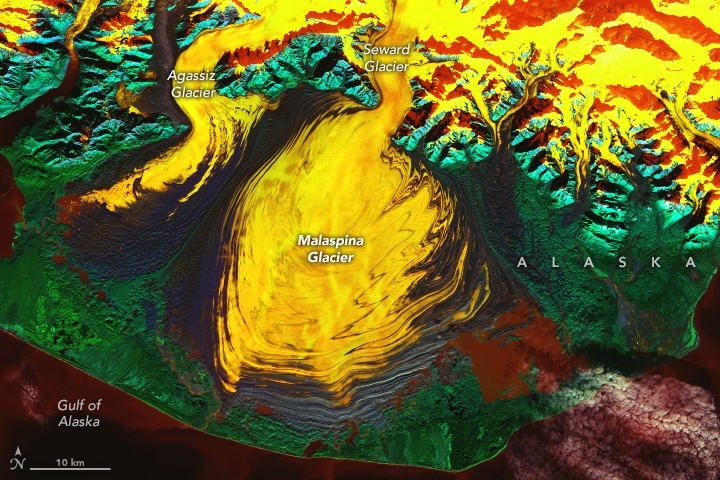خلال الأيام القليلة المقبلة ستُعرف اختيارات أهل المهنة السينمائية الأميركيين في ما يتعلق بتوزيع جوائز الأوسكار لهذا العام. من الواضح أن لا أحد يتوقع، منذ الآن، مفاجآت كبيرة لأسباب عدة، منها أن الترجيحات هذه المرة أتت أكثر من بديهية، تضع في المنافسة مجموعة أفلام يقف معظمها على الضد مما اعتادت أن تكون عليه الأفلام «الأوسكارية» في الماضي، لتعزز اتجاهات هذه التظاهرة التي ينتظرها العالم كله كما تنتظر الألعاب الأولمبية او حتى كأس العالم بكرة القدم، اتجاهات نحو سينما أكثر إنسانية وجمالاً وأقل كلاسيكية مما في أي وقت مضى. ولعل ما يعزز هذا الشعور أن قلة من أسماء النجوم أو الفنانين أو حتى الأفلام التي بقيت حتى التصفية النهائية، معروفة للجمهور العريض. فاليوم، في نهاية مرحلة انتقالية عاشتها وتعيشها السينما الأميركية، بات التوجه واضحاً نحو سينما تنهل من «تعاليم» صاندانس، أكثر مما تنهل من تعاليم سينما الهوليووديين الكبار. ويمكن أن يحسب هذا نقطة في صالح هوليوود، التي تبدو هنا وكأنها باتت جديدة إلى حد كبير، ويقيناً أن هوليوود باتت تبدو مختبراً للحساسيات السينمائية الجديدة اكثر كثيراً مما تبدو صانعة للأحلام كما كان حالها في عصورها الكلاسيكية الغابرة.
فهذا العام مثلاً، وحتى لئن عادت «سينما الأحلام» بقوة وعلى الأقل من خلال فيلم «لا لا لاند» المرشح أكثر من أي فيلم آخر لنيل العدد الأكبر من الجوائز، بما في ذلك جائزة أحسن فيلم، - إلا إذا حدثت قلبة مسرحية في اللحظات الأخيرة، وضعت في الصدارة واحداً آخر من الأفلام التسعة المتبقية في التصفية -، لئن عادت «سينما الأحلام»، فإنها تعود كمجرد أقلية استثنائية، في وقت تطفو على السطح كل تلك القضايا الشائكة، ذات الهموم الاجتماعية خصوصاً وربما السياسية أيضاً، التي كثيراً ما حملتها أفلام هوليوودية، وبخاصة غير هوليوودية، تلك التي بات أهل المهنة الهوليووديون ينظرون إليها بقدر كبير من الجدية بعدما كانت قد ظلت لعقود طويلة على الهامش، حتى وإن ساهمت في الخارج في صنع هوليوود الجديدة.
ومثلما يحدث في أزماننا الراهنة في مهرجان صاندانس، الذي لا شك أنه أعاد إلى السينما الأميركية بل حتى إلى أميركا نفسها من وجهة نظر ما، اعتبارها الإنساني، ها هي الغالبية العظمى من الأفلام المتنافسة في جوائز الأكاديمية (الأوسكار)، تأتي محملة بالقضايا الإنسانية، وبشكل يبدو تراكمه هذا العام غير متطابق على أية حال مع التبدل في الذهنية الأميركية العامة التي جاءت بدونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
قضيتهم في أيديهم
وعلى رأس هذه القضايا، هذه المرة، وبالتناقض – كما أشرنا سابقاً – مع ما حدث في دورة العام الفائت الأوسكارية التي أثارت غضب الأميركيين الأفارقة، قضية السود، أو كما يفضلون هم: قضية الأميركيين الأفارقة، ووجودهم في المجتمع، كما مساهماتهم في المهن السينمائية بالتالي. فالحال أن نحو نصف الأفلام المتنافسة على الأوسكارات، تحمل ما هو منتم إلى حياة الأميركيين الأفارقة وهمومهم وصراعاتهم وتاريخهم. أكان ذلك في المواضيع، أو في انتماء المبدعين أنفسهم، وصولاً إلى الفئات الأكثر إثارة للاهتمام العام عادة: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلين، وممثلين ثانويين.
ولئن كان من بين الأمور اللافتة، إمساك الأميركيين الأفارقة، بقضاياهم في أفلام مثل «مونلايت» من إخراج باري جنكنز (كواحد من قلة من مخرجين سود وصلوا إلى المنافسة على جائزة أفضل مخرج في تاريخ الأوسكار)، أو دنزل واشنطن (المرشح كممثل إنما لا كمخرج، عن فيلم «حواجز»)، أو حتى الهايتي راؤول بيك، (الذي يظهر هذا العام في ترشيحات الأوسكار عن فيلمه الوثائقي «أنا لست زنجيّك»، بعدما كان تجوّل كثيراً في دورات «كان» وغيره)، فإن ما يمكن الالتفات إليه هنا كذلك، الاهتمام المتجدد لدى سينمائيين غير سود، بتحقيق أفلام عن هؤلاء، تبرز بقوة هذا العام. ولعل المثالين الأكثر بروزاً في الترشيحات الأوسكارية، الفيلمان المميزان، «لافنغ» من إخراج جيف نيكولز، الذي كان قد عرض منذ شهور في دورة العام الفائت لمهرجان «كان»، حيث لم يحالفه الحظ في الحصول على السعفة الذهبية التي كان مرشحاً لها، مع أنه كان يستحقها، وإلى جانبه «وجوه مخفية» من إخراج ثيودور ملفي، وتمثيل عدد لا بأس به من نجوم سود وبيض. وإذا كان «وجوه مخفية» قد رشح لثلاثة أوسكارات، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثلة مساعدة، فإن «لافنغ» لم يحظ إلا بترشيح واحد، له قيمته الكبيرة والرمزية على أي حال: جائزة أفضل ممثلة لروث نيغا، التي تبدو من الأوفر حظاً للحصول عليها.
والحقيقة أن ترشيح واحدة من شخصيات «وجوه مخفية»، وبطلة «لافنغ» لهاتين الجائزتين، أمر يمكن اعتباره، ليس فقط ذا بعد سينمائي استثنائي، خصوصاً إذا ما أضفنا إلى ذلك ترشيح فيولا دافيز (فيلم «حواجز» من إخراج دنزل واشنطن) ونوومي هاريس (عن «مونلايت»)، إلى جانب أوكتافيا سبنسر (في «وجوه مخفية») وروث نيغا (عن «لافنغ»)، وهي أمور – وصول ممثلات سوداوات إلى هذه المرتبة الأوسكارية – لا تحدث إلا نادراً، وقد يبدو نوعاً من الرد على ظلم لطالما أحاق بهذه الفئة العرقية من المبدعين.
نضال ضد الظلم
ومع هذا يظل اللافت كون الفيلمين الأفضل، في مجال إعادة الاعتبار لشخصية الأميركي – الأفريقي على الشاشة، ومن خلال النساء هذه المرة، أتيا من تحقيق مخرجين، وحتى فريقي عمل، لا ينتمون إلى الأميركيين الأفارقة. وفي ما لا يقل عن فيلمين يبدو القاسم المشترك الأساس بينهما، كونهما ينتزعان من التاريخ الأميركي حكايتين تقولان أشياء كثيرة، عن حياة السود ونضالهم والظلم الذي يتعرضون له - على رغم القوانين التي يحدث أحياناً أن تنصفهم - بل تقولان أكثر مما تقول مئات الكتب وعشرات النظريات. فالأول بين الفيلمين، وهو «وجوه مخفية» يأتي لنا من سجلات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بحكاية حقيقية عن ثلاث عالمات سوداوات حقيقيات ساهمت مساهمات فعالة في برامج الفضاء والرحلات الفضائية، لكن ذكراهنّ طويت تماماً لأسباب عرقية تحديداً، بل حتى لم يؤت على ذكرهن في حينه!.
وإذا كنا سنعود إلى هذا الفيلم في كتابة لاحقة، فإننا نتوقف هنا عند «لافنغ» الذي انتزعت حكايته بدورها من سجلات التاريخ الأميركي الحديث، وبالتحديد من سجلات التاريخ القضائي في الشرق الأميركي. وبالتالي نحن هنا أمام حكاية تاريخية حقيقية، أبدع جيف نيكولز في نقلها إلى الشاشة، ولكن بخاصة، في التركيز على الكيفية التي يمكن للنضال ضد الظلم والعنصرية، أن يكون صبوراً هادئاً حتى ولو استغرق وقتاً.
وكما يدل العنوان تدور الحكاية من حول عامل البناء الأبيض ريتشارد لافنغ، الذي يعيش ويعمل في مقاطعة كارولينا بولاية فرجينيا. ريتشارد يقع ذات يوم في غرام جارة وصديقة للعائلة هي ميلدرد جينز. وإذ يقيمان علاقة في ما بينهما غير منتبهين إلى قسوة «العالم الخارجي» على المحبين، تكتشف ميلدرد ذات يوم أنها حامل. فيقرر الحبيبان أن يتزوجا. لكن المشكلة تكمن في أن ميلدرد سوداء وريتشارد أبيض، والزواج بين شخصين من عرقين مختلفين ممنوع في تلك الولاية، لذا يتوجهان إلى واشنطن دي. سي. حيث لا يوجد حظر من هذا النوع من الزواج. وبالفعل يعقدان قرانهما هناك، ويعودان وهما مطمئنان إلى أن كل شيء يتعلق بهما وبعلاقتهما وبالطفل المقبل، قانوني. ولكن: أبداً... سيقول لهما «شريف» المنطقة. هذا القانون «المتسامح» في واشنطن، لا يسري في فرجينيا. ومن هنا فإنهما يقيمان في ما بينهما علاقة خارج القانون. وتكون النتيجة أن يقودهما إلى السجن بتهمة خرق القانون. ومن ثم يحكم عليهما بالسجن لمدة عام. غير أن القاضي الرحيم» يعلق ذلك الحكم شرط أن يبارحا معاً فرجينيا ولا يعودا إليها طوال الخمسة والعشرين عاماً التالية.
أحب زوجتي
وعلى هذا النحو تبدأ رحلة الزوجين بين أروقة القضاء والقوانين، ومحاولات التحايل على القانون، ومن ثم محاولات هذا «القانون» القبض عليهما ومعاقبتهما. وفي تلك الأثناء، من دون أن تفتر همة العلاقة بين الاثنين ولو قيد أنملة، يتابع الفيلم تلك الحياة فيما يزداد عدد أطفال الزوجين ومعاناتهما في الفقر، الذي يستبد بهما في وقت لم يعد متاحاً فيه لريتشارد أن يمارس عمله ويحتاج الى أن ينفق على المحامين. فالرجل، بكل هدوء وانطلاقاً من حبه الخالص لزوجته وعائلته، ورفضه لأي قانون يفرق المرء عن عائلته، ولرفضه كذلك أن يعيش إلى الأبد، بعيداً من موطنه الأصلي في منفى لا يمكنه أن يتكيف معه، الرجل بات ممزقاً تماماً... لكن هذا التمزق لم يبدل من طبعه الوديع وحبه لأسرته. ومن هنا، في وجه شراسة مطبقي القوانين الذين لا يفهمون أن هذه إنما هي هنا لخدمة الإنسان، ومن وجه بؤس قوم لا يعرفون شيئاً عن الحب، لا يجد ريتشارد لافنغ وزوجته أمامهما سوى أن يواصلا معركتهما. وهي معركة سوف تتواصل فترة طويلة، وسوف يتدخل فيها المحامون والنصابون، وجمعيات الحقوق المدنية والانتهازيون السياسيون من الطرفين. وكل هذا وريتشارد وميلدرد صامدان، مصرّان على الوصول إلى ما يعتبرانه حقهما الطبيعي.
وفي نهاية الأمر، تعطيهما المحكمة العليا حقهما، إذ تعتبر أن القوانين العنصرية التي استندت إليها ولاية فرجينيا لطرد الزوجين، غير دستورية. وهكذا ينتصر آل «لافنغ» في معركتهما التي وصلت، تاريخياً، إلى ذروتها يوم كتبت ميلدرد لافنغ، الحقيقية، إلى وزير العدل روبرت كنيدي رسالة لا تزال محفوظة حتى اليوم بين أوراق آل كنيدي، - ومن المعروف أنها لعبت دوراً أساسياً في الخاتمة السعيدة التي وصلت إليها الحكاية -، ويوم وقف ريتشارد لافنغ، الحقيقي، في قاعة المحكمة العليا ليقول إن دفاعه الحقيقي لا يتجاوز ثلاث كلمات: «أنني أحب زوجتي».