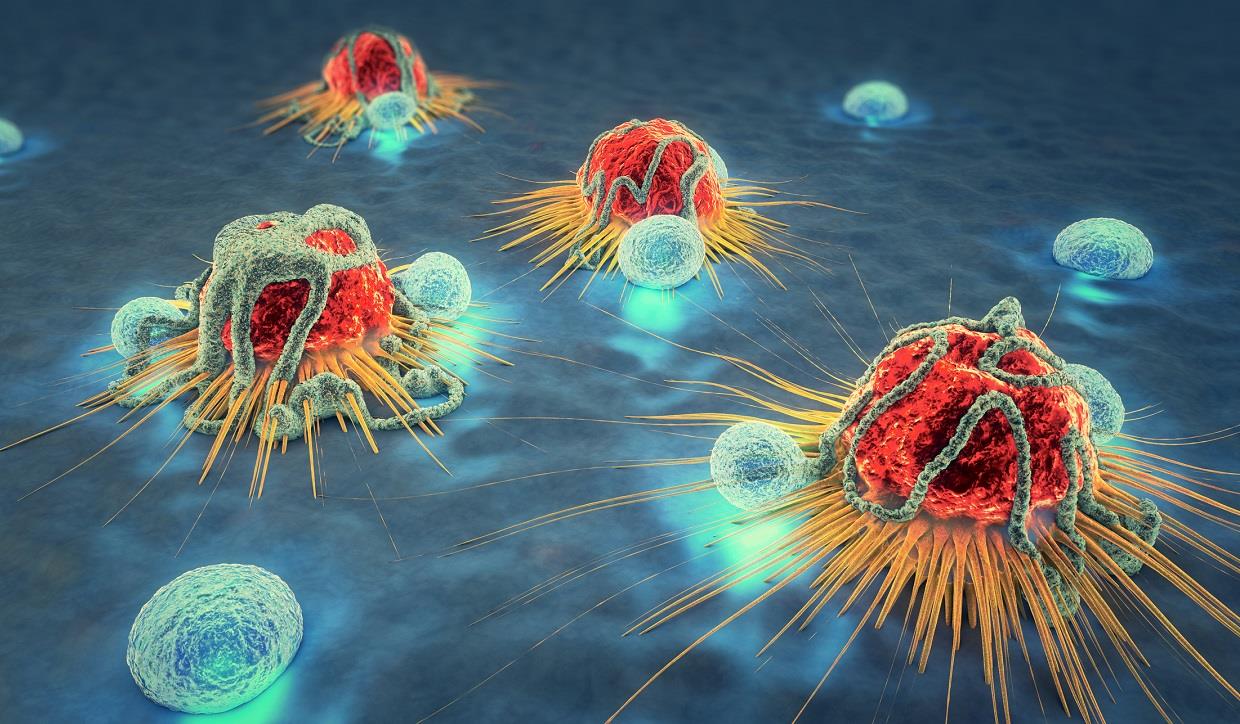دائماً ما نظر إلي مجايليّ قبل الحرب بعين الحسد لأني بعذر طبي وبدل نقدي نجوت من الخدمة العسكرية في جيش النظام السوري. فإلى أنني لم أقاس تلك الظروف السيئة التي يمر بها الذين يؤدون هذه الخدمة، وفرت أيضاً وقتاً طويلاً، استنفدته بعد تخرجي الجامعي في البحث عن عمل وفي تحصيل خبرات أولية، لم يستطع زملائي امتلاكها إلا بعد وقت طويل.
طبعاً مرت مياه كثيرة تحت جسر ذلك كله، وهجرنا من بلادنا مرغمين مختارين، لكن ظللت طيلة هذا العام والنصف اللذين أمضيتهما بين مخيمي اللاجئين في مدينتي زفولا ودرونتن الهولنديتين، وكلما اشتدت ظروف الإقامة فيهما علي، أبرر ذلك لنفسي بأنه لربما هو نصيبي من الخدمة العسكرية التي هربت منها في سورية، وها أنا أمضيها هنا، فلأتقبلها كما هي فلن تنفع معاندتها أو الهروب منها إلى الخلف في شيء.
لم تكن ظروف المخيم الأول في زفولا الذي أقمت فيه ثلاثة أشهر، والذي كان عبارة عن صالة مفتوحة ضمت 500 لاجئ عزلت بين كل عشر منهم جدران خشبية غير مكتملة هينة، فلا أحد ينام قبل السادسة صباحاً، وإن لم ينم الجميع فلن تعرف النوم أنت أيضاً، والطعام الذي كان أشبه بطعام المستشفيات لن تستطيع أخذه إلا في وقت محدد إن فاتك ستبقى جائعاً إلى اليوم التالي، لكن كان لدي ولسواي، على رغم ضجرنا وتعبنا من تلك الظروف، قدرة على التحمل طورناها من تبريرنا أننا هنا نبقى أفضل حالاً بكثير مما لو بقينا على حدود بلدان رحلة لجوئنا والتي بات مجرد انتهائها إلى أي شيء إنجازاً بحد ذاته.
في ذلك المخيم كنا ننتظر أن تبدأ إجراءات لجوئنا، أن يسألنا أحد عن أسمائنا، أن يعطينا أي أمل بنهاية ما لهذه الإقامة، لكن ضغط اللاجئين على شعبة شؤون الأجانب في وزارة العدل الهولندية جعلها غير قادرة على فتح ملفاتنا، نحن اللاجئين الجدد، بل لنسمع في نهاية الأشهر الثلاثة تلك أن هذا المخيم سيغلق، وأنه سيتم توزيعنا على مخيمات أخرى.
ولأنني طلبت مساعدة من طبيبة المخيم في أيامنا الأخيرة هناك، تم نقلي وحيداً وعلى عكس بقية اللاجئين إلى مخيم درونتن ذي الرقم واحد في هولندا، كان المخيم حين وصلت إليه أشبه بفندق بخمس نجوم مقارنة بالمخيم الذي كنت فيه في زفولا، فهنا تملك غرفة بمفتاح تجمعك مع ثلاثة أشخاص، وراتب أسبوعي تشتري به طعامك بنفسك، ومكتبة وصالة بلياردو وصالة إنترنت، والأهم أنني لاحظت منذ البداية ملصقات عن جمعيات إنسانية وتوصيات بمنع التدخين الذي لا أحتمله إطلاقاً.
طبعاً بعد أيام قليلة تبدى أن هذا كله كان إلى الوهم أقرب، مجرد شكل يفتقر إلى أي مضمون، فرفاقي في الغرفة لا ينامون أيضاً قبل طلوع الضوء ويصرفون طيلة الليل بالسهر وتدخين كل أنواع الحشيش، ما حول الغرفة إلى شيء أشبه ببار أو ورشة تصليح سيارات، وفاقم من كل معاناتي وكوابيسي التي كنت أعيشها في المخيم السابق. ولا مجال لتطلب منهم أن يتوقفوا، ولا حتى تلك المنشورات التي تدعو إلى منع التدخين أو سواها كانت للتنفيذ، بل كانت سياسة موظفي المخيم تقضي بتيسير الأمور بالتي هي أحسن، بخاصة مع المتنمرين. بدا الأمر مرات كثيرة وكأنك في سورية، لا في هولندا، وبأنك إن أردت أمراً عليك أن تحله بنفسك، فهنا أيضاً على رغم القوانين المعلنة لا حياة لمن تنادي.
وزاد من سوء الوضع أني بقيت في هذا المخيم ثلاثة أشهر من دون أن يحرك أي ساكن في إجراءاتي، على رغم أن الكثير من رفاقي الذين كانوا معي ونقلوا إلى مخيمات أخرى أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على حق الإقامة. وعرفت في ما بعد أن مخيم درونتن هذا وعلى رغم ظروفه الجيدة ظاهراً مشهور بتسمية «مخيم النسيان»، فهنا يرمى اللاجئون ولا أحد يفتح ملفاتهم إلا بعد مرور وقت طويل. لاحقت الأمر مع أكثر من موظف، لكن الجواب كان نفسه، وتعلمته منذ اليوم الأول لمجيئي إلى هولندا؛ انتظر! لا يوجد لديك ما تفعله سوى الانتظار. وطبعاً هذا أيضاً كان جواباً كاذباً أو يرمى من قبل كل موظف ليزيل المسؤولية عن عاتقه، لكن في الحقيقة وبعد أن صادفت موظفة لطيفة تذكرتني من المخيم السابق، عرضت علي المساعدة، واستطاعت تحريك ملفي، وأخذ موعد من شعبة شؤون الأجانب لبدء تحقيقي وإجراءات حصولي على الإقامة.
كان الأمر في شباط (فبراير) 2015، أسبوع كامل من السفر اليومي بين المخيم في درونتن ومركز التحقيق في تيرأبل، المسافة بين المدينتين ساعة ونصف الساعة تقريباً، الباص كان يأتي ليقلنا في السادسة صباحاً في طقس ثلجي مظلم، ويعود بنا إلى المخيم في الساعة الثامنة مساء، وبين الساعتين اثنتا عشرة ساعة نصرفها في الانتظار من دون جوالات أو أقلام أو دفاتر من أجل تحقيق يدوم حوالى الساعة، عليك أن تنتظر أن ينهي كل رفاقك الذين شاركوك الباص من درونتن إجراءاتهم لتعودوا معاً.
أحاول أن أتذكر أياماً أخرى في حياتي أصعب من ذلك الأسبوع وأفشل، بخاصة مع ملفات حياتنا وظروف الحرب في سورية والتي كنا نفتحها للمحققين، لكن على رغم ذلك رأينا في تعب تلك الإجراءات وعذابها أملاً ما بقرب حصولنا على الإقامة وبدء حياتنا في هذه البلاد.
المفاجأة التي لم أكن أتوقعها أني في نهاية هذا التحقيق لم أحصل على الإقامة بل وضع ملفي في الانتظار؛ لأن شعبة شؤون الأجانب في ذلك الوقت كانت تسرع ملفات العائلات، ولم أحصل على الإقامة المنتظرة إلا في نيسان (أبريل)، بعد شهرين من هذا التحقيق، وعلى أثرها بدأت عجلة الأمور تتحرك رويداً رويداً. اخترت البلدية التي أريد الإقامة فيها والتي ستمنحني منزلاً وحياة كاملة، وفتحت حساباً بنكياً، وحزت رقماً وطنياً، وبدأت متابعة دروس اللغة الهولندية في صفوف مدرسة المخيم المتواضعة.
وعلى رغم أن الكثير من ظروف المخيم لم تتغير، بل ازدادت سوءاً، بدت تلك الأشياء في حينه قادرة على منحي الأمل والقدرة على التحمل، بخاصة أني رفدتها بمحاولات وجهود يومية للخروج من المخيم والاندماج مع الهولنديين والتطوع في أعمال كثيرة مكنتني من الوثوق بأن هناك أملاً بالقليل من الجهد والصبر بالوصول إلى نفسي وحياتي في هذه البلاد، على رغم كل ما كنت أعانيه داخل هذا المخيم المقيت.
لكن بين ما كنت أعيشه في المخيم وما أعيشه خارجه تنابذت بين حالتين قصويين بين منتهى السوء ومنتهى الراحة، كانت الاثنتان غير حقيقيتين، ولا دائمتين، بل جذرتا فيّ شيئاً أقرب إلى الانفصام، أضعت فيه نفسي. فكأني في المخيم وفي خارجه أمثل أدواراً يتطلبها الوضع وناسه، أكثر مما هو واقع حقيقي أعيشه.