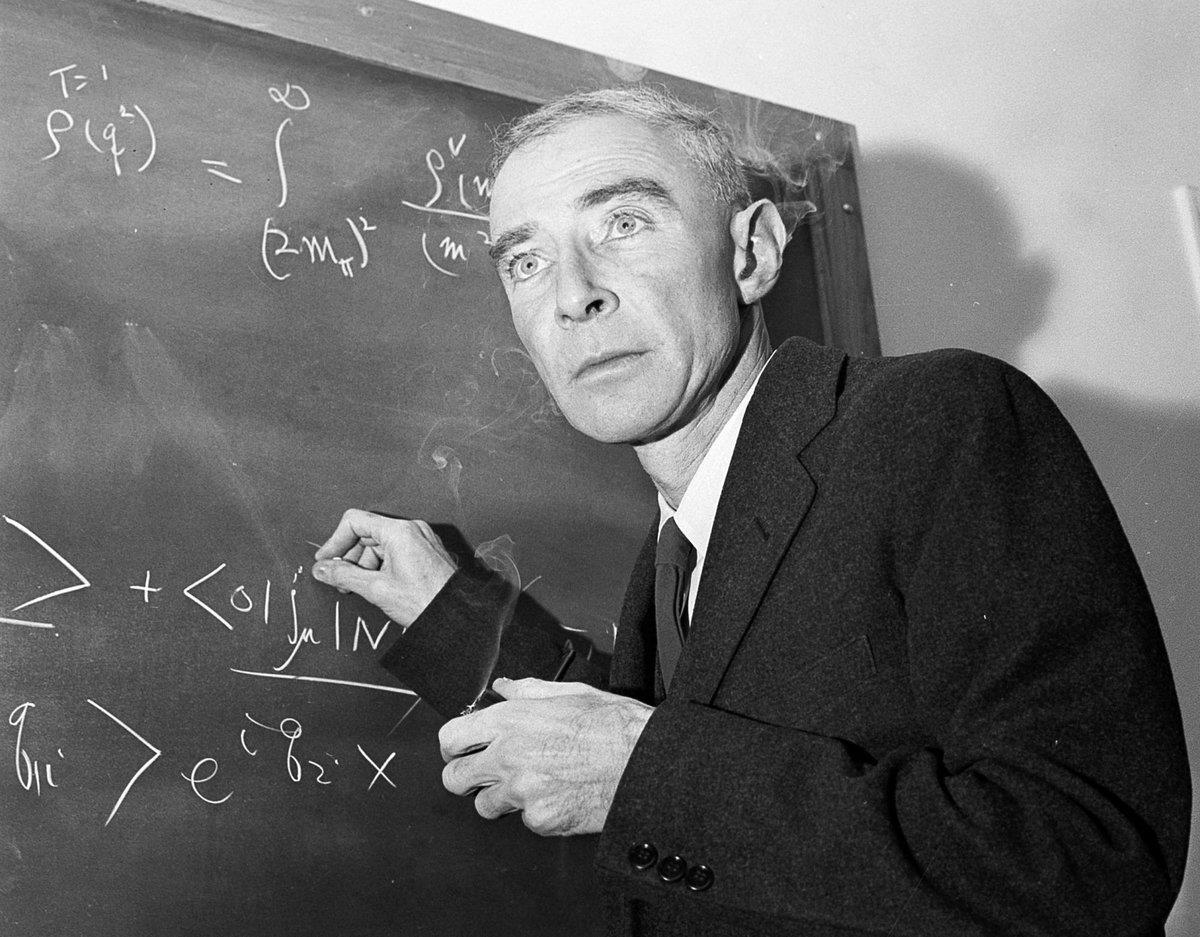إذا كان يبدو من غير الطبيعي للبعض أن يكون السينمائي الإيراني عباس كيارستامي، واحداً من عدد محدود جداً من منظرين للسينما من غير الأوروبيين والأميركيين، دخلوا، ومن باب عريض على أي حال، واحداً من أهم وأحدث القواميس التي صدرت حول الجوانب الفكرية في الفن السابع ( وهو المعنون بالتحديد «قاموس الفكر السينمائي والذي ستصدر ترجمته العربية خلال الشهور المقبلة عن مؤسسة نقل المعارف البحرينية التي يشرف عليها المفكر التونسي طاهر لبيب)، فإن الفضل في دخوله لا يعود إلى أفلامه بالتحديد. فهذا القاموس لا يعنى بالأفلام في حد ذاتها بل بأفكار أصحابها ومساهماتهم التجديدية في تفكير السينما. ومن هنا فإن أياً من أفلام كيارستامي ليس له مدخل في القاموس، بل يتمثل حضور المخرج في كيف فكّر في السينما وكيف اشتغل عليها. والحقيقة أن هذا الجانب من النشاط الإبداعي للمخرج الراحل باكراً بعدما جعل لبلاده، رغماً عن حكامها، مكانة كبيرة في الحياة السينمائية العالمية استفاد منها عدد من المبدعين السينمائيين الإيرانيين الذين يمكن القول أن ليس لأي منهم حظوة في بلاد الملالي، لكن هذه حكاية أخرى بالطبع، أما ما يعنينا هنا فهو سينما كيارستامي نفسه، الذي من دون أن يبرز كمعارض سياسي في بلده، حقق أفلاماً وصاغ نظريات وحضر في الساحة الإبداعية العالمية خلال السنوات الأخيرة من حياته، ودائماً عبر نتاجات تتناقض كلياً، إنما بذكاء شديد وموهبة استثنائية، مع ما هو مطروح في ديار ولاية الفقيه. ومن هنا اشتغال الباحثين الدائم على تفكيك شفرات أعماله ليكتشفوا فيها عدداً من تيمات وأفكار وخلفيات من المؤكد أنها هي ما برّر حضوره في القاموس الذي أشرنا إليه. ولعل الموضوعة الأساسية لدى كيارستامي تتمثل في إلحاحه على مسألة الحدود المستحيلة بين الواقع والمتخيّل، ليس في الفن السينمائي وحده، بل في الإبداع ككل وهو ما سنعاينه هنا.
> ولعل يمكننا البدء بأن نقول هنا أنه إذا كان في وسعنا أن نتحرى حضور هذه الموضوعة المركزية في مجمل إبداعات كيارستامي بما فيها السينما والتصوير الفوتوغرافي والشعر وصولاً إلى ما طرحه في الفيلمين «غير الإيرانيين» اللذين حققهما آخر سنوات حياته، واحد في إيطاليا («نسخة طبق الأصل») والثاني في اليابان («مثل عاشق»)، فإن ثمة فيلماً مبكراً في مسيرة كيارستامي كان الأكثر وضوحاً في طرحه للمسألة، ناهيك بأنه كان في الوقت نفسه فيلماً عن السينما في حدّ ذاتها، وعن قوة السينما وسحرها وتأثيرها في الحياة اليومية للناس. ولعل «أغرب» ما في هذا الفيلم، أنه ليس روائياً تماماً، وليس وثائقياً بالمعنى المتعارف عليه للكلمة. كما أنه لا ينطلق من حكاية مكتوبة سلفاً، لكن كل ما فيه من عناصر سردية يجعله شبيها بفيلم كُتب له سيناريو مسبق يخلو من أي ارتجال. ونتحدث هنا عن فيلم «لقطة مكبرة» (1990) الذي أدهش النقاد الغربيين وأهل السينما في أوروبا إلى درجة أن المخرج الإيطالي ناني موريتي سيحقق بعده بست سنوات فيلماً قصيراً عنوانه «يوم العرض الأول لفيلم «لقطة مكبرة»...» وهو يعني بذلك العرض الأول للفيلم في صالته التي يملكها في روما. فعلام هذا كله؟ وما هو هذا الفيلم؟
> ببساطة نحن هنا أمام فيلم يتحدث عن حادثة «جنائية» حقيقية، يقوم بالأدوار الأساسية فيه أصحاب العلاقة أنفسهم، بدءاً بـ «المخرج الجاني» وصولاً إلى القاضي الذي حاكمه بالفعل والذي رضي أن يلعب المحاكمة أمام كاميرا كيارستمي، مروراً بالشرطي الذي قبض على الجاني والذي استدعي من الجبهة ليلعب دوره الذي كان لعبه في الحياة الحقيقية قبل ذلك خلال المحاكمة. وكما فهمنا حتى الآن لا بأس من القول إن موضوع الفيلم هو تلك المحاكمة، ولكن أيضاً تلك «الجريمة» التي استدعتها. والجريمة هي عملية تزوير سينمائية بالتحديد. وتزوير حدث بالفعل، أو لنكون أكثر دقة في تعبيرنا، عملية احتيال كانت في منتهى البساطة أول الأمر قام بها شاب عادي عاطل من العمل يدعى حسين سابزيان، ادعى ذات يوم أنه هو المخرج الإيراني المعروف محسن مخملباف صاحب فيلم «سائق الدراجة». والحكاية بدأت، إنما ليس الفيلم الذي سيحققه كيارستامي بعد حين، حين كان حسين المذكور في حافلة ركاب عمومية ليرى أمامه سيدة يبدو عليها أنها تنتمي إلى البورجوازية المحلية، ولدى مشاهدتها منشوراً بين يديه يتحدث عن فيلم «سائق الدراجة» لمخملباف، يدخل الشاب في حديث مع السيدة المتقدمة في العمر حول الفيلم والسينما في شكل عام، ليخطر في باله أن يزعم أمامها أنه هو نفسه محسن مخملباف، ولأن السيدة وهي مدام أهانخان لا تعرف مخملباف كثيراً على رغم حبها للسينما الذي تكتشف أن الشاب يشاطرها إياه، ولأن ثمة بالفعل شيئاً من التشابه بين حسين والمخرج الحقيقي، يصل بهما الحديث المتبادل إلى اقتراحه أن يزورها وعائلتها في دارتهما الأنيقة التي قد يصوّر فيها «فيلمه المقبل الذي يزمع تحقيقه». وبالفعل تدعوه السيدة وزوجها إلى البيت ويبدأ هو بمعاينة المكان ودراسة إمكانية التصوير فيه وذلك عبر ثلاث زيارات متتالية خلال أسبوع واحد أيام الثلثاء والخميس والسبت. والطريف أن هذا كله بدا حقيقياً بحيث أن المعرفة توثقت بين حسين والعائلة فذهبوا معاً إلى السينما لمشاهدة فيلم يوم الثلثاء... ولكن يوم الخميس بدأت الشكوك تداعب العائلة المضيفة، أما يوم السبت فكان يوم القبض على المخرج المزيف. وهي عملية دعي في شكل ما إلى المشاركة فيها صحافي تناهت الحكاية إلى أسماعه وسُمح له بأن يرافق في سيارة أجرة شرطيين أُرسلا للقبض على الجاني. وسيكون هذا الصحافي وتدخّله في الأمر، الخيط الذي يقود الحكاية كلها بالنسبة إلى كيارستامي الذي ما إن عرف بالحكاية وتفاصيلها وهو المعروف في ذلك الحين بصداقته مع مخملباف، حتى قرر أن يصورها في فيلم جديد له. وكان رهانه منذ البداية أن يعيد تركيب الحكاية كلها وكأنها عمل تخييليّ (روائيّ)، ولكن في أبعاده التوثيقية: أي وكما أشرنا أعلاه، أن يصور الحكاية من جديد مستعيناً بالأشخاص أنفسهم ليلعبوا أدوارهم الحقيقية، بما في ذلك جعل الاختتام لقاءً بين المخرج المزيف ومخبلماف الحقيقي، وكذلك الإتيان بأم «الجاني» حسين، لتعيد أمام الكاميرا ما كانت شهدت به في المحكمة التي حاكمت ابنها، فروت حكاية حياته، مركّزة على ولعه بالسينما وعلى بؤس حياته وبطالته التي تمنعه من إعالة أسرة ما تسبب في طلاقه وعجزه عن الاحتفاظ بولديه. أما هو فلم يكن شيء من حياته يهمه بقدر ما يهمه حبه للسينما. وهو على أي حال لم يسرق من بيت أسرة آهانخاه سوى بضعة ملاليم لا يُعتد بها ما أدى في نهاية الأمر إلى إسقاط العائلة الدعوى في حقه.
> طبعاً بالنسبة إلى كيارستامي لم يبد أنه مهتم بكل تلك التفاصيل. كان ما يهمه في الحكاية مسألة التزوير وانتحال شخصية المخرج مخملباف، وبالتالي قدرة حسين سابزيان المدهشة على أن يمثل دور المخرج، ناهيك بسحر السينما الذي من ناحية جمع في بوتقة واحدة أسرة بورجوازية، و «مجرماً» صغيراً فقيراً عاطلاً من العمل- من ناحية كون السينما الموضوع المشترك الذي حرك القضية كلها-، ثم من ناحية أخرى قدرة السينمائي، كيارستامي هذه المرة، على أن يعيد عبر السينما الحكاية نفسها إلى الحياة مغرياً في طريقه كل أصحاب العلاقة بالظهور على شاشته من دون أن يدرك أي منهم ما الذي يتوخاه من ذلك الظهور. حتى القاضي الموقّر لم يتنبه إلى ما هو فاعله، إلا بعدما صوّرت مشاهده. ولربما يمكننا أن نقول هنا إن هذا الفيلم بالتحديد أتى يومها متساوقاً على أيّ حال مع السينما الواقعية/التخييلية التي كان قد اشتهر بها في ثلاثية «الواجب المدرسي» و «أين منزل صديقي؟» و «الحياة تسير»، حيث كان ذلك الخلط المدهش ذاته بين الواقع والخيال، من خلال الزلزال الحقيقي الذي ضرب منطقة ريفية بعد تصويره أول أفلام الثلاثية فيها، فإذا بالزلزال يصبح موضوع وبيئة بقية الثلاثية في مسعى من المخرج، لم يتخلّ عنه أبداً لجعل السينما جزءاً من الحياة وهذه الأخيرة جزءاً من السينما. لقد كان ذلك البعد في حكاية سابزيان، ما حرك سينمائية عباس كيارستامي ودفعه إلى تحقيق ذلك الفيلم الغريب والمدهش الذي سيقول منظرو السينما أنه كان مثالياً في احتوائه على السينما ونظرية السينما، الحقيقي والمتخيل، والسينما وبديلها في بوتقة واحدة.