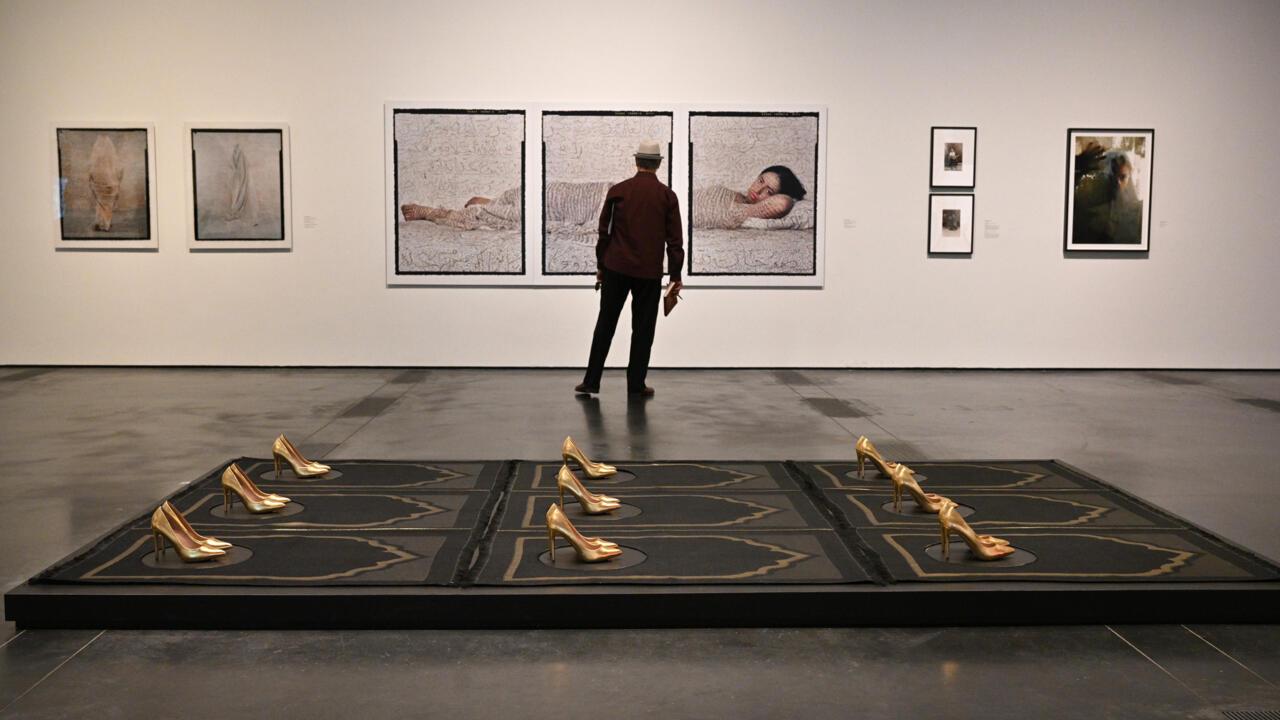في بداية حياتي المهنية عملت مدرسًا لطلبة المرحلة الثانوية، وكانت هذه المرحلة من أجمل مراحل حياتي وأكثرها غنى وتأثيرًا. فقد كنت أتعامل مع الشباب في أفضل المراحل العمرية وأكثرها تفتحًا على الفكر والحياة. ومع ذلك فإنني مازلت أذكر أنني كلما كلفت طلبتي بموضوع كتابي، إلا وبدأوا زمنيًا، ومنذ المقدمة من آدم عليه السلام.
فمثلاً إذا كان الموضوع عن الحرية، كتبوا: منذ خلق الله الإنسان والأرض وما عليها كان الإنسان تواقًا إلى الحرية. وإذا كان الموضوع عن صراع الانسان مع الطبيعة، كتبوا: منذ خلق الله آدم عليه السلام عرف الانسان الصراع، حيث تقاتل هابيل وقابيل... وإذا كان الموضوع عن حب العمل، قالوا: منذ خلق الله الانسان، كتب عليه الشقاء والعمل والكدح من أجل الحياة.
المهم أن هذه النظرة المقولبة النمطية كانت هي السائدة في ذلك الوقت، لا يستطيع الطلبة الفكاك منها، لأنهم يعتقدون أن البداية لابد أن تنطلق من تلك اللحظة فقط دون غيرها، وأنه لا يجوز أن تكون البداية من لحظة أخرى أو فكرة أخرى أو مدخل آخر. بما يعكس رؤية للعالم لا يستطيع الطالب التخلص منها، لأنها جاهزة وسهلة، ولا يمكن ان يختلف فيها اثنان. فهذا الأمر كان يعكس غياب النظرة التحليلية والقدرة على مواجهة المشكلات واجتراح الحلول بشكل عقلاني. فأغلب الموضوعات والقضايا كان يتم مقاربتها من منطق النظر إلى الأشياء من حيث دلالتها على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا مبحث من المباحث المهمة في علم الكلام، ولكنه لا يمكن ان يشكل القاعدة في مقاربة جميع الأفكار والمسائل الأحداث والحوادث والقضايا التي تحتاج فكرًا ورؤية وقدرة على حل المشكلات ومواجهة الإشكاليات المطروحة في الفكر أو في الحياة نفسها.
هذه العقلية الموروثة بدأ الشباب اليوم، والحمد لله، يتجاوزونها بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية من ناحية، وبفضل التطور الحاصل في علوم التربية وطرائق التدريس، من ناحية أخرى، وبفضل تحول اكتساب المهارات، ومنها القدرة على حل المشكلات، إلى هدف رئيس من أهداف أي تعليم متطور ينتمي إلى العصر، من ناحية ثالثة.
المشروعية المثيرة للجدل:
من الموضوعات المثيرة للجدل منذ سنوات عديدة السؤال المشروع التالي: «هل يمكن أن يكون الحزب الديني ديمقراطيا؟».
وعند محاولة الإجابة تختلف الردود وتتنوع، بين نفي وتأكيد مستدل بتجربة الإسلام السياسي في تركيا باعتبارها دليلا على إمكانية بناء هذه المعادلة الصعبة فيقولون مثلاً: «إن تجربة حزب العدالة والتنمية في إدارة الدولة، أثبت أن بإمكان حزب إسلامي يعمل في إطار منطق الدولة المدنية الديمقراطية، أن ينجح في إقناع الجمهور وكسب ثقته، طالما انه لا يدخل في تناقض مع مشروعية الدولة المدنية وأسسها المستقرة والقائمة على مبدأ سلمية التداول على السلطة في إطار احترام الثوابت والفصل بين الدين والسياسة».
بعيدًا عما يثيره مثل هذا الجدل من تفاصيل، ومثل هذا المثال من إشكالات في الواقع، فإن أي مشروع سياسي لأي حزب أو جمعية سياسية لا يعبر عن فكرة مدنية الدولة وانتمائها إلى العصر، ولا يقوم على الأخذ بمدنية الدولة مبنى ومعنى، واحترام الحريات العامة والخاصة، وصيانة حقوق الإنسان في جميع الأوضاع والحالات، ولا ينهض على العدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية بعيدًا عن أي تصنيف طائفي او ديني او عرقي، لا يمكن أن يكون مشروعًا ديمقراطيًا ولا عصريًا، ولن يكتب له النجاح في الغالب، مهماً امتلك من أدوات تزييف الوعي، ومن إمكانات مادية وبشرية. وذلك لأن الناس لن يقبلوه عند اكتشاف عجزه، وتعلقه بالشعارات وليس بالبرامج التي تخدمهم.
إن بناء الدولة الديمقراطية واستمرارها لا يمكن أن يتحقق من خلال الأحزاب السياسية التي تعبر عن القوى الاجتماعية الطائفية، لأن البناء الديمقراطي المدني لا يمكن أن ينهض به إلا من خلال القوى التحررية المستنيرة، صاحبة المصلحة في قيام الديمقراطية وانتشار الحرية. إلا أن هذه القوى التي كان التعويل عليها دائمًا في الحفاظ على استقرار الدولة وتوازناتها، قد بدأت تتآكل منذ سنوات، وتزعزعت مكانتها لأسباب متعددة، وبقيت القوى المتسيدة في الساحة هي القوى المحافظة المستندة إلى ثقافة تغييب العقل والخلط بين القيم والشعارات الديمقراطية شكلاً، وتنفيذ سياسات استبدادية طائفية مضموناً.
إن المسألة الديمقراطية نتاج الحداثة والحرية واحترام الحق في الاختلاف وتعايش الأفكار على اختلافها، بعكس ما هو سائد من نظرة سطحية تركز على الصراع على السلطة، ولذلك يتم التركيز فقط على الانتخابات وعلى السيطرة على السلطة والموارد (يلاحظ طبيعة النقاش بين القوى السياسية في العراق والسودان وليبيا حاليًا هو حول تقاسم النفوذ والثروات والسلطة).
كما إن الديمقراطية لا يمكن أن تنبت عن مسألة الحداثة التي اقتصرت في أغلب البلاد العربية على (التمدن المادي الخارجي المظهري) مع الاحتفاظ بالبنى التقليدية مهيمنة على حياة الفرد ومصيره وعلى حياة المجتمع ومصيره، فكل فريق يمتلك السلاح والمليشيات المسلحة ويهيمن على مناطق جغرافية باتت معروفة باسمه ومقصور دخولها وسكناها على هذه الفئة دون غيرها، هذا بالإضافة إلى الغياب شبه الكلي لمظاهر وحدة الدولة (لكل علمه ولكل مذهبه ولكل أعياده ونشيده وتعليمه ومساجده ومستشفياته وإذاعاته وقنواته الفضائية.. إلخ). فالحداثة التي تتحدث عنها بعض تيارات الإسلام السياسي لا علاقة لها بالحداثة المتعارف عليها في العالم، كذلك الشأن بالنسبة لمدنية الدولة. ومن المفارقات العجيبة أن مثل هذه التيارات الغارقة في الطائفية تكرر استخدام مصطلحات مفارقة لطبيعة تكوينها وفكرها وسجالاتها الأيديولوجية مثل الحديث عن الدولة المدنية والتي تعني في النهاية المظاهر الحديثة (زمنيًا) للدولة لا أكثر ولا أقل، وليست فكرًا ولا آلية للحكم وليست تبنيًا لقيم ولثقافة المواطنة والعمل المنتج والشفافية وتكافؤ الفرص.