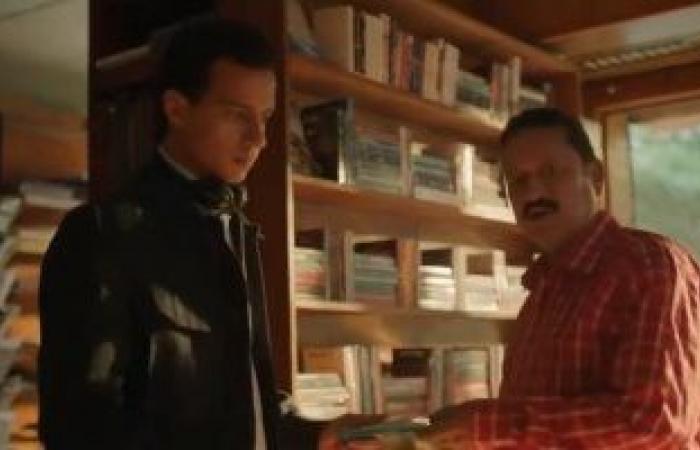إذا كان نجيب محفوظ قد أهدى العالم العربي أولى جوائز نوبل للآداب، فما زال الطيب صالح يهدي العالم العربي منطقة اهتمام أدبيّ جاذبة لأنظار العالم نحو إحدى أهم الروايات العربية في التاريخ الحديث. موضوع رواية الطيب صالح الشهيرة «موسم الهجرة إلى الشمال» ما زال هو الموضوع الأساس للانعكاس المباشر للعلاقة المختلة بين الشمال المتطور وبين الجنوب المتخلّف؛ ليبدو العالم الثالث مؤطرا في العيش في شكل (المستقبل) الذي رسمه حدس الأديب السوداني الطيب صالح في روايته الشهيرة «موسم الهجرة إلى الشمال».. فما زال الغرق الذي كان مصير مصطفى سعيد بطل الرواية هو نفسه مصير آلاف المهاجرين إلى الشمال. الفرق الوحيد هنا هو أن الغرق الذي تخيّله الطيب صالح لبطله كان غرقا لشخصيتين اثنتين في إطار هو «نهر النيل» أما اليوم فاتسع الغرق بحجم أميال شاسعة من البحار والمحيطات وبمآسٍ بعدد آلاف من البشر.
ستلمع منارة موسم الهجرة إلى الشمال كلما خرجت لنا غرف الأخبار في العالم بالقصص الجديدة لعشرات المهاجرين المتسللين وهم يحاولون حظوظهم في بلاد الشمال. ستلمع مع كل مشهد غرق جديد لمهاجر أو طفل لاجئ. هكذا تقرر «موسم الهجرة إلى الشمال» العودة مع كل نشرة أخبار تتكلم عن مآسي الهجرة غير الشرعية. تعاود اشتغالها النقدي مع كل نقاش حول أسباب الهجرة المتزايدة وحلولها الممكنة. قدرة «موسم الهجرة إلى الشمال» على الحياة المتجددة، تجعلنا نتساءل عن سر جاذبيتها التاريخية وحضورها الواقعي؟ أهي حظوظ القدر الأدبي أم نبوءة الخيال الإبداعي؟!
موسمية الهجرة والعودة
إن «الموسمية» التي يتصف بها عنوان رواية الطيب صالح تجعل منها ما يشبه النبوءة المرعبة القابلة دوما للتكرار. من عادة المواسم أن تعود، مثلما أن من عادة الفصول أن تتغير. حكت الرواية بواقعيتها الرمزية عن تاريخ من الاستعمار والمقاومة المضادة، تلك المقاومة التي تتجلى في فِعال وانفعال بطل الرواية مصطفى سعيد وهو يقضي أيامه اللندنية بحياة فردية ذات أبعاد جماعية، وهي ليست جماعية المجتمع الصغير أو الوطن الكبير، لكنها تصير كوجدان الأمة التاريخي منذ تاريخها الغابر في «أندلس خصب»، لا بل تصبح جماعية كل منطقة الجنوب التي ما زالت تكافح لتهاجر معنويا إلى شمال التطوّر. لكن موسم الهجرة إلى الشمال لا تنفك أيضا عن التذكير بفصلية الاستعمار وموسمية الهجرة وهي ذكرى مرعبة ولا شك وتشبه سردية المخفي من جبل الجليد، حيث تبدو الهجرة المتزايدة في العالم من الجنوب إلى الشمال كجزء ظاهر من جبل الجليد الآخر المغمور الذي يعبّر عن الكولونيالية الجديدة التي تختفي دائما عن الأنظار، فتظهر المشكلة ويختفي سببها. ربما تبدو واقعية الرواية المستمرة في إلحاحها على هذا «التبادل الموسمي» الذي يتقلّب بين موجات استعمار جديد وموجات هجرة جديدة. كأن سر موسمية الرواية يكمن في تلك (الفجوة) التي تتسع يوما بعد يوم بين عالم يجد كل شئ وآخر لا يجد أي شئ.
لا تنسى الرواية أيضا الهجرة كمشروع حين يستنفد وقته، أو كما تتساءل الرواية ذاتها عن كنهه «هل هي رحلة أم هجرة؟»، حيث تبدأ الرواية بمشهد الرجوع إلى الجذور وصورة العودة الاحتفالية:»عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة» لكنها تختتم بمشاهد الغرق والنهاية الغامضة وطلب النجدة. كأنها تتأرجح بين عودة مؤكدة إلى الوطن ومصير غامض كغموض تبعات ركوب البحر شمالا باتجاه المهجر.
فشل الهجرة في الرواية يعني أيضا فشل الاندماج في مجتمعات الشمال، وهو الفشل الذي يقض مضاجع الحكومات الأوروبية اليوم لتلافي أخطاره،؛ بل تمضي الرواية لأعمق من ذلك برسم صورة قاتمة لآثار عودة المحقونين بـ»جرثومة الشمال» في بلاد الجنوب التي تمثلها في الرواية قرية مصطفى سعيد عند منحنى النيل. إنها تشير دائما لذلك الاغتراب الذي يمكن أن يصيب المهاجر إلى الشمال والعائد منه، نرى ذلك في استياء الراوي العائد من الغربة من حياة القرية: «أنا الآن وحدي، لا مهرب، لا ملاذ، لا ضمان. عالمي كان عريضا في الخارج، الآن قد تقلص»، إلى أن يقول»لا مكان لي هنا، لماذا لا أحزم حقيبتي وأرحل؟». مصير أبطال الرواية يجعلنا نستبين حجم (الفجوة) بين عالم الجنوب وعالم الشمال. «على مرمى حجر من خط الاستواء تفصل بينهما هوة تاريخية ليس لها قرار». الفجوة المتسعة التي تبتلع بداخلها أشكالا من النزاع والعنف.
عنف الضحية
أمر آخر يظل يستدعي رواية الطيب صالح دائما في موضوعات الهجرة المعاصرة وهو العنف أو العنف المتمظهر في الجنس. سواء كان هذا العنف من المهاجرين أو ضدهم، خصوصا عندما نستعرض سيرة مصطفى سعيد الغارقة في العنف الجنسي ونقابلها مع شكوى بعض المجتمعات الأوروبية من تزايد حالات الانفلات الجنسي من بعض المهاجرين. إذا قرأنا العنف في رواية الطيب صالح بمنظور الصراع مع الغرب الذي انبنت عليه أعمدة الرواية فسيبدو لنا - رغم قسوته غير المشكك فيها – تعبيرا مقابلا لعنف الاستعمار، فيصبح «عنف الغازي الذي جاء من الجنوب» بعبارة مصطفى سعيد ضد (عنف الغازي الذي جاء من الشمال) بلسان حال عقدة الرواية. لا تخفي الرواية هذا الشعور المغبون بالعنف، يظل واضحا:»جرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثله من قبل»، ومعلَناً بالغرض والخلفية التاريخية: «جئتكم غازيا في عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ». ويمكننا القول أن الطيب صالح سعى لتوظيف عقدة الجنس والعنف في علاقة الشمال بالجنوب لخلق مستوى من المقابلة وتكوين منطق من الفعل ورد الفعل. يمكن لهذا المنظور أن يفتح أفقا أوسع لحوار أكثر فاعلية مع الغرب وتياراته الشعبوية المتبرمة من حركة الهجرة الجديدة، للحديث أكثر، وبشكل أوضح، عن مستويات العنف الهيكلي (بتعبير يوهان غالتونغ)، الذي يكمن في بنية وعلاقة المؤسسات الغربية بالعالم الثالث، والعنف الموضوعي (بتعبير سلافوي جيجك ) الذي يندمج مع آليات النظام الاقتصادي المعولم. هذا النوع من الحوارات ينشغل مباشرة بالسبب لا الأعراض، ولا يستهلك وقته كثيرا في الالتفات العاطفي لـ(عنف اللحظة) كرد فعل، لكيلا يصرفه عن النظر المتبصر في الآليات المولّدة للعنف كفعلٍ أصيل. بهذه القراءة إن كانت (شيلا غرينود، وآن همند، وإيزابيلا سيمور، وجين مورس) ضحايا عنف مصطفى سعيد(عنف فردي)، فمصطفى سعيد نفسه ضحية لعنف الاستعمار(عنف جماعي، عنف الغازي الذي جاء من الشمال)، ذلك العنف الذي يحكيه مصطفى سعيد «لكن بروفيسور فستر كين حوّل المحاكمة إلى صراع بين عالمين، كنت أنا إحدى ضحاياه». ومثلما ينظر البعض في الغرب للهجرة كعنف مهدّد للمجتمعات المحلية يمكن أن يُنظَر للمهاجرين كضحايا عنف تاريخي ظل يستمر بأشكال ناعمة.
جهات الغرق المنتّظَر
تبدو حركة الاتجاهات والغرق في رواية موسم الهجرة إلى الشمال موضعا محفّزا لاحتماليات التنبؤ الأدبي التي تدعم قدرات الرواية على الحضور المشهدي في عصر الهجرة الإشكالي الراهن. منذ العام 1966م، تاريخ بداية نشر الرواية مجزأة في مجلة حوار، بدأت مشاهد الغرق المأساوية للمهاجرين تتراءى في آخر فصول الرواية عبر وصف مفصّل لاحتدام أحلام الهجرة إلى الشمال بآمال الحياة في الجنوب داخل قلب الراوي الغارق الذي يحاول التشبث بأي شئ موصول بالحياة في الوطن. هذا الفصل الأخير من الرواية التي أكملت عقدها الخمسين يصلح الآن كنص جديد وصالحٍ تماما لتقرير تلفزيوني مباشر من أحد شواطئ الموت التي تستقبل جثث المهاجرين. الفرق الوحيد أن هؤلاء المهاجرين يصارعون بحارا عريضة ومشكلة حياة أعرض، بينما كان بطلا «موسم الهجرة إلى الشمال» يصارعان «النيل»أطول نهر في العالم. أهي إشارة أخرى لرؤية تنبؤية بطول أمد مشكلة الهجرة المعاصرة؟!
الغرق الذي يكون مصيرا للراوي ولمصطفى سعيد يحدث في ذات النيل الذي يماثل حلم الخلاص/حلم الهجرة. فنهر النيل الذي تحتفي به الرواية لا يمثل الحياة والاخضرار والاستمرار فقط لكنه يمثل المحفّز لحلم الهجرة أيضا «أرمي الحجارة في النهر وأحلم»، ولهذا فإن الرواية قد سعت لمسرحة النيل لعرض فصول الهجرة إلى الشمال منذ أولى صفحاتها وحتى آخرها؛ ليس النهر في ذاته فقط ولكن في حركة اتجاهه الحتمي نحو الشمال الجغرافيّ أيضا. نقرأ من الرواية: «ولأن هذا النيل يجري نحو الشمال لا يلوي على شئ . قد يعترضه جبل فيتجه شرقا وقد تصادفه وهدة من الأرض فيتجه غربا، ولكنه إن عاجلا أو آجلا يستقر في مصيره الحتمي ناحية البحر في الشمال». وتبدو المفارقة القاسية في مصير أبطال الرواية (راويها وبطلها الأساس) في أنهم وهم يصارعون موتهم تتجه أجسادهم المغلوبة بالأمواج ناحية الشمال الذي طالما كان موضع نزاع للغلبة والانهزام، بينما بقية الروح تتجه بكل ما فيها من وداع للوطن الذي يصبح مدفنا، ونهايةً في نفس الوقت لحركة الجثث المتوجهة شمالا. إنها ورطة أن تظل عالقا في المنتصف» أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب. لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة».
النجدة كحل أخير
إذا كانت الهجرة إلى الشمال في الوقت الذي كتب فيه الطيب صالح روايته آنذاك، موسما لطلب (الحياة الغربية)، فإن موجات الهجرة في القرن الواحد والعشرين تصبح موسما لطلب (الحياة الإنسانية) في ذاتها، ولهذا تصبح أكثر تعقيدا وإلحاحا على الحل. مشهد الرواية الختامي لا يستدعي للبال واقع الضحايا الحاليين للهجرة غير الشرعية فقط، لكنه يخاطب أيضا المشاعر الإنسانية في بذل المستطاع لإنهاء مشكلة المهاجرين بتلك الصرخات الأخيرة التي كانت تنطلق من حنجرة راوي القصة وهو يصارع الغرق: «النجدة، النجدة». إن النجدة التي تقتضيها الدراسة المعمقة لرمزيات البناء الكلي لرواية «موسم الهجرة إلى الشمال» لا تقتصر على نجدة المهاجرين فحسب، بل تتعداها إلى نجدة الهجرة نفسها كمشكلة، لأن حلها يعني وصول المهاجرين ليابسة آمنة. وهذا ما اشتغلت عليه الاستدعاءات الرمزية في نص الرواية، بتطرقها لصراع الشمال والجنوب، موسميته، مظاهره، ونتائجه. تهب الرواية حكمتها للحلول الممكنة بسخاء، في عبارتها جامعة المعاني: «ضاعت اللحظة الخطيرة حين كان بوسعك الامتناع عن اتخاذ الخطوة الأولى.. لو أن كل إنسان عرف متى يمتنع عن اتخاذ الخطوة الأولى لتغيرت أشياء كثيرة». هي إذن العلاقة بين حكمة الخطوة والوقت. حكمة الإجابة على (متى) التي تجعل من الرواية زمنا ممتدا في الحاضر رغم أنها ابنة القرن الماضي.
إنها تصر على أن تبدو دائما كرواية كاتِبة للمشهد لا مقروءة في السياق فحسب.