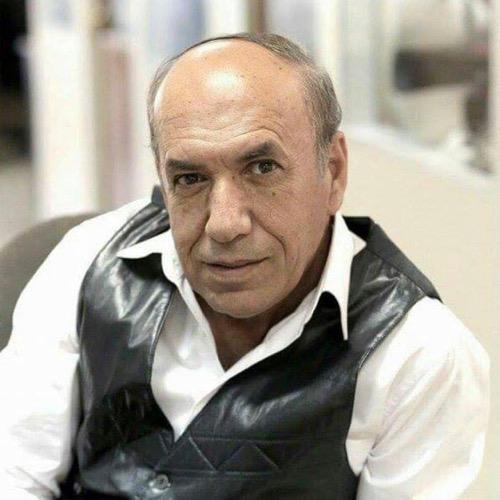آلمني كثيرا خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي (عليه السلام) الواقع في قرية القديح في محافظة القطيف السعودية. وأدمعت عيني مقاطع الفيديو التي عرضت أشلاء الشهداء وهي متناثرة في أنحاء بيت من بيوت الله، وفطرت قلبي صور الطفل الشهيد وما تضمنتها من رسائل - لسان حاله - إلى أمه.
آه... لو كان هناك جراح ماهر ومات طفل من عمر الشهيد بين يديه أثناء عملية خطيرة، لعتبت على الجراح بعد شكره على مساعيه. فما بالك بمن يقتل طفلاً، فقط لأن مذهبه مختلف وبذلك توجب تفجيره في لحظة كان يعتقد فيها بأن في قربه من والده الأمان وفي صلاته طاعة للرحمن.
استشهاد هذا الطفل ذكرني برجل بريطاني، من أصول أفريقية وفي لباس عربي، كان يخطب في حشد من الناس في لندن. وبعد أشهر من إسقاط نظام صدام حسين. الخطيب كان يحذرهم من المخاطر التي تحيط بالقوات البريطانية المتواجدة في العراق قائلا «ما ذنب أطفالنا الذين سيقتل آباؤهم في العراق من أجل قضية لا تعنينا؟، وما جريمة زوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وعوائلهم وأصدقائهم؟».
وجدت الجمهور منصتاً لشيخ الدين البريطاني وكأنه سيطر على عقولهم وامتلكها. قائلا لهم «اتصلوا بنوابكم وطالبوهم بإرجاع أبنائنا وفلذات قلوبنا إلى الوطن، ودعوا العراق للعراقيين ليمارسوا حقهم في تقرير مصيرهم». قرأت الاقتناع والطاعة في وجوه الجمهور، وتخيلت في تلك اللحظات القوات البريطانية وهي تنسحب من العراق ثم تتبعها الأميركية، فعودة حزب البعث لحكم العراق بقيادة صدام، وبداية مسلسل التهديدات على حدودنا والتفجيرات في أسواقنا وأماكن تجمعنا.
فوجدت نفسي أسأل الجمهور إن كانوا يعلمون بأن محدثهم الحنون يؤمن بحقه الشرعي في سلب أموالهم وسبي نسائهم وقتلهم جميعا بما في ذلك أطفال الجنود الذين يتباكى عليهم. واستفسرت إن كانوا يعرفون بأن زملاء الخطيب العطوف هم من بين من يفجر في العراق ليقتل في المساجد والأسواق رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاً. فقاطعني صاحب القلب الرقيق قائلا «إن كان الآباء يؤيدون الغزو الاميركي على العراق، فهم وأسرهم وأطفالهم أهداف مشروعة ويستحقون القتل كما قتل الأميركيون العراقيين وأبناءهم، مستدلا بالقرآن الكريم قائلا «النفس بالنفس»ثم «العين بالعين»م ن القرآن والتوراة والإنجيل. وسرعان ما استنكر الحضور منطقه المشوش وبدأوا بالانصراف.
وما هي إلا لحظات، وإذا بشخصين بعثيي المظهر (حليقي الوجه وصداميي الشارب) يقتربان مني ويعتبان علي - بلهجة عراقية - مستنكرين موقفي. لم أطل النقاش معهما وتركت المكان مع أسرتي. وتساءلت في وقتها إن كان في تصرفي تهور وتهديد لسلامتي وأسرتي. بلا شك عرضت أسرتي لخطر محدود، ولكن لم يكن في ذلك تهور بل تعقل لأنني حميتهم من تهديد أكبر كنت أراه قريباً.
مع مرور الأيام اشتدت التفجيرات المستهدفة للمدنيين في العراق، وبرزت شخصيات وقوى متطرفة تتبنى الإرهاب على الهوية الدينية. تخوف الكويتيون من امتداد عدوى القتل الفئوي إلى أسرهم، فلجأ البعض إلى النواب مستنكرين عجز الحكومة عن مواكبة المستجدات الإقليمية، وطالبوهم بتفعيل أدواتهم الدستورية قبل أن «تطيح الفأس العراقي بالرأس الكويتي»، ولكن الكثير من الأعضاء كانوا منشغلين بحماية شيوخ الحكومات المتتالية ولو على حساب سلامة النسيج الوطني، وبعضهم كان متفرغاً للتجهيز لمحاربة إسرائيل لأنها هي المسؤول الأوحد عن كل الإرهاب في العراق والمنطقة، وأما أبو مصعب الزرقاوي ومن في حكمه فهم شخصيات خيالية هوليوودية!
في تلك المرحلة الحساسة، قمعوا الأصوات التي نادت بالتصدي المنهجي لمخاطر التطرف الديني. وأجهضوا المطالبات بتعزيز التعددية ونعتوها بالطائفية. وتبنوا مشروعين لتجاوز المرحلة: الأول رص صفوف الكويتيين لحماية الشيوخ الوزراء، والثاني توحيد المسلمين لتحرير فلسطين. فهم لم يكتفوا بالتهرب عن مواجهة الفكر الإرهابي ومنابع تمويله، بل شغلوا الناس عنهما. وما زالوا، فاليوم يختزلون مسؤولية تفجير القديح في رموز الخطاب الديني المتطرف، مستثنين أقطاب التطرف السياسي، ومتناسين دورهم السلبي.
مثلما نبذ البريطانيون محدثهم السفاح عندما عرفوا حقيقته، أتمنى أن يحاسب الكويتيون هؤلاء النواب والنشطاء السياسيين المتباكين على ضحاياهم في مسجد القديح وخارجه.
abdnakhi@yahoo.com