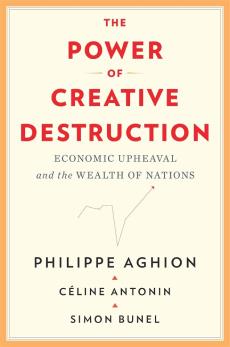أوضحت سابقاً، كيف تعرضت العلمانية، كمفهوم سياسي وافد إلى الفضاء الثقافي العربي، لتشويه وسوء فهم كبيرين، من أعدائها الطبيعيين الإسلاميين، ومن بعض أصدقائها العلمانيين، كما ذكرت الآثار الإيجابية للعلمانية على الدول التي تبنتها، وفِي هذا المقال أحاول الإجابة عن تساؤلين مهمين:
الأول : ما حاجتنا إلى العلمانية، وهي فكرة مستوردة من الغرب، وتتسم بـ «خصوصية ثقافية أوروبية» لا تنسجم مع تاريخنا، ولا تصلح لمجتمعاتنا وخصوصياتنا الثقافية والدينية، وقد أغنانا المولى عز وجل بالإسلام ديناً هادياً ينظم شأنينا العام والخاص؟
للإجابة عن هذا التساؤل، نقول: نعم، نحن بحاجة إلى مضامين العلمانية، لتجاوز واقع التخلف والعجز والفرقة والنزاعات العصبية (القبلية والطائفية)، الذي جعل بأسنا بيننا شديداً، وحوّلنا إلى مجتمعات عالة على العالم (مستوردين مستهلكين)، للحاق بركب المنتجين المزدهرين.
الذين يتمسكون بالخصوصيات الثقافية والدينية والتاريخية، حجة لرفض المفاهيم المستوردة، في عالم اليوم، إنما يعانون انفصاما عن واقع حياتهم وحيات مجتمعاتهم المعاصرة، فنحن منغمسون في منتجات الحضارة، مادياً وفكرياً، حتى النخاع، ونحن لم نستورد فقط العلمانية، إنما كل شيء في حياتنا (أفكاراً ومعارف وعلوماً، فضلاً عن الماديات) وشأن العلمانية لا يختلف عن القيم الأخرى من الديمقراطية، والاشتراكية، وحقوق الإنسان.
أما الخصائص الثقافية للمجتمعات، فأمر لا ينكر، إلا أنها اليوم، أصبحت نسبية في عصر العولمة، فما من خاص إلا أصبح عاماً، وسقطت الحواجز، وأصبح العالم متشابكاً في كل شيء، يتأثر ويؤثر بعضه في بعض (وهذا الوباء العالمي الذي أدعو المولى أن يرفعه، خير دليل) وصارت الخصوصية الثقافية حجة واهية، أما الخصوصية التاريخية، فصحيح أن نشأتنا التاريخية مختلفة عن الغرب، لا كنيسة ولا بابا في تاريخنا، إلا أنه لا إنكار لوجود سلطة دينية كانت جزءاً من منظومة الخلافة، تتدخل في الشأن العام، تتهم وتكفر وتصادر حرية الفكر وتستعدي السلطة على المفكرين الذين تُعدهم زنادقة ومرتدين، فكانوا يُضطهدون... وفي عهد المهدي وحده، أقيمت محاكم الزنادقة التي قتلت وحرقت جمعاً كبيراً من المفكرين والشعراء (موسوعة العذاب للشالجي 7مجلدات، وتاريخ التعذيب في الإسلام للعلوي، وديوان الزنادقة).
أما الخصوصية الدينية، فصحيح أن ديننا يتضمن تعاليم وأحكاماً لتدبير الشأن العام، لكنها مبادئ عامة مرشدة (الشورى، العدالة، المساواة، الحرية) لا تنزل إلى الأمور التنظيمية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أنها لم تمنع الإفادة من تجارب الآخرين، فالحكمة ضالة المؤمن، وما قامت حضارتنا وازدهرت وسادت العالم إلا بقطف ومزج ثمار الحضارات السابقة البيزنطية، والرومانية، واليونانية، والفارسية، والهندية، والصينية.
أما التساؤل الثاني فهو : ما العناصر الإيجابية في العلمانية التي تفيد مجتمعاتنا؟ ونجيب بأن أبرزها :
1 - تأكيد «المواطنة» بصرف النظر عن المعتقد والجنس والطائفة، معياراً للحقوق والواجبات.
2 - تعزيز «مركزية الفرد» في النظامين السياسي والاجتماعي.
3 - رفض توظيف الدين لخدمة الأغراض السياسية.
4 - تجريم استخدام دور العبادة لترويج أجندة سياسية أو حزبية.
5 - تبني مبدأ «الحياد الديني» للدولة، فلا تنحاز إلى دين أو مذهب، بل تعامل جميع أصحاب الأديان على قدم المساواة.
6 -منع وصاية المؤسسات الدينية على الشأن العام.
7 - كسر احتكار المؤسسات الدينية، للفهم الديني، وفرضه على المجتمع.
8 - تمييز الشأن الدنيوي العام من الشأن الديني الخاص.
9 - الفصل بين الفضاءين : الديني والسياسي، وتأكيد أنه لا تعارض بين علاقة الفرد بخالقه، على أساس الاختيار الديني الحر، وعلاقة الفرد بغيره من الأفراد في إطار التنظيم العام، على أساس العقد الاجتماعي الحر.
10 - تنأى الدولة العلمانية عن التحالفات السياسية مع الأحزاب الدينية لضرب مناوئيها من الأحزاب السياسية الأخرى أو العكس، تحالفات تبادل المصالح، وهو ما كان سائداً عبر التاريخ الإسلامي، ولا يزال «أس البلاء».
المحصلة : إذا كانت مجتمعاتنا لا تزال متوجسة من العلمانية، إثر التشويه وسوء الفهم اللذين لابساها، فإنها تستطيع الإفادة من هذه العناصر العشرة، ومن آليات عملها، مما يعينها على تطوير دولها لتكون دولاً «مدنية حديثة»، كما هو الحال في الغرب، مع الحفاظ على قيم الإسلام ومبادئه، بوصفها مجتمعات إسلامية.
* كاتب قطري وعميد كلية الشريعة بجامعة قطر سابقاً.