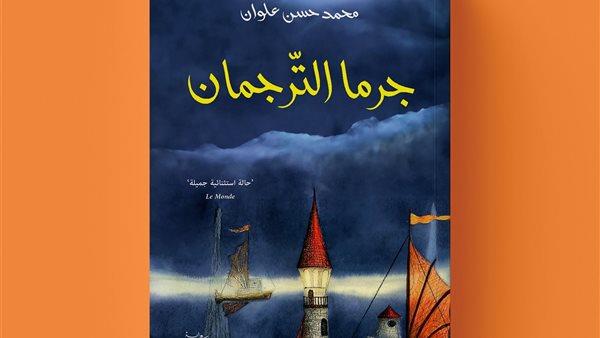في روايته الأولى ، باكورته «بناية ماتيلد» الصادرة (1983)، اهتدى الروائي اللبناني حسن داوود إلى نبرته الخاصةالتي أفردت له مكانا واضحا في مجال الرواية اللبنانية والعربية.
ينتسب داوود إلى ما قرأه وليس إلى جيل معين. يقول أنّه قسا على نفسه وعلى القارئ بكتابة مفتونة بنفسها.
حسن داوود كاتب مميز أخذ الرواية الى مناخات فنية لافتة وفي دردشة معه،حاولت مع الدخول الى عالمه الروائي الخاص.
حسن داوود، روائي وكاتب لبناني من مواليد سنة 1951، أصدر مجموعة من الروايات منها “بناية ماتيلد” و”غناء البطريق” و”لعب حيّ البياض” و”ماكياج خفيف لهذه الليلة”؛ وفي القصّة صدرت له مجموعة “تحت شرفة أنجي” وأخرى بعنوان “نزهة الملاك”؛ ترجمت رواياته إلى الأنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية
(رواية الحرب)
عن المؤثرات الأولى التي أسهمت في تكوينه وتشكيل وعيه الكتابي، يجيب صديقي حسن قائلا: “لا أعرف حقا من أين أتاني التعلق بالكتب؛ أنا نشأت في منزل لم يكن فيه سوى القرآن، وكان محفوظا في غلاف قماشي. والدي لم أره ولو مرة ممسكا بالقرآن أو قارئا له. أمي كانت مؤمنة تصلي وتصوم لكنها أمية لا تجيد القراءة.
في سن مبكرة وجدت نفسي راغبا في اقتناء الكتب أولا ثم في قراءتها؛ في أحيان أعزو ذلك إلى صوت السيد أمين قارئ عاشوراء في الضيعة وكان صوته جميلا وقد أخذتني فصول روايته الحسينية حيث كانت أشبه برواية، وكانت مثقلة بالحزن والتراجيديا، وغنية بلغتها وهذا ما جعلني ربما أكون محبا للغة أو للتعبير اللغوي.
في المدرسة أيضا، وأنا في التكميلي الأول وجدتني أتعلق بالشعر الموزع في صفحات كتاب القراءة وانتبهت إلى نفسي مرة أقرأ قصيدة وكانت قراءتي لها موقعة منغمة على نحو ما يفعل الشعراء، وحدث هذا دون قصد مني؛ طبعا ذلك التعلق الأول جعلني أستمرّ فيه.. عند تذكري لمراحل حياتي أجد أن أكثر ما ينظم هذا التذكر هو اقتناء الكتب أو قراءتها فأول كتاب اشتريته كان لطه حسين سنة 1963، أما ديوان المتنبي بأجزائه الأربعة المغلفة بجلد أحمر فكان محطة أساسية في ما أتذكره من حياتي؛ كان ذلك سنة 1964 وكنت في الرابعة عشرة“.
ويتابع داوود قائلا : رغم قراءاتي وجدت أنني حين جاء وقت الكتابة غير قادر عليها، كتبت نصوصا قليلة بعضها نثري وبعضها شعري ولم تلق من سامعيها صدى جيدا .
أما رجل الدين الذي كان في ضيعتنا فقد ردّ على القصيدة القصيرة التي أسمعته إياها برفع حاجبيه أسفا وكأنه يقول “هذا ليس من الشعر في شيء”، وكأنني كما قيل عن عمر بن أبي ربيعة إنه ظل يهذي حتى قال الشعر، أحسب أنني اهتديت إلى كتابتي بالتدريج فكانت النصوص التي أكتبها لصحيفة “السفير” بدأت تظهر على نفس خاص اهتديت إليه أنا، مثل ما اهتدى إليه غيري من قرائي. آنذاك كان كل أصدقائي قد كتبوا قصائد ذاع صيت بعضها وانتشرت.
ويكشف حسن أن الشاعر حسن عبد الله كان “يقول لي بأنني في قادم الأيام سآكل أصابعي ندما لأنني لم أنجز كتابا في عام 1982؛ وبدأت ذات ليلة بكتابة “بناية ماتيلد”.
قدومه إلى عالم الكتابة، يشرحه داوود قائلا : “مؤونة الكتابة كما أدركت آنذاك، هي أن تعيد تذكر ماضيك كأنه حلم يراودك، هكذا استعدت تخيل الحياة التي عشتها في تلك البناية والتي كانت قد انقضى ما يقرب من 15 عاما على مغادرتنا لها..”.
أضاف قائلا: “نساء البناية.. وخصوصا بعض الرجال القليلين الذين أسلموا أمر حياتهم لنسائهم“.
استعدت مدام “لور” في الطابق الرابع وبيت الكيلاني في الطابق الثاني، في رأيي إن الرواية كانت هنا في ذكر تفاصيل العيش اليومي، والتواصل والتنافر الدائمين بين السكان وكذلك الألفة والغرابة في الوقت نفسه. حين يقال إنها رواية عن الحرب أقول في نفسي إن حضور الحرب فيها ليس أكثر ثقلا، ذلك هو جريان الحياة، أما الحرب فأضيفت بابتسار وتعجّل لأن الحرب حدثت فعلا، وكان ينبغي كتابة ما أودى بمصائر الناس.
بيروت لم تعد بيروت
في «مكياج خفيف هذه الليلة» تابعت الحرب مرسومة على وجه وجسد تلك المرأة التي شوهتها القذيفة وفي “مائة وثمانون غروبا” تعقبت الهاربين منها إلى ملذاتهم معاينا كيف يبدؤون حربهم
وعن بيروت مدينة البدايات،يقول: “لقد ابتعدت بيروت كثيرا عمّا كانت عليه طيلة سنوات كثيرة، بقينا نقول إن بيروت ستستعيد زمنها المزدهر، ولا أخفيك فإننا ما زلنا إلى الآن نسأل أنفسنا إن كان يمكن لهذه العودة أن تحدث؟ ودائما نحصل على إجابات متناقضة، أحينا نقول إننا على رغم أربعين سنة من التراجع والتدهور والتحلل، بقي من يقول إن بيروت هي أفضل مكان للعيش، ليس بين البلدان العربية وحدها بل بين بلدان العالم”.
ويضيف حسن “أحيانا نظن أن بيروت تعطينا دليلا على ذلك، بأنه مثلا يعود شارع الحمراء مزدحما مكتظا، وتنشأ فيه ملاه ليلية راقية يؤمّها ناس كثيرون، أحيانا نقول إن الحياة التي تموضعت في الجميزة انتقلت الآن إلى مارمخائيل؛ ربما نعوّل كثيرا على هذا، إذ نعلم مثلا بأن العالم سبقنا وأن بيروت لم تعد تحتمل إلا نتفا من ماضيها الذي لم نعد كلنا متذكرين له.. في حصص التعليم بالجامعة كنت أسأل الطلاب كيف يتخيلون بيروت ما قبل الحرب؟“
ويتابع: “اكتفوا بأن قالوا إنها تحتوي على بنايات قديمة وسموا بعض ما تبقى منها في رأس بيروت، ولا شيء سوى ذلك. أقصد من قولي بأن بيروت ما قبل الحرب تبتعد عنا، إلى حدّ أنها بعد سنوات ستكون قد نسيت من الجميع، ولن تعود راسخة في ذاكرة أحد“.
ويواصل قائلا: “لكنني مازلت أتعاطى مع بيروت، أنا المولود فيها وقد عشت حياتي كلها فيها، كأنني زائر غير مقيم، وإلى ذلك كانت بيروت ذات قابلية على التجدّد الذي لم تكن تحظى بها مدن أخرى في البلدان العربية، لا ثبات لا استقرار لا بقاء للأشياء على حالها ثم إنها كانت قد سبقتنا أصلا، أقصد أننا منذ بداية وعينا بها، وكأنها قد حققت خطوات وما علينا إلا أن نحاول اللحاق بها.
بعد الحرب تغير ذلك وإن كنا بقينا مركزين النظر على كل جديد يمكن أن يحدث في مناخ الخراب ذاك، كأن يفتتح مثلا مطعم بهوية أميركية جديدة أو أن تعاد الأرصفة إلى بعض شوارع بيروت، أو إلى تشكل منطقة مثل ’’المونو’’ بمثابة واحة وسط المدينة الخربة. هذه كنا نتابعها ونحسب لها حسابا عظيما رغم أنها في غالب الأحيان تجارب يجريها مغامرون لا يلبثون أن يدركوا أنهم أضاعوا من أجلها كثيرا من الوقت والمال“.
وعن “لا طريق إلى الجنة”، وما فيها من الذوقية و”البراءة”، ما يمكن الاكتفاء بها لمن يرغب. أما المتشوّق إلى استجلاء “اسم الوردة” والخوض في وجوه معانيها، فهو سينقاد إلى قراءة ثانية هي حتما مقاربة بحثية ونقدية لطريقة عمل الكاتب، وهنا يطرح تساؤلين: أولهما عن الناقد المكمل للقراءة وضرورة وجوده. وثانيهما عن إباحة التجريب على صعيد الروائي خاصة، والكتابي بشكل عام وشرعية تبني كل أشكاله؟
بحذر يحاول الإجابة: أنا أخاف أن يسيء الناقد القراءة فيمسي الكتاب على يديه حاملا أخطاءه وسوء معرفته. هذا مع أنني أعرف أن قراءة عادية “لكتاب من كتبي لا تعطي ما فيه”. ذاك أني مازلت متأثرا بالشعر، أقصد بأن تكون الكتابة أبعد قليلا من سطرها النثري.
كثيرون من الأصدقاء يقولون لي إنهم استمتعوا بالقراءة الثانية للكتب أكثر من استمتاعهم بالقراءة الأولى، وأنا أعرف أن ذلك قد يكون صحيحا، ذاك لأني أضع القارئ في التباس. فأن أقول له هذه رواية، أكون أقترح عليه أن يقرأها كما تقرأ الروايات، أي قراءة سريعة متابعة للحدث وملاحقة لما سيجري من بعده. أما أن يجد نفسه قارئا له فيكون أمام لغة تتطلب التأني والتفكر والعثور على المتعة في عملية القراءة نفسها.
لامعنى كثيرا للمصير الذي آلت إليه حياة بطل “لاطريق إلى الجنة” إن لم تدخلنا تفاصيل حياته الدقيقة في تكوين قاع نفسيّ وشخصيّ له. القراءة الثانية ممكن أن يستعاض عنها بقراءة أولى متأنية، ومستسلمة لما تأخذنا الكلمات إليه. ولا أجدني مخترعا طريقة في الكتابة حين أكتب بتلك اللغة الملتبسة بين الوضوح والغموض. فقط في لجنات التحكيم العربية للرواية، لا إدراك لهذا النوع من الروايات.
وعن “بناية ماتيلد” ولدت في الحرب، و”مائة وثمانون غروبا” لم تكتب الحرب مباشرة، بل أرّخت تأثيراتها الجانبية وتصدّعاتها النفسية على حياة أبطالها وشخصياتها. وكأنك لاتريد أن تخوض في فعل الحرب، بل العيش في الحرب، فكيف أثرت الحرب فيك وفي كتابتك؟
يجيب: لقد كتبت عن الحرب متناولا إياها من مواضع مختلفة. في “بناية ماتيلد” أنهيت بالحرب زمن تلك البناية وفي “غناء البطريق” جعلت الناس ينتظرون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من دون بارقة في الأفق في “مكياج خفيف هذه الليلة” تابعت الحرب مرسومة على وجه وجسد تلك المرأة التي شوهتها القذيفة وفي “مائة وثمانون غروبا” تعقبت الهاربين منها إلى ملذاتهم، معاينا كيف يبدؤون حربهم هم أيضا وهم هناك، منذ أربعين سنة يعيش أحدنا متنقلا بين أمكنة الحرب وأزمنتها متنقلا بين أنحائها متلهفا لملاحظة ما تأتي به من جديد وما تدفع به إلى الخراب.
وقع ذلك وتأثيره هما ما يدفعنا إلى رؤية الحرب كلٌ من زاويته الخاصة وتجربته الخاصة. أذكر أننا في الثمانينات والتسعينات كان يسأل الروائي اللبناني أن يكتب عن الحرب وكأنه يؤرخ لها، يعني أن يصف تتابع أحداثها ومعاركها إلخ.. فيما الرواية هي غير ذلك تماما.
يطول الحديث والكلام مع راوي المدينة والحرب والسلم،وتبقى الصور نابضة بألوانها الخاصة التي تخص الروائي وحده دون سواه.