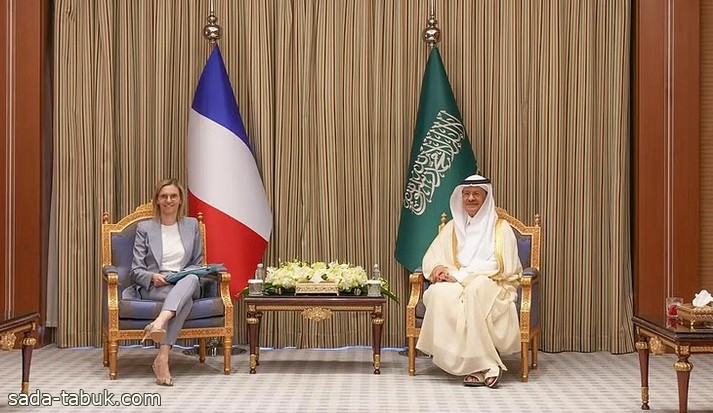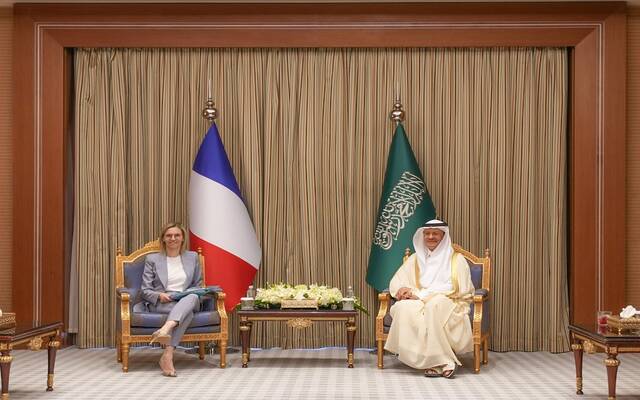قرأتُ بتمعنٍ شديد وبعمق المقال المنشور في صحيفة الجارديان البريطانية في 21 أغسطس من العام الجاري تحت عنوان: «التوجه نحو المخلفات الإلكترونية: فشل عمليات التدوير في أستراليا وتحديات الطاقة الشمسية». هذا المقال أرجعني إلى الوراء إلى ما قبل أكثر من قرنين من الزمان بعد أن بدأ الإنسان الثورة الصناعية الأولى، فحلَّت الآلات والأجهزة مكان الجهد الذي كان يقوم به الإنسان، أي استبدال عضلات الإنسان وقوته البدنية بالمكينة والآلة، وقريباً في الزمن المنظور سيُستبدل الإنسان بالروبوتات، أو الإنسان الآلي.
ومع كل هذه التطورات العلمية والتقنية المبهرة والمتسارعة منذ أكثر من مائتي عام، ومع كل هذه العمليات التنموية والمكاسب العظيمة التي حققها الإنسان في جميع المجالات وكافة القطاعات، ومع النضوج الفكري للبشر عامة طوال هذه السنوات الطويلة، مازالت نظرته قاصرة، وفكره مازال محدوداً، فأنشطته الإنتاجية غير المسبوقة في التاريخ كانت ومازالت تهدف إلى تحقيق هدفٍ رئيس واحد فقط، هو الربح الوفير والسريع، فكانت التنمية تسير بعجلةٍ كبيرة وبعينٍ واحدة ثاقبة ترى خطاً واحداً فقط، وتركز على مسارٍ واحد لا ثاني له، وتسمع بأذن واحدة كذلك ومن جانب واحد فقط.. لذلك تجاهلت هذه التنمية البشرية كل الإفرازات التي تتمخض عنها، ومازالت على هذه الحالة بالرغم من هذه الخبرات الطويلة التي اكتسبها عبر القرون، والكوارث التي عانى منها وسقط فيها، ونسيت، أو تناست ما ينتج عن هذه الأنشطة التنموية من مخلفات غازية، وسائلة، وصلبة. ففي كل مرة يُقدم منتجاً جديداً للبشرية، يفاجأ بعد سنوات بملايين الأطنان من المخلفات التي نجمت عن العملية الصناعية لهذه المنتجات والمواد الاستهلاكية، أو المخلفات التي تنتج بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج وعند تخلص الإنسان منه.
وهذا المقال الذي قرأتُه في الجارديان أكد لي هذه الحقيقة التي أراها أمامي منذ عقود، وفي كل مرة تزداد قناعتي بمصداقيتها.. فعلى سبيل المثال، يسعى الإنسان جاهداً منذ زمن إلى التخلص من مصادر الطاقة الملوثة للبيئة والمفسدة لصحة الإنسان والتي عادة ما تكون ناضبة وغير متجددة، مثل الوقود الأحفوري، كالفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، ويعمل بكل ما أوتي من قوة عقلية على استبدال هذه المصادر بأخرى صديقة للبيئة ونظيفة لا تنبعث منها السموم ولا تنجم عنها المخلفات الصلبة وغير الصلبة، إضافة إلى أنها تكون متجددة وقادرة دائماً على العطاء.. ولكن الإنسان كعادته في بحثه عن البديل المستدام والسليم والآمن لصحة الإنسان، مثل الطاقة الشمسية، لم يفكر بالمخلفات التي تنجم عن استخدام هذه الطاقة من ألواح شمسية بعد الاستعمال، وبعد أن تفقد صلاحيتها وقدرتها على العطاء بعد مرور نحو عشرين عاماً، فتتحول بعد ذلك إلى مخلفات يجب التعامل معها، وإدارتها بطريقة سليمة بيئياً وصحياً. فها هو الآن، كما ورد في المقال، عقل الإنسان يقف حائراً ومرتبكاً أمام هذه الملايين من الأطنان من المخلفات التي تتراكم أمام عينيه كالجبال الشامخة، فلا يعرف كيف يتعامل معها، وكأنها انكشفت أمامه وظهرت فجأة وبدون سابق إنذار.
ففي أستراليا، على سبيل المثال، هناك قرابة مائة ألف طن من الألواح الشمسية المستهلكة التي ستفرض نفسها على الإنسان بحلول عام 2035، بحسب التقرير المنشور من حكومة ولاية فكتوريا الأسترالية في السابع من أبريل تحت عنوان: «المدخل القومي لإدارة الألواح الشمسية». وما يحدث في أستراليا ينطبق بشكلٍ كلي على باقي دول العالم التي تتجه نحو استخدام الطاقة الشمسية، والتي ستجد نفسها أمام هذه المعضلة، وخاصة أن مخلفات الطاقة الشمسية تدخل ضمن المخلفات الإلكترونية، وتُصنَّف كمخلفات خطرة تحتوي على عناصر ثقيلة سامة كالرصاص، ما يعني إدارتها بأسلوب خاص وحذر يختلف عن إدارة المخلفات غير الخطرة.
ومثال آخر أستطيع أن أضربه لكم ويتمثل في سيارات المستقبل القادمة لا محالة، وبالتحديد السيارات الكهربائية. فالإنسان من أجل علاج مشكلة تلوث الهواء الجوي الناجم عن سيارات الجازولين والديزل والتي لها تداعيات بيئية وصحية عصيبة على المجتمعات البشرية، وبخاصة دورها المباشر والشديد في وقوع مشكلة وقضية القرن، وهي التغير المناخي، يحاول منذ زمن إيجاد البدائل المجدية بيئياً وصحياً واقتصادياً لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومكافحة سخونة الأرض وارتفاع حرارتها، ومن بين هذه المحاولات التي خطت خطوات عملية جادة في كل دول العالم، وتبنت الحكومات ومنتجو السيارات هذا البديل، السيارات الكهربائية.
فحكومات الدول الصناعية المتقدمة المنتجة للسيارات اتخذت قراراً سياسياً استراتيجياً يتمثل في التخلص من السيارات التي تشتغل بالوقود الأحفوري، مثل الجازولين، والديزل، والغاز الطبيعي، وحثت الشركات المنتجة للسيارات على الاستثمار في هذا القطاع الجديد المتمثل في السيارات الكهربائية بعد أن وفرت لها الغطاء السياسي والتشريعي، واليوم كل شركات العالم المصنعة للسيارات خصصت المليارات من الدولارات لإنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية والتخلص تدريجياً من السيارات الأخرى.
وهنا أيضاً سيُوقع الإنسان نفسه في ورطة كبيرة إذا لم يأخذ في الاعتبار من الآن في مرحلة التصميم والإنتاج ويخطط لكيفية التعامل مع مخلفات السيارات الكهربائية، في مقدمتها البطاريات التي ستكون بمثابة القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في وجه الإنسان إذا تجاهلها وغضّ الطرف عنها وجعلها تزيد وتتراكم يوماً بعد يوم.
فالتقديرات المنشورة في مجلة «الطبيعة» المعروفة في 17 أغسطس 2021 في المقال تحت عنوان: «السيارات الكهربائية والبطاريات: كيف سينتج العالم بما فيه الكفاية؟»، تفيد بأنه بحلول عام 2030 ستصل أعداد السيارات الكهربائية إلى قرابة 145 مليونا، أي ستكون هناك مئات الملايين من البطاريات القديمة والمستهلكة التي يجب التعامل معها بطريقة علمية مستدامة، فبعض مكونات هذه البطاريات الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، وهذه ملوثات سامة وخطرة تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة حتى لا تدمر صحتنا وتفسد سلامة مكونات بيئتنا، فيكون عندئذٍ الضرر من السيارات الكهربائية أكبر من الفائدة التي نجنيها منها.
هذه الأمثلة التي نواجهها اليوم، ونعاني منها منذ قرون، يجب أن تكون فرصة للإنسان ليصحح مفاهيمه الخاطئة، ويعدل من اعوجاج فكره تجاه بيئته فيضع البيئة في مقدمة اهتماماته وعنايته، وبالتحديد في مجالين، الأول منع أو خفض الانبعاثات من أية عملية تنموية يقوم بها، والثاني التفكير في كيفية إدارة المخلفات التي قد تنجم عن هذه العمليات حتى لا يصطدم بوجودها في وجهه.
bncftpw@batelco.com.bh