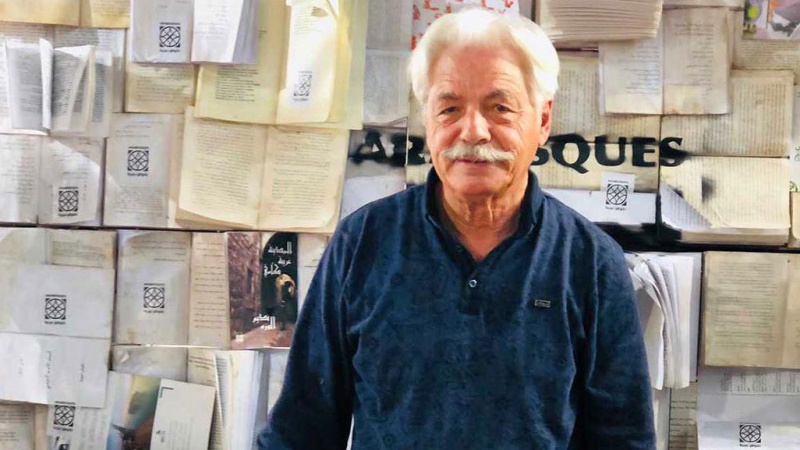تنتهي من رواية «أن تقرأ لوليتا في طهران» للأكاديمية آذر نفيسي، فتزداد يقيناً بخطورة إقحام الدين في السياسة، لأن الدين في حقيقته «مجال خاص» بين العبد وربه، فإذا تم «تديين السياسة» فكأنما نريد خلط «ماء زمزم» بزيت المطبخ السياسي، لنكتشف متأخرين أن شرب «ماء زمزم» عائد لمسائل تعبديه ذاتية، لا يمكن إخضاعها لشروط «هيئة الغذاء والدواء»، بقدر خضوعها لشروط حمايتها من آثار التلوث بمياه السيول السياسية ومجاريها الاستخباراتية تحت الأرض.
«أن تقرأ لوليتا في طهران» مزيج من معارف أكاديمية في الأدب الغربي ومقاربة شخوصها بالواقع الإيراني، مع تجارب حياتيه في «إيران الخميني»، وتغير الحياة معه إلى شعارات دينية وسجون سرية ومشانق علنية، ثم حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، وصولاً إلى وفاة الخميني في الثالث من حزيران عام 1989، الذي لم يمت كما ترى ذلك الطفلة الصغيرة لصاحبة الرواية إذ تقول آذر نفيسي عن يوم وفاته:
كان طفلي ممدداً في حضني بتلك الطريقة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، كان شعوره بالراحة قد منحني إحساساً بالهدوء والسكينة، فراحت يدي تداعبه دون وعي مني وتمسد حلقات شعره الناعم، ومن حين لآخر تلامس نعومة جلده، كنا، نحن الكبار، نحكي ونتبادل التحليلات ـــ في وفاة الخميني ــــ وكانت ابنتي ذات الخمس سنوات تنظر من النافذة لحاجة في نفسها، حينما التفتت فجأة وصاحت: «ماما.. ماما.. لم يمت.. انظري.. ما زالت النساء ترتدي الإشاربات!»، بقيت أربط بين وفاة الخميني وبين تصريح ابنتي التلقائي: فقد كانت على حق، لأنه في اليوم الذي تكف فيه النساء عن ارتداء الإيشاربات في العلن، سيكون يوم وفاته الحقيقي، وستصل ثورته إلى نهايتها، وحتى ذلك الحين، سيبقى يعيش معنا.
رواية «أن تقرأ لوليتا في طهران» للأكاديمية آذر نفيسي، مزيج من محاضرات أكاديمية ثمينة في الأدب الروائي العالمي بصفتها أستاذة للأدب الإنجليزي، مزجتها بمذكراتها اليومية في بلد يعيش معاناته ما بين فوضى الثورة والحرب، ومن المفارقات أن مخرجات «التطرف الديني الإسلامي» على يد «آية الله العظمى الإمام الخميني»، لا تختلف كثيراً عن مخرجات «التطرف القومي البعثي» على يد «زعيم البعث العربي الأخ القائد الرفيق صدام حسين»، رغم أن النزعة الدينية باسم الإسلام أو المسيحية.. إلخ أو النزعة القومية باسم العرب أو الأكراد لا تعتبر إشكالاً سياسياً حقيقياً ما لم تتحول إلى حركة شمولية تريد القفز من نطاق الدولة كمنظمة للعلاقات «المدنية» وفق معطيات «المواطنة» إلى دولة تقتحم الفضاء الخاص للأفراد فتمسخهم إلى لون واحد ومقاس واحد بعقلية تستلهم بروكرست وسريره الحديدي.
فالزعيم السياسي الحكيم هو «ممثل» للشعب بتنوعاته، وليس «تجسيدا» للشعب، وبينهما شعرة تكاد تنقطع في معناها رغم الفرق الكبير في مؤداها، فمن يمثل شعبه سيحتاج أن يتلمس مصالحهم باختلاف أطيافهم بين الحين والآخر، والعقل الحديث وحده من يستطيع ذلك، بينما من «يجسد» شعبه في شخصه لا يحتاج سوى أن يتلمس مصالحه الخاصة بين الحين والآخر والعقل القروسطي وحده من لا يستطيع سوى ذلك ولا يفهم سوى ذلك. ولهذا كان الخميني وصدام تجسيداً للقرون الوسطى في أن كل واحد منهما بشحمه ولحمه وغرائزه يرى أنه إيران والعراق بكل ما في هذين البلدين من عراقة وحضارة وتنوع وتاريخ، ولهذا من الطبيعي أن ينتج عن هذه الحرب مليون قتيل في سبيل الخميني وصدام، وقد ذهبا وبقيت إيران والعراق، مع تجاهل الوعي العربي في قراءة مستقبله وتحديد أولوياته لفضيحة «إيران كونترا» التي بموجبها «تبيع أمريكا على إيران ما يقارب ثلاثة آلاف صاروخ مضادة للدروع، وصواريخ هوك أرض جو مقابل إخلاء سبيل خمسة أمريكان محتجزين في لبنان! وكان نائب ريغان هو جورج بوش الأب في ذلك الوقت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني في لقاء باريس وبحضور مندوب المخابرات الإسرائيلية ليتم نقل الأسلحة من إسرائيل إلى إيران... إلخ».
انتهت رواية آذر نفيسي الإيرانية المهاجرة إلى أمريكا مع أملها الكبير في أن جيل الشباب الإيراني الآتي بعدها سيكونون أكثر نجاحاً في التخلص من عمامة الملالي ليصبحوا دولة أكثر مدنية ومراعاة لحقوق الإنسان، ولأن الأنظمة أحياناً تشبه الأولاد المراهقين فهل لنا أن نعتبر ما حصل في العراق وإيران مما ينطبق عليه: «من لم يربه أبواه رباه الزمان»؛ ولأن تربية الزمان قاسية ودموية ولا رحمة فيها فقد حصل للعراق وإيران ما رآه جيل «آذر نفيسي» في إيران وجيل «كنعان مكية» في العراق.