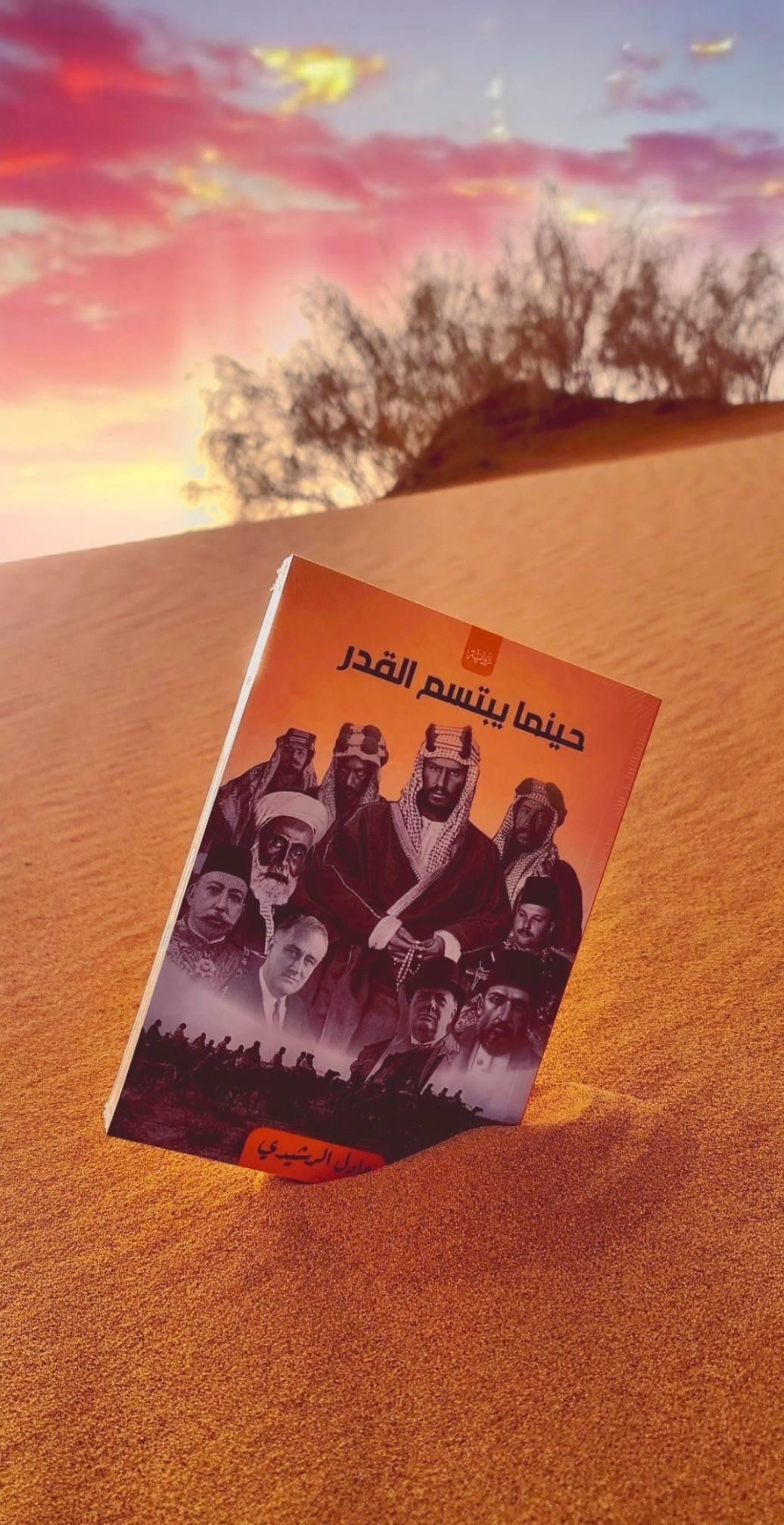الروائي الكويتي عادل الرشيدي هو أديب شاب لا يزال في ريعان الشباب، مارس كتابة السرد منذ فترة قصيرة -مقارنة بسنه- وبأسلوب متميز انفرد من خلاله عن مجايليه، قبل أن يكون مؤرخاً وقارئاً نهماً تستهويه كثيرا قراءة التاريخين العربي والإسلامي والتفكر والتأمل فيهما.
يتضح لنا ذلك بجلاء من خلال الرواية التاريخية الصادرة حديثاً للرشيدي، والتي تحمل عنوان «حينما يبتسم القدر» وهي رواية جعلت من الحدث التاريخي واستقرائه من جديد برؤية أدبية المحور الرئيسي الذي تدور حوله جميع فصول هذه الرواية التي يتجاوز عدد صفحاتها 300 صفحة من القطع الكبير.
وعلى الرغم من حداثة سن الكاتب -نسبياً كما أشرت إليه آنفا لدى مقارنته بعمر تجربته السردية التي لا تتجاوز عقداً من السنين أو ما يزيد عليها بقليل- إلا أن من يقرأ عمله هذا سيجد انه أمام (أرشيف تاريخي) ضخم، وغني جداً بإرث تاريخي وملحمي أصيل وعريق، تعبق صفحاته برائحة الحضارة الإنسانية العظيمة للعرب والمسلمين على مدى قرون طويلة من الزمن تأرجحت خلالها أوضاع الأمة بين القوة والضعف على مستويات عدة: دينية واجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية وثقافية وفكرية، وخاصة خلال مطلع عصر النهضة الحديث، وما تلاه من فترات زمنية لاحقة، كانت تمثل مراحل حرجة أشبه ما تكون بـ(الخروج من عنق الزجاجة) كما يقال، خصوصاً بالنسبة للبلدان العربية، ومنطقة (الشرق الأوسط) تحديداً، حتى ظهر لنا الكاتب هنا وكأنه أستاذ أكاديمي، متخصص في التاريخ، أو دراسات التاريخين العربي والاسلامي لسنين طويلة، وله من الخبرة والمعرفة فيهما ما يفوق المعرفة العادية لشاب حديث السن بأضعاف مضاعفة!.
وقد تمثلت هذه المعرفة -التي أظهرها لنا الكاتب خلال عمله السردي هذا- في رغبة الدول الأوربية الاستعمارية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا -آنذاك- في إقصاء العنصر (التركي) من المنطقة، وفرض هيمنتها وسيطرتها على مساحات شاسعة من (الوطن العربي) سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وفكرياً.
خلال هذه المرحلة الحرجة، وفي ظل الأوضاع المتأزمة من تاريخ العرب الحديث ظهرت شخصيات عربية وإسلامية على ساحــة الحدث السياسي الدولي، كان لها تأثير فاعل في لم شتات العرب والمسلمين، وجمع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، وعلى رأس هذه الشخصيات تأتي شخصية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- كشخصية سياسية عظيمة واستثنائية، تعتبر من أهم الشخصيات العربية والاسلامية في القرن العشرين على الإطلاق، إذ قام -رحمه الله تعالى- بتأسيس وتوحيد دولة إسلامية تستمد تشريعها وأنظمتها الداخلية والخارجية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وفعلاً تم له ما أراد بعون الله تعالى بعد ما أفنى -رحمه الله- عمره مجاهداً في سبيل الله، ومكافحاً كفاحاً مريراً من أجل بناء هذه الدولة، ومن أجل أن تبقى كلمة الله هي العليا، حيث كانت ثمرة هذا الكفاح ضم أجزاء كبيرة من (شبه الجزيرة العربية) تحت حكمه لتكون بلداً واحداً، وشعباً واحداً هو (المملكة العربية السعودية) دستورها القرآن والسنة.
وهنا أقر العدل والمساواة بين مواطنيها والمقيمين فيها في كل شيء، واستتب الأمن وأرسى قواعد الدولة الحديثة، ووضع على رأس اهتماماته في المقام الأول بعد استقرار الأمور مباشرة جميع ما يمكن أن يحتاجه المواطنون، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية كالتعليم والصحة والمواصلات... الخ.
كثير من هذه الجوانب احتوتها رواية (حينما يبتسم القدر)، ليس بقلم الباحث أو المؤرخ أو العالم بالتاريخ فحسب، وإنما برؤية أدبية تقرأ التاريخ بروح فنية إنسانية، وكأنها تستنطقه من جديد لتخرجه من صرامة الكلمة العلمية وجديتها الحادة، وحقيقتها المجردة إلى حيث فضاء اللغة الأرحب والأسمى، وحيويته المرتبطة ارتباطاً حسياً ومعنوياً بالإنسان، والارتقاء بمستوى اللغة عن أن تكون مجرد أداة من أدوات التخاطب البشري المعتاد بين الإنسان ومحيطه لتكون عاملاً فاعلاً قادراً على اختراق (المستوى المثالي) لهذه اللغة أو تلك كما وصفه عالم اللسانيات السويسري الشهير (سوسير) أحد أكبر نقاد ومنظري (المدرسة الأسلوبية) في الأدب العالمي في العصر الحديث.
(حينما يبتسم القدر) ليس رواية عادية نلقيها جانباً لدى فراغنا من قراءتها،A وكأن علاقتنا بها علاقة محددة بزمان ومكان معينين، مثل كثير من الروايات التي قرأناها وانصرفنا عنها ونسيناها أو تناسيناها، بل إنها تاريخنا الذي نحرص على اقتنائه وتذكره بشكل دائم، وتراثنا وهويتنا التي لا يمكن أن ننفصل عنها بأي حال من الأحوال، وسنبقى على ارتباط وثيق بها مهما كانت الظروف ومتغيراتها.
وتكمن القيمة التاريخية لهذا العمل في كونه رصداً دقيقاً للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي مرت بها منطقة (الخليج العربي) خلال القرن الماضي تحديداً وعلى رأسها (دولة الكويت) و(المملكة العربية السعودية) حيث ركز الكاتب -بشكل واضح- على أهم المراحل التي مرت بها نشأة الدولتين الحديثتين للأسرتين الكريمتين الحاكمتين آل (صباح) و(آل سعود) وتضافرهما سوياً، واتفاقهما على وحدة الهدف والمصير المشترك لإرساء دعائم الحكم في كل منهما، في زمن كان خلاله المناخ السياسي للعالم الحديث مضطرباً، والأوضاع الأمنية للمنطقة مختلة، والجهل والتخلف متفشيين بين السكان، إذ غابت أهمية الوعي بالمصلحة العامة للأمة لدى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، وكانت المصالح الخاصة والشخصية للأفراد والجماعات هي الظاهرة السائدة في ذلك الزمان؛ نظراً لكون النسبة العظمى من سكان المنطقة (شبه الجزيرة العربية) قائمة -في حينه- إما على (الإقليمية) أو (المناطقية) أو على وحدة (القبيلة) والولاء لها في كل شيء تقريباً، إذ لم يكن الولاء للدولة، أو معنى كلمة (دولة) واضحاً ومفهوماً من حيث المدلول بالنسبة لهؤلاء آنذاك؛ بسبب انتشار الأمية والجهل والانحطاط الديني والثقافي والمعرفي بين الناس في تلك الحقب الزمنية، مما جعل نسبة كبيرة منهم يعتقدون أن قيام دولة ذات سيادة ونظام حكم مبني على قواعد وأسس تنظيمية لحياتهم أمر يُحجم سلطة القبيلة، ويحد منها، ويقلل من حرياتها فيما أرادته لنفسها من ممارساتها المعتمدة على فرض كل قبيلة من القبائل نفسها على غيرها بالقوة والاكراه، وممارساتها من غزو وسلب ونهب لبعضها في مجتمع قبلي يتصارع أفراده فيما بينهم ودون هوادة، للإمساك بزمام السلطة والقوة والنفوذ في المنطقة، وكأنهم يتسابقون جميعا لتحقيق مقولة (البقاء للأقوى)!!
الرواية: البناء الفني
اعتمد الكاتب في روايته هذه على فنيات البناء القصصي وعناصره المعروفة من سرد وتحليل وصفي ونفسي للحدث وشخصياته وزمانها ومكانها، ومن حوار متنوع بين (الحوار الداخلي) أو المونولوج و(الحوار الخارجي) الذي يشترك في تبادله شخصيات متعددة، وهو ما يعرف بـ(الديالوج)، حتى انه وظف تقنيات (سينمائية) أخرى مثل (السيناريو) والمؤثرات الصورية (المتخيلة) أو الحركية، أو عرض بعض الأحداث التاريخية على شكل مشاهد يرافقها شرح تفصيلي يحيل النص المكتوب أو المقروء إلى ما يشبه الفعل الحركي التمثيلي المحسوس، وكأنه يجري على خشبة (مسرح) ما، وعلى مرأى ومسمع من المشاهدين ( النظارة).
وقد أجاد الكاتب توظيف هذا الجانب الفني في عمله بالشكل الصحيح والمناسب حتى غلب الطابع الأدبي والفني على الطابع العلمي التاريخي في الرواية ككل، وكأننا نقرأ (أدباً مؤرخاً) وليس تاريخاً (علمياً صرفاً) فحسب.
وهنا تظهر مهارة الكاتب الفائقة في (فلسفة الحدث التاريخي) التي لا تغير من (جوهر الحدث) أو حقيقته بقدر ما تحاول -دائماً- استيحاءه، وإعادة قراءته مجدداً. ويظهر من المراجع الواردة في الصفحة الأخيرة من الرواية والتي استقى منها الكاتب معلوماته التاريخية حرصه الشديد على (وثائقية) عمله هذا، أي توثيق الأحداث التاريخية وتسلسلها زماناً ومكاناً بكل صدق وأمانة، منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي حتى منتصف القرن العشرين، غير انه أظهر عاطفته تجاه تلك الأحداث بحس أدبي وفني، وتصرف في التحليل النفسي والوصفي والأساليب الحوارية و(السيناريوية) وفق رؤيته الخاصة به كأديب، يتعامل مع عمل سردي قصصي، له فنياته الخاصة، وليس كمؤرخ فحسب.
ولولا هذه الفنيات لكان العمل مجرد عمل علمي، أو بحث تاريخي موضوعي مفرغ من الذاتية، يستند إلى أحداث وحقائق تاريخية ثابتة، لا مجال للتصرف فيها أدبياً أو فنياً، مثله في ذلك مثل غيره من مئات المؤلفات والبحوث والدراسات العلمية الجادة التي قدمها كثير من الباحثين والدارسين عن تلك الحقب الزمنية من تاريخ بلادنا.