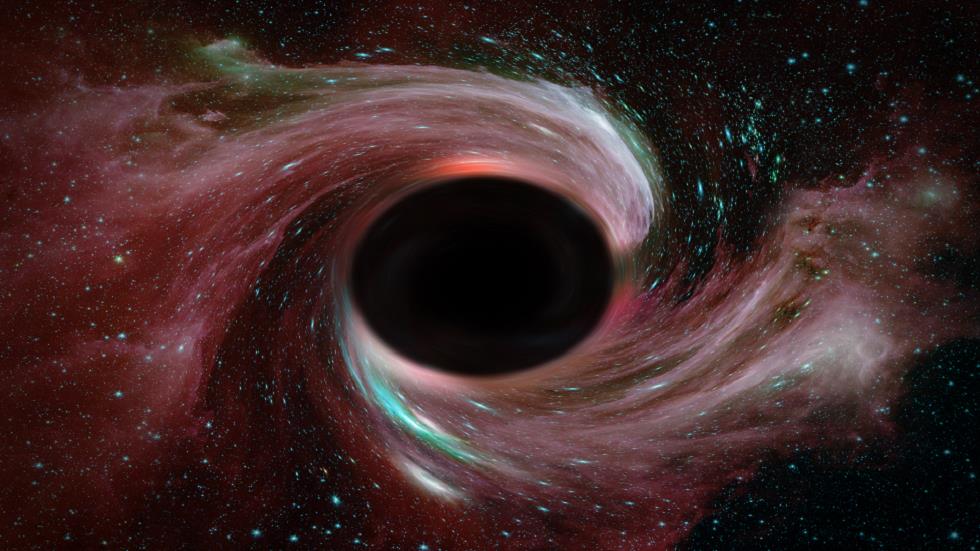على امتداد التاريخ الإنساني ظلت العلاقة بين الإنسان والوجود من حوله، علاقة مضطربة ومتنوعة وفق النمو الإنساني وتوسعه في طلب العلم وفهم الحياة، فالإنسان الأول كان أكثر خوفاً وانكفاءً لضعفه وشراسة الطبيعة من حوله، وكلما استطاع أن يخترع ما يحميه من سلاح ومساكن ويتغلب على قسوة الطبيعة بأمان المحراث وتوافر الطعام، كان أكثر قدرة على مزيد من الشجاعة في الريادة والسيادة على ما حوله.
هذه العلاقة بين الإنسان والوجود تنامت وفق محطات عديدة مرت عليها أجيال من البشر في فترات مديدة، لكن أهم محطة وأكثرها انعطافاً في خط النمو الإنساني كانت لحظة انتماء الإنسان للدين، هذه اللحظة العقدية أملت على الإنسان تعليماتها الصارمة ودفعته نحو توجهات جديدة وأظهرت له علاقته بالأشياء من حوله، فمن خلال نظرة عامة للأديان القديمة، يظهر اهتمامها الكبير بالعالم الداخلي أكثر من اهتمامها بالعالم الخارجي، وبحاجات الروح أكثر من حاجات الجسد، فتعاليم البوذية والهندوسية ثم المسيحية تؤكد ضرورة البقاء في عالم الداخل المنكفئ على الإنسان، باعتبار أن الخارج المادي هو ميدان الشياطين ورغبات الجسد وفساد الأخلاق (انظر: الإسلام بين الشرق والغرب للأستاذ علي عزت بيغوفيتش، ترجمة محمد يوسف عدس، دار الشروق، الطبعة الأولى 1994م ص 292-297).
يؤكد هذه النظرة عالم الفلك الأميركي كارل ساغان، عندما قال: «إن هذا العدد الكبير من العوالم، والحجم الهائل للكون، لم يؤخذ برأيي في الاعتبار، حتى ولو بشكل سطحي، من أي دين بخاصة الديانات الغربية» (انظر: كتاب الكون لكارل ساغان، ترجمة نافع أيوب، عالم المعرفة، طبعة 1993م، ص 266).
وصدق الحق تعالى: «لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [فصلت 57]،
أما اليهودية فتؤمن بأن الكون مسخر للإنسان اليهودي، وأن مملكة الرب في الأرض ستظهر مع بناء الهيكل ولا يعتبر العمل الدنيوي منافياً للمعتقد اليهودي، بينما المسيحية كانت أكثر تطرفاً في اعتبار الإنسان خطيئةً يتحملها معه، منذ أكل آدم التفاحة عن الشجرة وحتى نزوله للأرض، ثم عودة المسيح عليه السلام آخر الزمان، ولا تعير اهتماماً بالكون، بقدر ما تهذب الفرد بالأخلاق والرهبنة، وبعيداً من نقد هذه المعتقدات وانحرافاتها الواقعية وتطوراتها المعاصرة، خصوصاً المسيحية بعد عصر النهضة والإصلاح الديني على يد مارتن لوثر وكالفن، جمع الإسلام بين تلك الديانات كلها في متطلبات الروح والجسد، وعمل الدنيا والآخرة، وغائية العبادة والعمارة، وجاء هذا التوازن الدقيق العظيم في آيات قرآنية واضحة المعنى والدلالة، بخلاف القراءات التراثية التي جانب بعضها الصواب انحرافاً نحو الغلو الصوفي أو الغلو السلفي في تهميش هذه الموازنات في الحياة.
يقول بيغوفيتش: «وهكذا تبلورت أكبر حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان وفي تاريخ العقل الإنساني بصفة عامة، تميزت بظهور دين العَالَمين (عالم الروح وعالم المادة)، أو ظهور النظام الذي يحتضن الحياة الإنسانية بكل جوانبها» (الإسلام بين الشرق والغرب ص 279.)
وبناءً على هذا التأسيس الإسلامي للحياة ظهرت الحضارة الأولى للمسلمين جامعة بين تلك الثنائيات الوجودية في إنسان واحد ومجتمع واحد، ومع ضعف العلماء في الاستمرار على هذا النهج، وإقبال المجتمع نحو الطرقية والتقليد المذهبي، وتسلط الاستبداد وعودة الكهنوت وتحالفهما معاً، كل ذلك وغيره أسهم في اختفاء هذا المعلم البارز في حضارة المسلمين.
وفي عصرنا الحاضر ارتسمت صورة جديدة في علاقة المجتمعات وأصحاب الديانات بالكون ومدى قدرتهم على تسخير ما فيه للإنسان، وما تغيرت هذه الرؤية إلا بعد جدل طويل وثورات حقيقية ومعنوية تجاوزت صور الاستبداد والكهنوت المكبِّل للحياة والإنسان، ويمكن وصف أغلب الفلسفات بعد القرن السادس عشر واعتبرت في أوروبا أنها بداية لعصر التنوير؛ كانت لأجل المواءمة بين الإنسان وعلاقته الوجودية بالكون والحياة.
يعلق على هذا الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر بأن عبارة: «رؤية العالم» تمثل استعمالاً فلسفياً حديثاً لا نجد انشغالاً مماثلاً له عبر مسار تشكل الحضارة الغربية، لا من جهة مقولات الفكر ومبادئه، ولا من جهة مظاهر الممارسة الاجتماعية هواجسها... ويعتبر عصرنا بوجه خاص عصر العلم الذي أصبح يشكّل مقام الرؤية الشمولية للعالم» (انظر: كتاب الفلسفة الألمانية والفتوحات النقدية، بحث الدكتور محي الدين قليع، دار جداول، الطبعة الأولى 2012م، ص 39). ففي هذا العصر التنويري وما بعده دُمجت العلوم الطبيعية ومكتشفاتها الحديثة في كافة التصورات حول الكون والحياة، وأصبحت أقرب للتناول المادي الذي أثمر النهضة الحديثة بكل صورها في الاستغلال الإنساني للكون.
ولنأخذ على ذلك أمثلة نحاول فيها معرفة رؤية تلك المقاربات الفلسفية لنظرية العلاقة الكونية بالإنسان ومقارنتها بما تقرر لدى المسلمين تجاه الكون وواجباته، من خلال سؤال الكون وحضوره في الفلسفات الأوروبية المعاصرة.
بدأت الكتابات الأوروبية الفلسفية خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الطبيعي من خلال البحث أولاً عن المنهج، فالكم الزاخر من كتابات فلاسفة الإغريق والعصر الوسيط، يفتقد للدقة العلمية، إذ تداخل اللاهوت بالعلم بثقافة العصر وإملاءاته، فوقعت أخطاء استمرت لقرون حتى تم التمييز بين السحر والكيمياء، والتنجيم وعلم الفلك، والخرافة والعلم.
وبما أننا أمام قدر هائل من النظريات والأفكار والمراجعات الفلسفية والعلمية، فليكن التعليق على ذلك من خلال تلك المنهجيات الأوروبية التي تطورت في فهم الكون ودراسة ظواهره، على النحو التالي التالية:
1- منذ أكثر من ألفي عام قبل ميلاد السيد المسيح وحتى اليوم، والأبحاث والنظريات تتوالى على فهم هذا الكون ومحاولة معرفته، وكل ما أمكن للبشر أن يقوموا به لأجل فهم الكون؛ مارسوه بدءاً من علوم الخرافة والتنجيم حتى شيوع منهج الملاحظة والتتبع والتجريب. لقد فَتَن الكون كل الذين حاولوا فهمه، فتنهم بالروعة والجمال وإدمان الاكتشاف، حتى تعرّض الكثير من العلماء للموت حرقاً لأجل هذا الافتتان المدهش متحملين هذا المصير ومندفعين نحوه من دون هوادة، وكل عالم ساهم في هذا الكشف الباهر للكون، كان يحني ظهره بتواضع ليرتقي آخر ويكمل الصعود والبناء على جهد من سبقه، ومع هذا السباق المحموم من التتابع لكشف ألغاز الكون، كان هناك الكثير من المطارحات والمناقشات اللاهبة بين أولئك العلماء لتأكيد مصداقية البحث الذي توصلوا إليه في تساؤلات فتحت الباب لتساؤلات أكبر وأعمق، يمكن أن نجملها في ثلاثة موضوعات كبرى: نشأة الكون، مصير الكون، خالق الكون.
هذه الأسئلة وغيرها من تساؤلات صغرى وكبرى حول التأثير المتبادل لأجرام الكون، ودور الإنسان في هذا التأثير، ومدى وجود عوالم مشابهة لما في الأرض، أثمرت الكثير من المكتشفات، وأسفرت عن جهود جبارة من علماء أجيال متتابعة حتى اليوم، والعلم الحديث رائد هذه المسيرة، لأنه الأدق والأصدق والأكثر عقلانية.
في المقابل، نجد كل آيات القرآن حول الكون وقبل أربعة عشر قرناً، كانت تشير لطلب رئيس أن نستعمل العقل لفهم المغزى من هذا الخلق والتسخير، ومن تلك الآيات على سبيل المثل قوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [النحل 12].
فالميدان الحقيقي لإدراك حقيقة التسخير وتفسير ظواهر الكون، هو من خلال العقل الذي يسمع ويبصر، فالله تعالى قال: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) [البقرة 171]، دليلاً على أن تلك الحواس الرئيسة في الإنسان هي مجال التعقل المطلوب لفهم الكون والإنسان، وإذا عطّلها عن الاستعمال العقلي فهي أدوات تنظر بلا بصيرة وتسمع بلا تعقل، فيصبح الإنسان وفق هذا الانفصال كالأصم والأعمى.
2- وقفت الأساطير الدينية والعرفية عقبة أمام التقدم العلمي لفهم ظواهر الكون وتفسيرها بلغة يفهمها العاقل بفطرته الأصلية، وحاولت ممارسة أشد أنواع العقوبة لمن يخالف التفسير الكهنوتي كما عند المسيحية تجاه بعض القضايا الكونية، كبدء الخلق أو كروية الأرض، ومع أنها سببت تعطيلاً للبحث في أوروبا لزمن طويل، كان العالم الإسلامي في المقابل يبحث وينتج الجديد من النظريات العلمية الدقيقة في مسائل الكون المتنوعة مستفيداً من كل المعطيات التي حوله.
ويمكن أن أضرب مثلاً بجهد فلسفي مهّد النظر العلمي للكون بطريقة لا تفسد الدين ولا تقمع الباحثين، وهذا المثال لن أفرضه من حضارة العرب التي لم تشهد جدليات هذا الفصل بين الدين والعلم؛ بل من القرون الوسطى في أوروبا، وهو ما قدمه باروخ سبينوزا (1632-1677م)، هذا الفيلسوف الأهم في عصر النهضة الأوروبية، الذي لم تعرف حقيقة قدره إلا بعد انقضاء حياته القصيرة التي امتدت لخمسة وأربعين عاماً، كانت الميزة الأبرز في هذا العالم الكبير تفوقه في الرياضيات والمنطق وقراءاته لمن سبقه من الفلاسفة والعلماء من كافة الديانات، ثم قدرته على تقديم نسق معرفي لا ينكر معطيات العلم الحديث ولا يتخلى عن إيمانه بالله، كما أن لجرأته وامتناعه عن التوقف من إبداء آرائه سبب آخر في محنته وعداوة رجال الدين اليهودي والمسيحي له، ما اضطره للعيش وحيداً ومريضاً وبعيداً من أعين الناس.
ومع كل ما كتبه سبينوزا في مجال القوانين الرياضية للطبيعة والنقد العقلاني للمرويات الدينية، فقد كان يوصف على حدِّ تعبير نوفاليس: «بالإنسان المفتون في الله» (تاريخ الفلسفة الحديثة لوليم رايت، دار التنوير، الطبعة الأولى، 2010م، ص 114). لقد قامت فلسفة سبينوزا على أهمية العقلنة وهندسة الوجود والاعتراف بالقوانين الطبيعية التي أقرتها البراهين العلمية، وأن هذا الكشف العلمي لا يناقض قدرة الرب الخالق ولا ينفي صفاته المطلقة على الطبيعة والكون، وعندما أنكر معجزات الكتاب المقدس كانت المسألة الجوهرية التي خرج بها سبينوزا أن الإله واحد، وأن الكون نسق فيزيائي ورياضي تام يقوم على قوانين مطردة، والله لا يصادم هذا العقل والقانون، فهو الجوهر الأزلي الذي لا يتغير والأساس الأقصى، وهو الماهية الظاهرية لكل شيءٍ عقليٍ وفيزيائي، بمعنى أن مدبر الكون لم يجعل الاعتقاد به سبباً في إنكار هذا الكون بكل قوانينه وبراهينه الواضحة (انظر: السياسة واللاهوت لباروخ سبينوزا، ترجمة حسن حنفي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، طبعة 1971م، وتاريخ الفلسفة الحديثة لوليم رايت 120-121).
يمكن جعل تجربة سبينوزا مثالاً على مواجهة الخرافات وعلى محاولة إثبات الحقيقة وفق طبيعتها البرهانية من دون اللجوء للمواجهة مع حقيقة الألوهية المطلقة للرب، وبالتالي تحقيق التناغم والاتساق بين الكون ومعتقد الإنسان، وما اتهم به من الإلحاد أو الحلولية مرجعه إلى سوء فهم لنظريته بالتكامل بين الله والطبيعة، فالطبيعة قائمة على قوانين محكمة كقوانين الهندسة وتمتد في كل الكون بفعل القوة الفاعلة وهو الله.
وتعتبر هذه الرؤية الفلسفية لسبينوزا الأقرب لفلسفة ديكارت السابق له، والأكثر إلهاماً لفلاسفة التنوير بعد ذلك فولتير وكانت وهيجل وغيرهم (انظر: العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة، تأليف د.أيوب أبو دية، دار الفاربي بيروت، الطبعة الأولى 2009م، ص 93-98).
وفي الختام... تبقى هذه الجدلية الباهرة بين الإنسان والكون مصدر إثراء للإيمان والمعرفة والعمران البشري، وأي اقتصار على واحدة منها جذبته الأخريات كلوازم لهذا الشغف الإنساني.