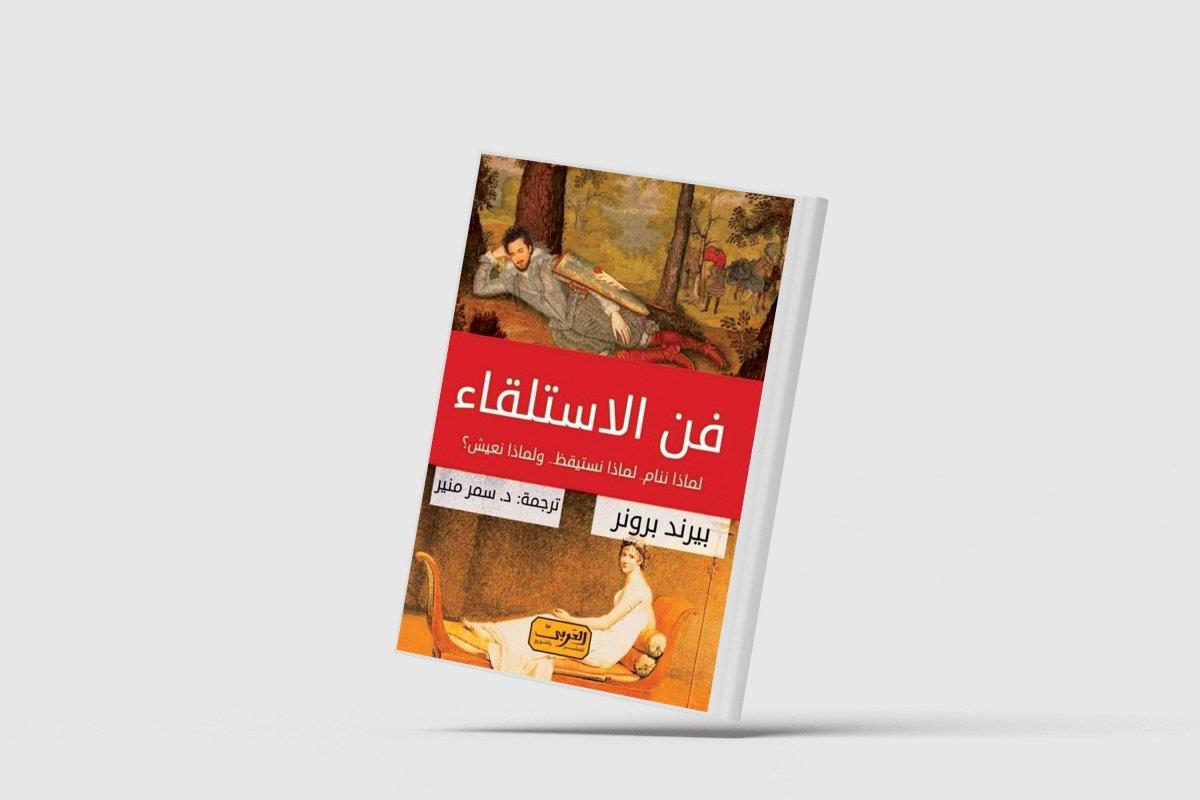فى مرحلة مبكرة من حياتى كنت لاعبا مهاريا متميزا فى لعبة كرة القدم، وفي مرحله تالية كنت مشجعا متحمسا لمباريات الدورى العام المصرى، ومباريات المنتخب الوطنى، خاصه في البطولات الأفريقية ذات الصبغة الدولية وتصفيات كأس العالم. بعد أحداث بورسعيد الدامية اتخذت قرارا شجاعا بالتوقف تماما عن التعاطي مع رياضة كرة القدم لعبا وتشجيعا. ومنذ ذلك التاريخ تحددت علاقتي بكرة القدم بصيغة تأملية تتناسب مع وقوفي علي مسافة من الأحداث والنتائج الرياضية التي منعت نفسي من الانخراط فيها. وقد اسفرت هذه العلاقة عن مجموعة من الخواطر التأملية التي اختلطت فيها الفلسفه بأقدام اللاعبين. وهي خواطر جمعت بعضها في عدة أوراق احتفظت بها في درج مكتبي، ونشرت بعضها الآخر علي صفحتي بالفيسبوك، وكان بعضها الثالث محورا للأحاديث العقلية الودية التى دارت بيني وبين بعض الأصدقاء. وهنا في هذا المقال أنتهز هذه الفرص كى أجمع هذه الأفكار والتأملات الفلسفية حول الكرة، والتي لا تخلو من دلالة ومن دعوة إلى التأمل والتفكير في أحوالنا الماضية والحاضرة، لنقف على الطريقة التي نفكر بها ونتصرف من خلالها فى أمور حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية. إنها محاوله للكشف عن بنية ذهنية مرت بالعديد من الثورات التحررية، وما زالت تؤدى بنفس الطريقة، وترى الأشياء من ذات المنظور.1- الفرحة كما تبدت فى وعى المصريينالفرحة الطاغية التى غمرت المصريين خلال الأيام القليلة الماضية بمناسبة صعود المنتخب الوطنى إلى نهائى كأس الأمم الافريقية المقامة بالجابون، كانت – مثل كل شىء فى حياتنا- مثارا للخلاف والجدل بين أبناء الوطن، كما كان لهذه الفرحة تجليات عديدة ومتنوعة على صفحات الفيس بوك. فالبعض عبر عن فرحته -كالمعتاد- بهيستيرية ودون أدنى تحفظ، فدخل فى غيبوبة الرقص والغناء والثرثرة، والبعض الآخر عبر عن فرحته بشىء من التعقل فأخذ يتحدث عن سوء الأداء، وهناك من عبر عن هذه الفرحة بشىء من التحفظ لافتا الانتباه إلى ألا تنسينا الفرحة الأحوال المتردية التى تمر بها البلاد والمعاناة التى يلقاها المصريون كل يوم، وكان هناك من امتنع عن التفاعل مع الحدث تماما حدادا على الأرواح التى ازهقت فى بورسعيد وكانوا ينظرون إلى الفصيل الفرحان بروح ناقدة متهمين إياه بانعدام الإحساس وغياب الوعى، بينما نظر هؤلاء الفرحانين إلى المنتقدين باعتبارهم عالم كئيبة “عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم”.وبالرغم من أن مظاهر الفرح والحزن لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنى أميل إلى تناول المسألة من زاوية فلسفية مفاهيمية تزعم لنفسها شيئا من الحياد والموضوعية.فلا يمكننا فهم معنى الفرحة إلا من خلال تحليل المفاهيم الأخرى التى تشترك معها فى المعنى من قبيل “اللذة” و”السعادة”. فالفرحة تقترب من معنى اللذة فى كونها شعور سار، لكنها تختلف عنها فى كونها شعور جماعى يغلب عليه الانفعال ويتم التعبير عنه بمظاهر خارجية صاخبة مثل التصفيق والغناء والرقص، فى حين تكون اللذة شعور فردى يغلب عليه الطابع الحسى، والمثال الأبرز هو اللذة الجنسية، والاثنان ينتميان إلى ذلك النوع من المشاعر والأحاسيس الوقتية العابرة.هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تختلف الفرحة عن السعادة فى أن السعادة شعور سار داخلى دائم وهادئ، فهو ليس فى قوة اللذة الجنسية ولا تصاحبه هيستيريا الفرحة المعبر عنها خارجيا. بل إن السعادة هى الغاية النهائية التى تسعى إليها كل أحاسيس اللذة ومشاعر الفرحة المضطربة. فكلما تحقق الانتظام لهذه المشاعر كلما كانت أقرب لشعور السعادة الهادئ والمستقر.ويلاحظ أن اللذة ترتبط بالرغبة والوجدان والعاطفة، وترتبط الفرحة بالمناسبات (سياسية أو اجتماعية أو رياضية)، فى حين ترتبط السعادة بالنجاحات المتحققة فى مجالات الفن والأدب والعلم بنحو أكثر. فقد فرح المصريون بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم فى البلاد، وبوصول المنتخب الوطنى إلى نهائى بطولة الأمم الافريقية، لكنهم سعدوا بحصول يوسف شاهين على جائزة مهرجان كان وفوز نجيب محفوظ وأحمد زويل بجائزة نوبل.2- المصريون والمقامرة بالمشاعركتبت فى منشور سابق عن الفرحة كما تبدت فى وعى المصريين بمناسبة وصول المنتخب الوطنى إلى المباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية، وتوصلت إلى أن شعور الفرحة يرتبط بالانفعال والصخب بعكس الشعور بالسعادة الهادىء والدائم.وربما لم يرق كلامى للكثيرين خاصة من عشاق الساحرة المستديرة، والذين يربطون الكرة -مثل أشياء كثيرة فى حياتنا- بالوطنية. فى الحقيقة إنما أردت بكلامى شيئا آخر أبعد من الكرة ومن السياسة. شىء متعلق بذلك الوعى الشقى الذى يأبى المصريون إلا أن يربطوا مصيرهم بمصيره.والمؤسف أننا كنا فى حاجة إلى الهزيمة حتى تتضح فكرتنا التى بدت كئيبة وثقيلة الظل فى لحظات الانتشاء بالفرحة.فالعبارات التى تصدرت المشهد فى الأيام الماضية من قبيل “خلى الناس تفرح” ، “الكورة هى اللى بتفرحنا” ، “الكورة هى اللى بتجمعنا” ، إنما كانت تعبر كلها عن الحاجة الملحة إلى الفرحة خاصة فى ظل الظروف الخانقة والمحزنة التى يحياها المواطن. وهذا مطلب مشروع، لكن السؤال .. لماذا نعلق آمالنا على ضربات الحظ ؟ لماذا نرهن مشاعرنا بالدخول فى مغامرة هى أقرب للمقامرة التى تحتمل المكسب والخسارة ؟فلا يخفى على أحد أننا نحيا فى زمن اصبحت فيه حياتنا كلها نوع من المغامرة غير المحسوبة. فلا أحد يستطيع أن يتكهن بما سوف تحمله اللحظة القادمة، إننا أسرى المجهول، وكل خطوة نخطوها إنما هى بمثابة قفزة فى الظلام. ينطبق ذلك على كافة المستويات، ولم يتبق لنا سوى مشاعرنا. فهى الحاجة الوحيدة التى مازلنا نملك القرار بشأنها، فلماذا نجازف بها فى مضمار اللعب، خاصة اذا كنا نلقى بالنرد على طاولة طالما خذلتنا ؟!3- الوعى الكروى وسحر الإيقاعبالصدفة عرفت أنه كانت هناك مباراة بين الأهلى والزمالك، وبالصدفة عرفت أن الزمالك فاز. لكن بالخبرة كنت عارف أننا سننسى سريعا خسارتنا فى الجابون، وأننا سنعود القهقرى إلى حرب الديوك بين مشجعى الأهلى ومشجعى الزمالك. وبالخبرة أتوقع أن مشجعى الزمالك فى منتهى السعادة وأن شعار “مدرسة اللعب والفن والهندسة” عاد للظهور ليحل محل شعاراتنا الوطنية التى كانت تملأ الشوارع منذ أيام قليلة. وأعرف كذلك أن جمهور الأهلى يعيش الآن فى مأتم وأن حزنه على ضياع السوبر يفوق حزنه على خسارة المنتخب بمراحل، وأنه الآن يبحث عن شماعة يعلق عليها فشله، وأنه يترصد لأى مباراة قادمة يلعبها الزمالك ضد أى فريق حتى لو كانت ودية ويخسرها حتى يرتاح نفسيا وينفذ انتقامه بسلاح الشماتة الفتاك. والحقيقة أن الزمالك “ما بيتوصاش” فما يلبث أن يحقق لمشجى الأهلى أحلامهم غير البريئة ويسقط صريعا أمام أول فريق ضعيف يقابله. ليس هذا فحسب، بل إننى أعرف أن مشجعى الزمالك، رغم كل ذلك، فى أول مواجهة أفريقية للنادى الأهلى سوف يرتدون الفانلة الحمراء ويرفعون الرايات الحمراء، تضامنا مع أشقائهم فى الوطن من مشجعى النادى الأهلى، لكنهم لن يلبثوا أن يلقوا بالرايات ويخلعوا الفانلات ويستبدلوا بها رايات الفريق غير الوطنى المنافس إذا ما خسر الأهلى. ونفس الشىء سيحدث من قبل جماهير الأهلى إذا ما خاض الزمالك مباراة أفريقية. وأعرف أيضا وبالخبرة الطويلة، أننا سنعود للاتحاد ورفع رايات الوطن فى تصفيات كأس العالم ، إلا أن هذا الاتحاد لن يستمر طويلا بعد الخيبات المتوقعة خاصة فى ظل ترتيبنا المتدنى علميا وكرويا على مستوى العالم. ولن يكون أمامنا سوى العودة القهقرية مرة أخرى للثنائية العقيمة: الأهلى والزمالك، وللدورى العام المصرى الضعيف تحت مقولة “إن الكورة عندنا ليها طعم خاص”.والسؤال الجوهرى الملح: لماذا هذا التأرجح السريع والعنيف بين الفوز والهزيمة، بين الداخل والخارج، بين الفرح والحزن، بين الكرة والحياة ؟!! الإجابة فى نظرى يمكن العثور عليها فى تحليل العقل والشعور للمصريين. فنحن شعب متقلب المزاج، تهيمن على تفكيرة البنية الإيقاعية، وهو بهذه المثابة يخضع فى تصرفاته لمنطق “المراجيح” الذى عبر عنه المطرب الشعبى أحمد عدوية “حبة فوق وحبة تحت” . إنه منطق عقيم لأنه يشبه الجرى فى المكان، حركة نشطة ودائمة دون أى تقدم. وهو نفس منطق اللذة الوقتية الناجمة عن الرعشة. والإيقاع هو أهم ما يميز الرقص الشرقى المفضل لدى المصريين، وهو أداء جسدى مجانى لا ينطوى على أى معنى سوى الإثارة، بخلاف رقص البالية أو الفنون الشعبية المعروفة ببنيتها الحكائية المميزة. وتتأكد أهمية الإيقاع من المكانة التى تحتلها “الطبلة” فى الثقافة الشعبية المصرية من بين الآلات الموسيقية جميعا، وهو ما عبر عنه كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس فى رائعته “الراقصة والطبال” التى تحولت إلى فيلم سينمائى ناجح. والإيقاع أيضا هو مايميز الحركة البندولية التى تستخدم فى التنويم المغناطيسى.وبهذا المعنى يمكننا أن نفهم إلى أى مدى يكون وعينا الكروى مخدرا. والمشكلة فى الحقيقة ليست فى وعينا الكروى، لأنه فى النهاية وعى مرتبط بلعبة ما أو برياضة معينة، لكن المشكلة أن هذا الوعى الاستثنائى أصبح هو الوعى الكلى العام الذى يتلقى حادثات العالم كله، ويتصدى لتقييمها والحكم عليها. إن شعبا يحيا بهذا الوعى، لهو شعب يغط فى نوم عميق، ولأنه نائم فلا يمكنه أن يسمع غطيطه، فقط المتيقظين هم الذين يزعجهم هذا الغطيط !!