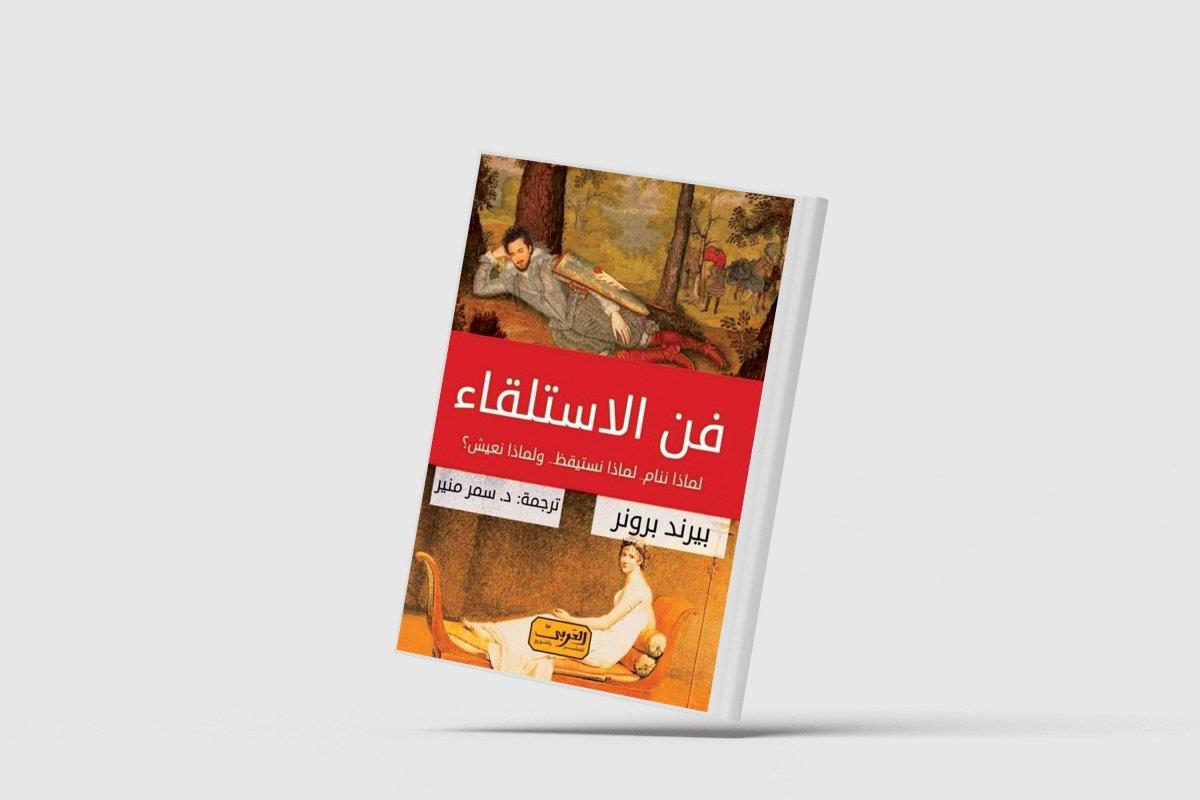لقد كشف وباء كورونا باكتساحه السّريع للعالم، عن الفردانيّة المنفلتة للإنسان الذي كان ولا يزال منتهباً بغواية أن يكون هو سرّ العالم. وها نحن نعيش اليوم تداعيات ذلك الوهم المميت، ونرقب راهننا المرعب حقّاً، ببالغ الذّهول والارتياع، طالما أنّ هذا الواقع الرّاهن بات منذراً بما هو أسوأ، وبما قد يتعذّر تداركه والسّيطرة عليه.
لقد وضعنا البروز المباغت لهذا الداء، وانتشاره الكاسح بيننا، وجهاً لوجه أمام تلك الحقيقة السّاطعة التي لا مفرّ منها، والتي غالباً ما نتغافل عنها.. حتميّة الموت. فيما كشفت لنا حالة الارتياع التي أحدثها، وخاصّة الإحساس بالخوف من عواقبه التي قد تكون كارثيّة، عن الطبيعة الهشّة لمجتمعاتنا.
ويكفي أن نحدّق بإمعان في تلك المجتمعات اليوم حتّى ندرك إلى أيّ مدى باتت مخذولة ومثبّتة في واقع رأسماليّ متّسم بالتوحّش، واقع يُنَمّي فيه الإنتاج والاستهلاك على نسق متسارع ومفرط، ويجعل المواطن العادي متعلّقاً إلى درجة الهوس بكلّ ما هو ماديّ، فيذهل بذلك عن حقيقة قدره وحتميّة تناهيه.
لقد بلغ هذا المواطن «المنتج-المستهلك» اليوم، درجة من الانغمار في رتابة اليوميّ، جعلته لا يقيم وزناً للموت، ولا يرى في حتميّته مسألة هامّة قد تستوقفه أو تحفزه على التّفكير. فليس من المستغرب، والحال تلك، أن يغدو ذلك المواطن فريسة للقلق والتوتّر، وأن تتملّكه الرغبة الاستحواذيّة في مراكمة المزيد من المكاسب والخيرات الماديّة.
كما لا غرابة في أن نراه اليوم، وهو يتهافت على تلك الخيرات، يعتمد أحياناً على وسائل كسب مشبوهة، متغافلاً تماماً عن تلك القيمة الجوهريّة التي في غيابها تختلّ كلّ الموازين، قيمة الكرامة الإنسانيّة.
ولذا نرى هذا الإنسان المتشنّج يمضي بخطى همجيّة، منتهباً برغبة الكسب، داهساً كالجرّافة كلّ الأعراف والقيم التي تكرّس علاقات الوئام وأواصر التّآلف بين البشر.
وعند قمّة تعجرفة نراه يتواثب على الأشياء التّافهة والعقيمة، التي تحوّلت مع الوقت إلى حجاب يمنعه من النّظر إلى الموت وجهاً لوجه، ولم يعد هذا الإنسان تبعاً لذلك ليستحضر الموت إلاّ كحدث عابر حين يغيّب ذلك الموت أحد أقاربه.
شعرة في حساء
وجهاً لوجه مع الموت كما الشّعرة في الحساء، يقذف وباء كورونا إلينا بالموت، ويجعلنا نتلقّفه بملء الوجه، ودون رغبة منّا يكتسح بقوّة مشهد راهننا اليوميّ: مستشفيات محتشدة بالمصابين، مرضى تغشاهم الغيبوبة، آخرون يترقّبون مذهولين لحظة الموت الحاسمة، أطبّاء منهكون من فرط مجالدتهم الوباء، مسعفون مقهورون.. وقد نضيف إلى ذلك، القائمة الرّهيبة لوسائل الإعلام التي لا تنفك تعرض يوميّاً مشاهد المقابر الجماعيّة وأكوام الجثث المعدّة للدّفن. إنّه الموت الذي ينتشر في كل مكان! الموت الذي يرسّخ في الوعي الجماعيّ الإحساس بأنّ الفناء والتّواري عن هذا الوجود هو بلا ريب المآل والمنتهى.
وتولّد مثل تلك المشاهد القاتمة في خيال الأفراد حالة من الارتياب، فيذهب بهم التّفكير أحياناً إلى أنّ الآخر هو سبب ما يحل بهم من كرب وبلاء، فتتغيرّ تبعاً لذلك طبيعة العلاقات التي كانت تشدّهم إلى بعضهم بعضاً.
ويتردّى الأفراد بذلك في وضعيّة شبيهة بالذّاتويّة الارتداديّة.. في «أنا» مضخّمة، تذهب في صلفها حدّ إنكار حقيقة الآخر ووجوده. وإنّها لغريزة حفظ الذّات، أي ذلك الحبّ الأنانيّ الذي يحملنا على الاعتقاد أنّنا معصومون من البلاء. كما يعيد فيروس كورونا الإنسان إلى حالته الطّبيعيّة، فيكشف له، وفي ما وراء زيف التّعاطف الذي قد يبديه البعض إزاء المصابين بالوباء، عن فردانيّته المفرطة.
كائنات هشّة
الإنسان أمام غروره.. إنّ الحقيقة التي لا تحتمل التّزييف والافتراء، هي أنّنا نظلّ في كلّ الأحوال محض كائنات هشّة، في عالم تحكم مسيرته عوامل خارجة عن إرادتنا، تتجاوزنا وتتفلّت من وعينا وإدراكنا.
ورغم الاكتشافات المذهلة التي طوّرت بشكل متسارع أنماط العيش على وجه الأرض.. ورغم تكاثر الآلات الذكيّة التي باتت تسدي للبشر خدمات لا حصر لها، ورغم المركبات الفضائيّة العملاقة التي أصبحت ترتاد الأغوار السّحيقة للفضاء، يظلّ الإنسان مع ذلك منتهباً بأسئلة ملغّزة لا إجابة لها، مندهشاً أمام الأسرار الدّفينة المودعة في الأرض وفي السّماء.
وقد يدرك، حين يحلّ الخطب ويستشري البلاء، أنّ غروره لا يقلّ بلاء عن الوباء، وأنّه مهما تطاول في الكون، سوف يظل عديم الحيلة أمام جزيئات دقيقة.. لامرئيّة، تدبّ حيثما سرت، دبيب الموت والفناء، مثلما تشي بذلك الأسرار الخفيّة المودعة في فيروس كورونا. نحن حينئذ بإزاء جرثومة مجهريّة ذكيّة أربكت جميع العلماء.
أمّا من النّاحية الفلكيّة، فتعني كلمة كورونا أو كورون، وسطاً في حالة تغيّر دائم، أحياناً ما يختلّ توازنه بصورة عنيفة بفعل مرور موجات صادمة.
لقد غدا هذا الفيروس، بما يفرضه من حجر على الأحياء، يحتلّ اليوم قمّة الآفات التي لا يتّسع لها الوصف، والتي لا تنفكّ تولّد الرّعب والهلع والأسى. وإن تيسّر للعلم في يوم ما، معرفة أصله واكتشاف ترياق شاف له، فلسوف يعود الفضل في ذلك إلى العارفين وإلى الطّبيعة. فلكلّ معضلة حلّ، وداخل كلّ حلّ يكمن نقيض تلك المعضلة، وهذا ما نتعلّمه من قانون الطّبيعة.
ولا يعني ذلك البتّة أنّ الأشياء التي لم نكتشفها بعد لا وجود لها، إذ يغطّيها فحسب حجاب متعذّر وصفه، ويمكن أن يغدو مدركاً بفضل تواطؤ الطّبيعة وجسارة الإنسان التوّاق دوماً إلى هتك ستار كلّ معضل وملتبس، ومربك للحياة.
رؤية صحيّة للوجود
يبدو أنّ تفشّي وباء كورونا هو من تلك الأحداث الجسام القادرة على جبّ الرّتابة التي ألفها الإنسان، تلك الرّتابة العنيدة المترسّخة في ذهنه، والقائمة على كبت كلّ شكل من أشكال إحساسه بالموت.
غير أنّ انتشار وباء كورونا، وما يثيره من إحساس فاجع بالموت المطلق، يسهم أيضاً في تغيير الأفكار وتعديل المفاهيم المرجعيّة (البراديغم)، إذ غالباً ما يصبح الإنسان المداهم بخطر الموت توّاقاً إلى أن يعيش الحاضر بملء كيانه، طالما أنّه في ما وراء الحقيقة الحسيّة المباشرة، ليس ثمّة غير المبهم وما يتعذّر تداركه.
ويصبح الإنسان، وفقاً لذلك، أكثر ميلاً إلى تثمين قيمة الحياة، لأنّ إحساسه بالموت المطلق، الموت الوشيك والحتميّ، يحمله أكثر على التحكّم في مخاوفه.
هكذا.. وبفضل كورونا، سوف يستعيد هذا الإنسان ثقته بنفسه، لا بوصفه متفرّجاً سلبيّاً تحكمه الغرائز الماديّة، وإنّما كفاعل قادر بصورة واعية على بناء ذاته بذاته. ويكون هذا الفيروس الذكيّ قد منحه الأدوات المسعفة كيما يتحكّم على نحو أفضل في مصيره. كما يكون هذا الفيروس قد جسّد لديه صورة الطّفل في «التحوّلات الثّلاثة للعقل» عند نيتشه: «الطّفل.. براءة ونسيان، بناء متجدّد ولهو، دولاب يدور من ذاته على ذاته، حركة أولى، برهان مقدّس(...)، ويغدو العقل هكذا أكثر تعلّقاً بإرادته الحرّة، وذلك الذي يكون قد فقد العالم سوف يريد بعد ذلك الإمساك بعالمه الخاص». وحينها.. لن يتأمّل الإنسان في الحاضر إلاّ بأعين متهلّلة، بأعين تكون قد تغيّرت رؤيتها إلى الموت.
أي علاقة بين وباء كورونا والموت؟ لكأنّ هذا الوباء يؤيّد ما ذهب إليه سبينوزا الذي كان يرى في الموت عنصراً خارجاً عن دائرة الحياة. والفكرة لديه.. أنّ الموت لا يعدّ من حيث جوهره منخرطاً في حياة الفرد، ولا يكون هذا الأخير تبعاً لذلك -ولأنّه يستشعره كاحتمال طارئ- على استعداد لقبوله.
وإلاّ كيف لنا أن نفهم أنّ آخرين يتوفّقون في مغالبة فيروس كورونا؟ لقد أدرك هؤلاء أنّ جوهر الحياة ذاتها يكمن في تمسك المرء بالوجود، بعيداً عن كلّ إحساس فاجع بالموت. وأن يتهافت النّاس على رفوف المتاجر لإفراغ محتوياتها، فإنّ ذلك يشي بتصميم الإنسان على مغالبة موت لا تولّده الحياة.
إنّ التغيّر الطّارئ على حياتنا اليوميّة، والخشية من أن تتوقّف بفعل التّوازنات الهشّة التي تزعزعها دوماً عوامل خارجيّة، ينبغي ألاّ نرى فيها عوامل سلبيّة، وإنّما علامات مقاومة يجب أن تختبر إلى أبعد الحدود للذّود عن القيم الأصيلة التي بدونها لا تستقيم الحياة على سطح هذه الأرض.