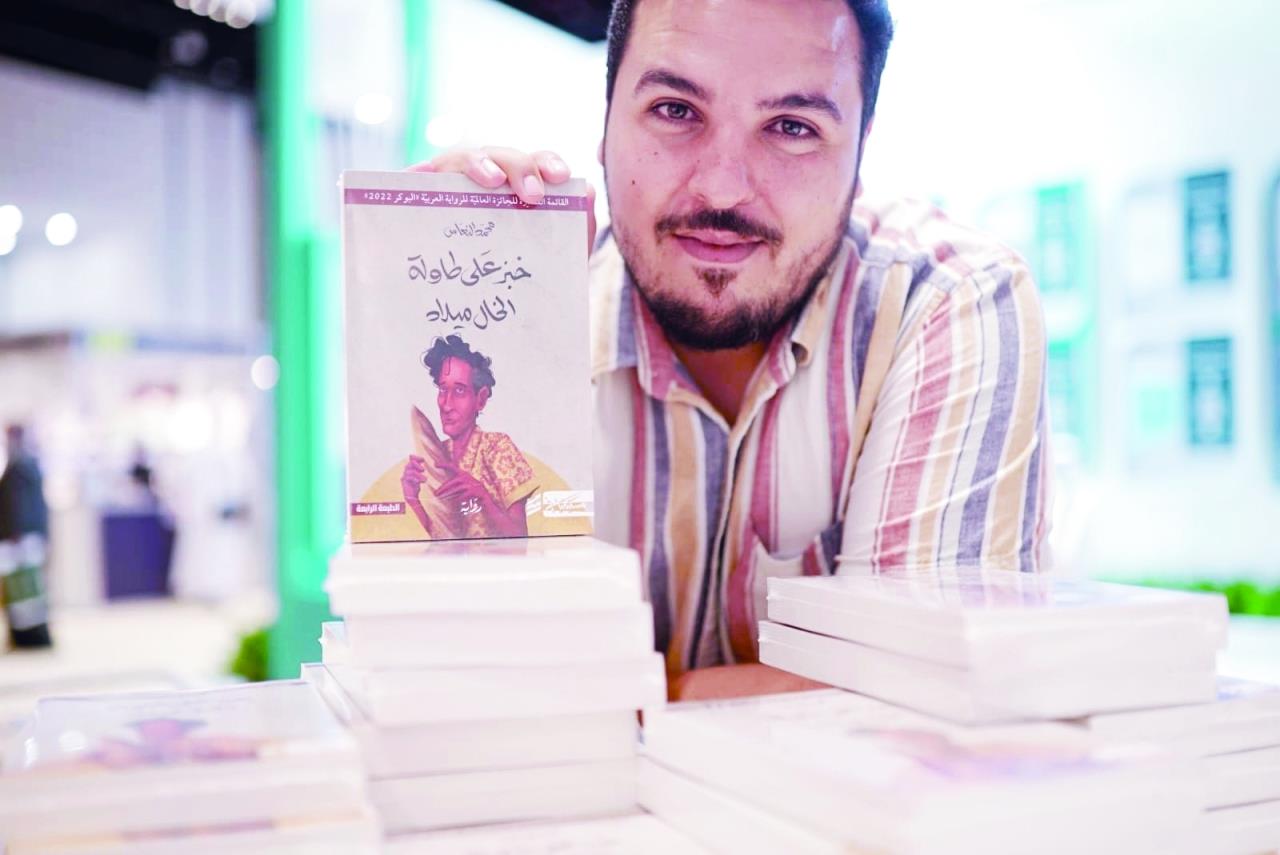"البصيرة لا البصر" المقولة المضمرة لرواية "صوت من وسط الظلام" للروائية د. زهرة خدرج، استطاعت عبر جسر لغوي خصيب بالبيان والتعبير الجزيل الواثق، أن تقدم جملة من المعاني التي ترسم سبيل الثبات الإنساني في وجه المعوقات والعواصف الغاضبة بالحقد والإحباط، وكيف يحيل الإنسان الخيبات إلى منجزات بقوة الشخصية، وشموخ الإيمان، وبتعبير الرواية يحيل الضغط الكربون والفحم إلى ماس شديد الشفافية واللمعان. وأرى أن القارئ العربي يحتاج مثل هذه الروايات التي تنقذه من فلسفة "جمالية القبح"، ومن العدمية التي تصبغ الحدث الروائي في روايات كثر بالعدمية.
وفي نظرية النوع الأدبي يرى قطاع من الدارسين أنه لم يعد هناك هذا النقاء القديم للنوع الأدبي، وأن الأنواع الأدبية تخصب ذاتها بتقنيات أنواع أدبية أخرى شرط ألا تهزم النوع الأدبي الأصيل القائم بالاستيراد لهذه التقنيات، والرواية تنتمي إلى تنويع من تنويعات عدة تقع بين نوعى السيرة الذاتية الصافية والرواية الخيالية، وهى الدرجة الأولى في ألوان الطيف السبعة فى المزج بين النوعين (الرواية / السيرة الذاتية)، فيمكن تصنيف رواية "صوت ..." رواية السيرة الذاتية للشخصية الروائية الرئيسة، وهى "أمنية" التى فقدت بصرها منذ طفولتها وخاضت رحلة صعبة جبلية فى دار الأمل للمكفوفات، ثم "ثانوية الياسمين"، ثم رحلة تجربة عاطفية مرة، حتى استطاعت أن تصل لبر الأمان، وتحوز النجاح والتوفيق العلمي والعملي والعاطفى أيضا فى خاتمة الرواية. وكانت حدوتة الرواية سيرة ذاتية صافية لأمنية فهى السارد الرئيس بضمير أنا، ضمير البوح والإفضاء الغزير بوجهة نظر الشخصية لتعامل الأسرة والمجتمع جميعا مع صاحب الاحتياجات الخاصة. وكيف يدمغه هذا في أعين ناقصة بالنقص، وكيف يجد العنت والعصف بإنسانيته رغم ثبوت حقوقه كامله في العرف الاجتماعي الناضج النبيل، وفي الشرائع جميعا.قدمت الرواية سيرة ذات منحى ملحمي للفتاة الصغيرة المنزوعة من دفء العلاقة الإنسانية الخصبة بالريف الشامي الغني، إلى جليد الإحساسات والعقد النفسية التي تحكم مجموعة من قيمات دار الأمل للمكفوفات، وحشدت الرواية ذاتها بقدر كبير من مواقف إنسانية مؤثرة مركبة شديدة الألم، فالطفلة المغتربة تصاب ببرودة الأطراف ماديا، كما تصاب ببرودة الأحاسيس التي تصيب قلبها من معاملة بلغت ذروة القسوة غير المبررة. والنموذج السابق له مواقف مناظرة كثر على مستوى الرواية جميعها، حتى الخاتمة تنبئ عن مواصلة الكفاح في سبيل التصحيح على درب المقاومة، فهي نهاية تخبر ديمومة موقف الثبات النفسي في مواجهة الظلام، عندما تقدم "رامز" لأمنية الفتاة التي جاوزت عمر الـ 36: "وفي المساء، كنت أخوض الجزء الأهم مع معركة إثبات الذات التي نذرت نفسي لها، مع أسرتي التي لم يكن أحد أفرادها لديه أدنى استعداد لأن يتقبل فكرة أن أمنية ستتزوج في يوم ما ..."
ودعم كونها رواية السيرة الذاتية للشخصية الروائية، حضور الذات الساردة بقوة من اللحظة الأولى حيث وجهت خطابها إلى القارئ العزيز: "هنا ستجد خلاصة حكايتي التي تحمل عبق روحي وتفاصيل حياتي". كما دعم ذلك شواهد نصية كثر، نموذجًا: "كل يوم من حياتي له حكاية تستحق أن تروى، وما أيامنا إلا حكايات تجتمع فترسم مجريات حياتنا وتفاصيلها".
واللغة تحتل في الرواية مكانة مهمة، فهي لغة واصفة للشعور، جائلة في الفضاء المكاني، تتناص على طول الرواية بالنص الشريف، سواء في التضمين المباشر في عناوين الفصول الروائية أو التعبير عن الموقف الشعوري لبطلة الرواية، فنجد عناوين لبعض الفصول: "فابيضت عيناه"، "فرجعناك إلى أمك"، ... إلى آخره من عناوين. كما نجد حديث انتماء اللغة للنبع النمير في مناجاة "أمينة" عن قمع مشاعرها، في وأد قصة حب تعثرت مع "جواد" الذي أحبها لكنه رضخ لأسرته عندما أبت ارتباطه بفتاة عمياء: ".. فرحت أقمعها (تقصد مشاعرها) وأعتقلها في أعمق أعماقي، وأقيدها بمقامع من حديد في زنازين نفسى المظلمة"، والرواية معمورة بهذه الأسلوبية البيانية الرصينة.
وحفلت الرواية بالمسار الرومانسي الخصيب، بحديه الوطني والعاطفي الرقيق، وتألق الحد القومي عبر تثمير رعاية الفضاء المكاني الريفي الفلسطيني، وما يصحبه من روح تكافلية ودود، حيث بتعبير الرواية: "الجميع يقطف ويعصر زيتًا شهيًا، رائع اللون طيب الرائحة" والزيتون رمز مقاوم يخبر عن حياة غامرة بالغرس والعطاء، لذلك تدفقت الملامح الرومانسية العذبة في مظلة هذا الخصب: "الجدة ترضعني من حليب بقرة جيراننا خلال غياب أمي في الحقل". وحيث إطعام الحب، فنجد لمذاق الطعام لذة لا تنسى لأنها مخلوط بالحب: ".. كم كانت لذيذة، طعمها لا يزال في فمي حتى الآن". وهذه البيئة الغنية حافلة بالتغذية بالحنان من قبل الجدة والأب والأم والأخوة، والصديقات الصغار، تؤرخ فيها الأحداث بالمشاعر: "أعوام الحزن الثلاثة في تقويم أمي". فالريف يمثل بتعبير الرواية: "الود والأخلاق والبساطة الشديدة والوضوح الساطع إلى الحد الذي يبهر البصر حتى لمن فقدوا بصرهم مثلي".
واشتغلت الرواية أيضًا على الفضاء المكاني عبر مماثلة الوصف الحسي للداخل الشعورى، بما حقّق سطوع فكرة الرواية وقصدية الحشد الروائي لقضية ظلم تقع على كاهل براعم صغيرة مسكينة، فالوصف المادي لدار الأمل "الخائب" يقدم من طرف ذكي الطرح النفسي لجهامة المعاملة وقسوتها وافتقاد الود في داخل الدار، حيث تقع الدار في: "... منطقة أحراش ملتفة الأشجار العتيقة التي تسكنها الزيغان، ومعزولة فوق قمة جبل يصلها بالعمار طرق ضيقة غير معبدة"، ثم لدى الاستقبال في أول لمحة: "صوت بوابتها ذات صرير مفزع". ثم حدث التبديل في وصف السمات الشخصيات نفسها بمفردات من الطبيعة أيضًا: "كانت الآنسة أحلام هذه جافة جدا في حديثها، كسعفة نخيل يابسة بقيت لأشهر عدة تحت أشعة الشمس اللاهبة، يصدر سحبها على الأرض حشرجة كحشرجة الموت".والرواية رغم منحاها الرومانسي الرقيق لكنها واقعية عندما وضعت المنحى الضد، فتألقت الرومانسية، فالساردة تمتح من "غيابة جب الواقع" بتعبير الرواية، وتمارس العزف: "على أوتار غربة الروح"، وتصف بتعبير الرواية كيف يمضغ الخوف القلوب، وتقدم أطلسا قاتما لقهر أصحاب الحاجات الخاصة، ثم تحيله بياضا بموقف روائي ونفسي مشهود عبر فعل المقاومة. فالرومانسية هنا تنتمي للون الأدب المثالي هذا الأدب الذي ينشد الكمال والخير وينقب عن دواعيه وأدلته ووسائل تحفيزه وبنائه بصبر ومحبة ورضا رغم مرارة الواقع الممرضة.
وعبر التأسيس الروائي قدمت الملامح الجسدية والنفسية لعدد كبير من الشخصيات، واستبطنت الساردة تلك الملامح الكثيفة عبر ارتداد الأصوات لسمعها، والروائح لأنفها، والأفعال لروحها، فصحبها القارئ مبصرا عبر وجهة النظر للشخصية الممتحنة بقسوة في أسر ظلام العين وظلام النفوس جميعا.
ووضحت الرواية دعم الواقعية في أنحائها عبر تقنية الحلم، ثم توضح الجانب المشرق أيضا عبر ذات التقنية، حيث تجد "أمنية" ذاتها في صحراء قاحلة مخيفة، ثم تعثر على حباب من اللؤلؤ، ثم تقطف ثمارا لم تر مثيلا لها في كبر حجمها ولذة طعمها، ودعاء أمها لها بالرضا. وتصف الرواية وجوها كثر من معاناة "أمنية" وعذابها، فمسامير "برايل" حادة تؤلم وتحدث الجروح، وتجربة الكتابة بشعة مغرقة بالدم، ثم تحيل الليمون الحامض شرابًا حلوا – بتعبير الرواية ثمار الليمون كالثريات اللامعة بين الأغصان - فتروي شعورها بالإفضاء بالكتابة عبر "برايل" وفكرة "الطب بالكتابة" لعذابات الروح: "علمتني تجاربي أن نزيف الحروف يهون من نزيف الروح".
وانتهجت الرواية طريقة مظاهرة المفردات اللغوية الحاشدة للتعبير، ففي موقف مقتلة طقوس البراءة في ظلال الدار: "ووجدت نفسي في سجني المقيت مرة أخرى .. أتنفس هواءه العفن، وأنام على سريره البائس، وأمضي أيامه القاسية وحيدة غريبة"، هنا نجد ثمانية مفردات (ووجدت نفسي أنه فعل قسري عليها / سجني المقيت / الهواء العفن / السرير البائس / الأيام القاسية / الوحدة / الغربة) في عبارة مشكلة من تسع عشرة كلمة فقط، وهذه الأسلوبية الحاشدة طرقت جوانب كثر من الرواية.
وقدمت الرواية بتعبيرها فكرة اللصوق بالخوف، ومفردات الطبيعة كمعادل للأطوار النفسية العصيبة، حيث "الظلام يميط اللثام عن وجهه البشع"، وحيث مفردة "البرد" حاضرة بقوة معادلا لجفاف العاطفة: "أرتجف طوال الوقت كشجرة زيتون وحيدة على قمة الجبل تعصف بها رياح كانون فتتشبث بالأرض وتبذل مزيدا من الجهد لتبقى على قيد الحياة"، "السعادة لحظات متطايرة حد الخيال، سريعة التلف حد اللامعقول".
وهذا الجانب عمر بالمجازات القوية: "الدموع الملوثة بقهر معتق"، "روحى بقيت مسقوفة طوال إقامتي .. بسحب عميقة لا يرجى منها مطر أو خير"، "أمواج البحر تتقن البكاء، والرياح تتقن العويل". وفي رحلة الرواية نجد تأريخ البصيرة عبر هذا المزيج بين الواقعية والرومانسية، بين الألم والسعادة، بين الصعاب والنجاحات، في حشد لغوي كبير من الوصف والبيان الرصين، تقول "أمنية": "أدركت أن الدنيا لم تخلق فقط للألم والحزن، ففي الدنيا أشياء جميلة وممتعة تجعلنا سعداء"، أو كما جاء في موطن روائي آخر: "المشاعر الطيبة لا تنعدم بين الناس، كما لا ينعدم الناس الطيبون"، وموطن ثالث عن "وردة تسلي القلب"، وعن ترميم القلب وإذهاب حزنه. ثم قصدية الرواية النابهة للقارئ التي أجدها في تعبير الرواية "إدخال كسرة من الطمائنية للقلب" النبيل.