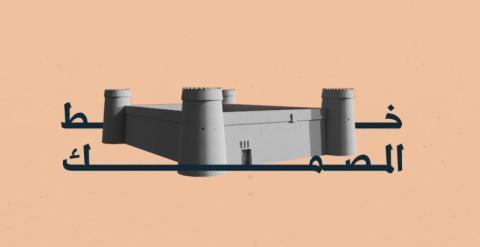... زميلي في المدرسة الثانوية اسمه قاسم، يسكن في حوش قرب الإمام، كان يركب الخط من أوله ويبدل في باب الخلق ليأخذ ترام رقم اثنين وعشرين، يصل جنوب المدينة بشمالها، من العباسية حيث نهاية الخطوط كلها ومأوى العربات بعد انتهاء الخدمة، معروف مخزن الترام، كان كله حتى منتصف الستينيات يعتبر من حدود المدينة، حيث مستشفى الحميات، والأمراض العقلية، كلاهما معزولان.
على مقربة كلية الشرطة، بابها عتيق، على جانبيه مدفعان، إلى جوار كل منهما جندي يقف مثل التمثال، في المواجهة مبنى مدرسة العباسية الثانوية الصناعية، عند أول الشارع مدرسة السرايات للبنات، رداء التمليذات بني اللون، للمتفوقات، لذلك تبدو الخصوصية في العناية بالمظهر، الجدية، معظمهن يجئن من أماكن بعيدة، لي مع إحداهن أمر سأقصه بعد قليل.
ذلك أن المكان يقوي علىّ وقت هذا التدوين، يحضرني كما كان وقتئذ، هذا لم يعد موجودا، ازدحم، اختفت المعالم القليلة المحددة ومنها مخزن الترام، مازال مبنى كلية الشرطة قائما، لكنه توارى في مواجهة الأبراج المرتفعة.
انتقلت الدراسة إلى مبنى حديث في امتداد القاهرة إلى الشرق، أما مستشفى الأمراض العقلية فصارت في قلب الطريق المؤدي إلى مدينة نصر التي لم يكن لها وجود وقتئذ.
كان اسم المكان «العباسية» يستحضر البُعد لأنه على أطراف المعمورة، عند الحد، ويعني الجنون لوجود المستشفى، إذا أراد البعض وصف أحدهم بالخلل يقول «دا عباسية خالص».. أو «دا خانكة».
إنها الصحراء، الامتداد اللانهائي، اللا حد، الهباء، الاقتراب من جوهر العدم، ذلك ما أدركته في مطلع الستينيات، رغم تناثر بعض المباني، وجود معسكرات الجيش الممتدة حتى كوبري القبة، أقام فيها الجيش الإنكليزي من قبل، رغم المواصلات التي ينتهي معظمها في ميدان العباسية، ويستأنف بعضها إلى ضاحية مصر الجديدة، التي يربطها بميدان الحديد ترام أسرع، أكثر تطورا.
عُرف في بدايته بالمترو الأبيض، رغم جزر العمران تلك لم أعرف مكانا في العالم أدركت فيه الصحراء وغمرتني مثل هذا المكان، يتكثف حضورها ما قبل الظهيرة وما بعدها، الأشجار المصطفة في شارع السرايات أمام المباني الأنيقة تزيد من حدة حضور الخلاء، الذي لم أعرف له مثيلا حتى عند خروجي في دوريات الصاعقة إلى أقاصي الغرب، إلى أماكن لا وجود لها على الخرائط، وكنت أشارك أحيانا في تسميتها أي إظهارها إلى الوجود، هناك في الجلف الكبير حيث الرمال التي لم يلمسها بشر لم يدركني تجسيد الصحراء.
كما عرفتها في ظهيرة أخرج فيها من المدرسة إلى محطة أوتوبيس رقم سبعة عشر ويتبع شركة فؤاد درويش الخاصة حتى تأميمها، يمر بالدراسة ولم يكن الطريق مرصوفا، أرى من خلاله المقابر ومصلحة سك النقود ودير الآباء الدومينكان ومطبعة الحلبي، ومقبرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة الذي اغتاله الإخوان.
أنزل في الأزهر، يستمر حتى السيدة نفيسة، مكانها قصي، تحت القلعة، ولم يكن مغمورا بالخلق والزحام العمراني كما هو عليه الحال الآن، مركبات الخط قديمة، بطيئة، تنفث بخاراً، وآلة التنبيه معلقة خارج النافذة المجاورة للسائق، يمد يده فيضغط ما يشبه القربة الصغيرة فيصدر صوت غليظ كخوار الجاموس، لا يوحي به الحجم الصغير.
في الترام آلة التنبيه تحت قدم السائق، معدنية مستديرة، يضغطها فتصدر رنات جرس مازلت أسمعه حتى الآن.
كنت أفضل استخدام الترام على مرحلتين، الأولى من الأزهر إلى العتبة، أو شارع الخليج بورسعيد فيما بعد وصلة رقم تسعة عشر، حتى الآن لا أمر أمام سوق الخضار إلا وأجزع بدرجة، كدت أفقد ساقي هنا، وربما حياتي.
من الخليج أركب ترام اثنين وعشرين، عربتان من الطراز القديم، بلا جدران، المقاعد مكشوفة، من العتبة، أول شارع الجيش الأمير فاروق قبل الثورة يمر الترام رقم ثلاثة وثلاثين القادم من إمبابة والذي تحول فيما بعد إلى تروللي، أي حافلة لها سنجة متصلة بخطوط الكهرباء، تماما مثل الترام، غير أن العجلات من الكاوتش غير مقيدة بقضبان.
رأيته أول مرة عندما صحبت العائلة يوم جمعة لزيارة عائلة الحاج أحمد عمر، بلدياتنا من طهطا، وساكن الطابق الأول من بيت درب الطبلاوي، وصاحب أول راديو في الحارة قبل الست روحية، بعد محاولة اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية.
وقد سمعت الطلقات الثماني في عين توقيتها عبر المذياع المنبعث من المنور، علمت أن أحمد عمر قرر الانتقال مع أسرته إلى مدينة العمال الجديدة بإمبابة حيث حصل على مسكن مستقل من طابقين يحيطه حديقة، أحد أقاربه المتنفذين توسط له لأنه تاجر وليس عاملا.
في قعدة العصر فوق السطح، سمعت أمي تقول: يا سلام لو كان لنا بيت مثله، قال أبي: نحتاج إلى واسطة والأهم المقدرة، غمرني حزن لأن الانتقال مرتبط بثريا ذات البهاء والإمارة، ابنة الحاج، تكبرني سنا لكنني تعلقت بها عن بعد، كل ما غمرني وهدهد روحي كان على البُعد، وما زلت.
أيضا ثناء ذات العينين الخضراوين، أول لون أخضر أراه في حضرة بشرية، تمت إليهم بقرابة، صحبتها في الحارة وأنفقت عليها خمسة وعشرين قرشا كانت في كيس جلدي، عثرت عليه أمام جامع سيدي مرزوق، ظلت تتجول بصحبتي وتطلب حلوى ولعبة وعروسة صغيرة وشربنا سوبيا عصير أرز قرب الخرنفش، وخروب أمام المسجد والضريح الحسيني.
وعندما سألتني قرب المغرب عما تبقي وتطلعت إليها صامتا، قالت: يعني مفيش؟، أدارت ظهرها وقالت إنها سترجع بمفردها، مشيت متمهلا أبحث عن موضع ألقي فيه الكيس الفارغ خشية سؤال من أمي أو استفسار من أبي فأضطر إلى الاعتراف، إنني أنفقت من فلوس حرام، لا تخصني، ولكنها ثناء.
رغم أنها تركتني وتطلعت إليّ من فوق، كانت تتقدمني بعامين، أما ثريا فليس أقل من خمسة، أراها الآن رغم العدم، لا أعرف إن كانت ساعية أم أنها في اللاهناك، عيناها القديمتان، تماما مثل أميرة الجيزة صاحبة الثوب الأبيض والجالسة حتى الآن في المتحف المصري إلى جوار زوجها.
من ديوان الشعر العربي
جار الزمان علينا في تصرُّفه
وأيّ دهرٍ على الأحرارِ لم يَجُرِ
عندي من الدهر ما لو أن أيسرهُ
يُلقي على الفلَكِ الدّوارِ لم يَدُرِ
ابن لنكك البصري.