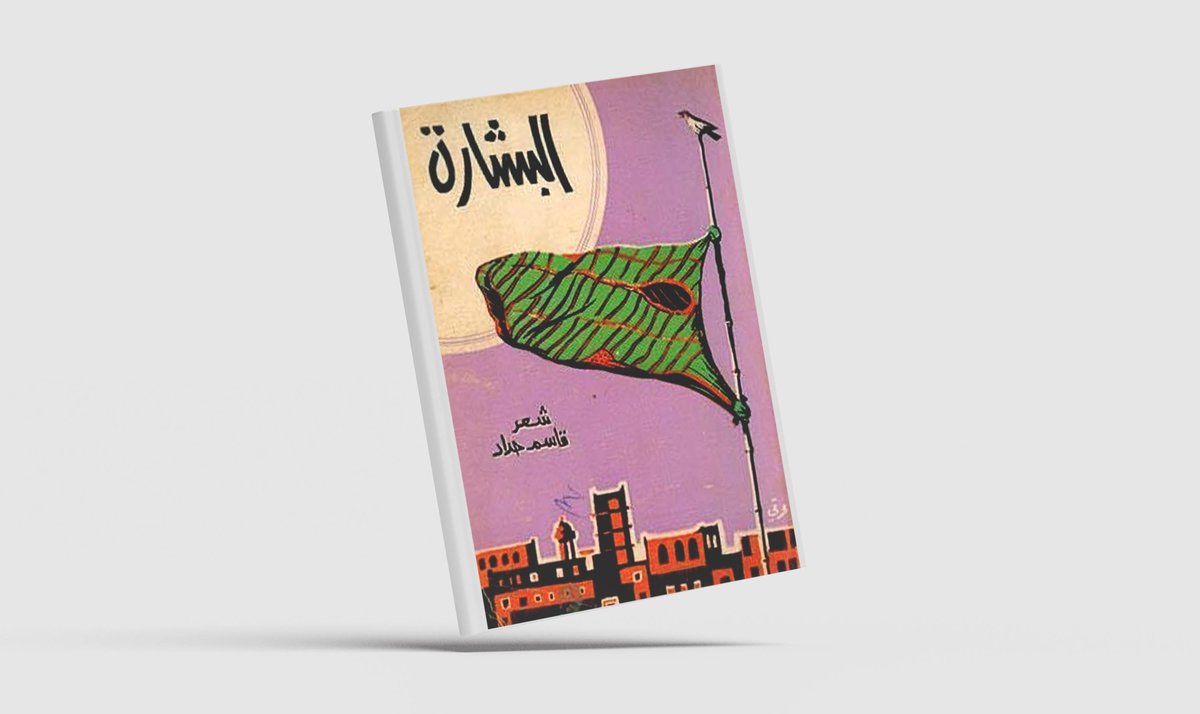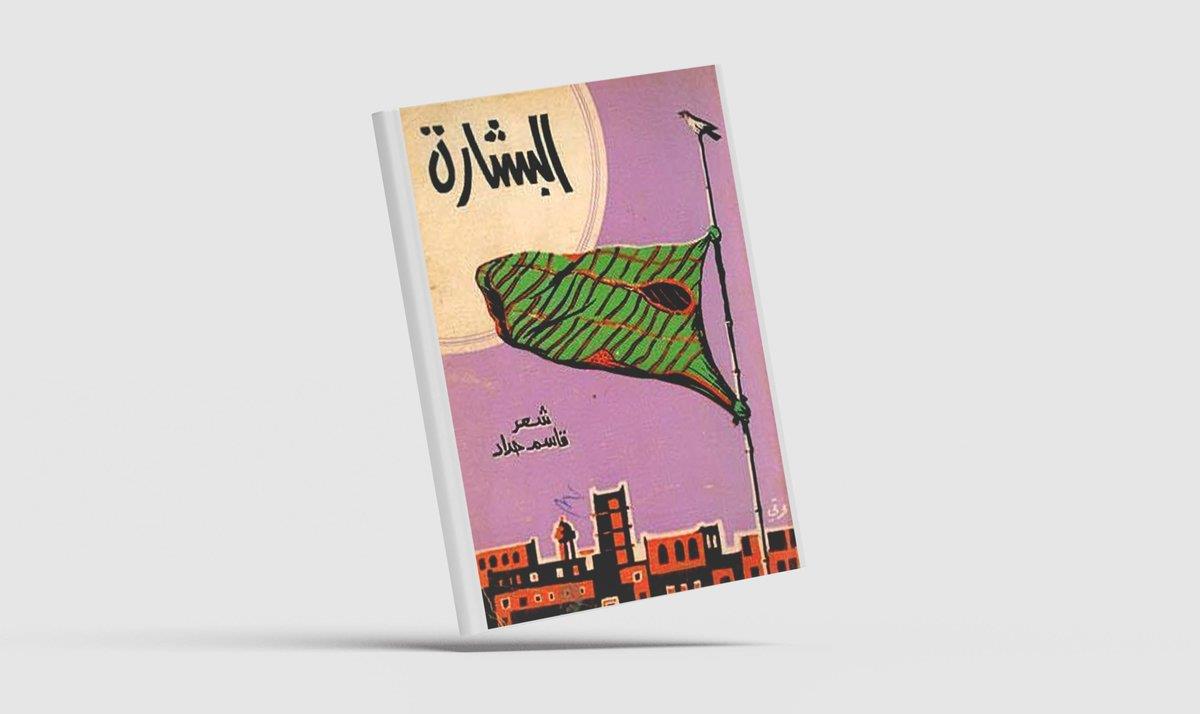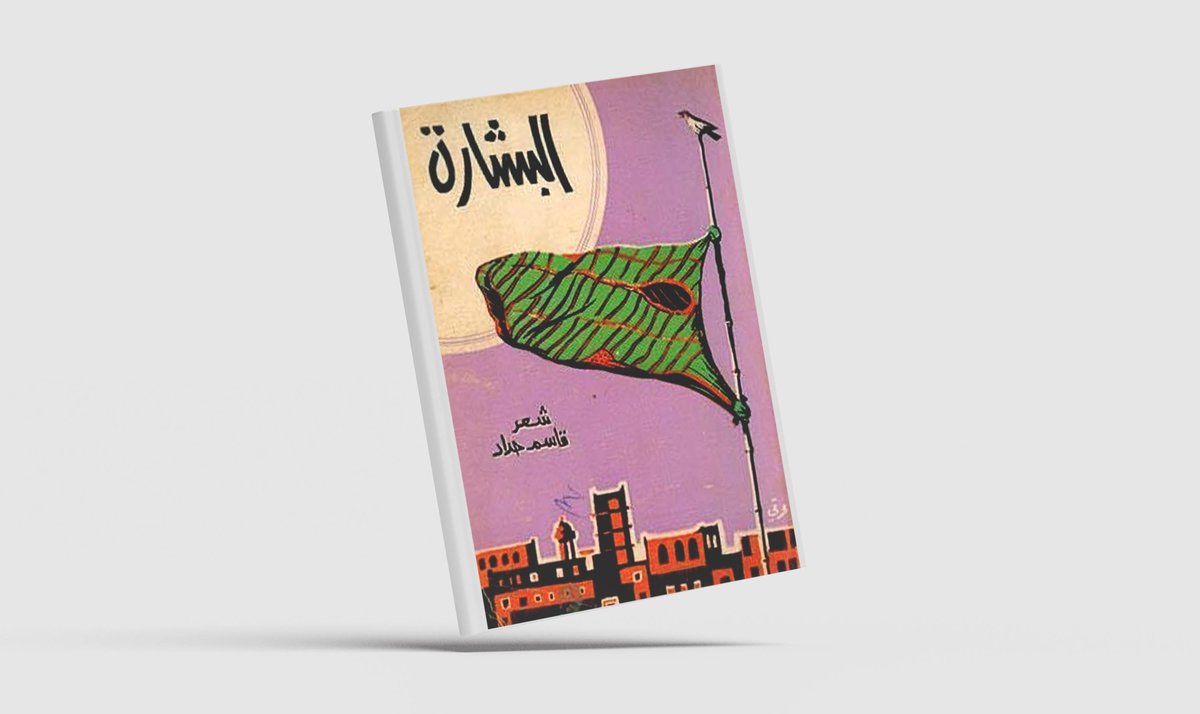
حين أراد المجلس الثقافي البريطاني أن يحتفل بيوم الأمم المتحدة العالمي للغة العربية عام 2016، اختار ديوان «أخبار مجنون ليلى» للشاعر البحريني قاسم حداد ضمن خمسة أعمال «تعطي نظرة فريدة عن ثقافة العالم العربي وتراثه على مر التاريخ». ومؤخراً صدر لقاسم ديوان جديد بعنوان «المنسيات» عن دار «منشورات المتوسط» بميلانو بإيطاليا. ويبدو الديوان وكأنه خلاصة رحلة الشاعر مع الشعر والحياة، مستعيداً في ظلالهما تراكمات الزمن وخبرة الذات في اللعب على وتر الذاكرة والحلم. وهو ما يتناثر في معظم دواوينه ومنها: «البشارة» 1970، «يمشي مخفوراً بالوعول»، «رشيق كالوقت ولا بيت له»، «موسيقى الكتابة – عن إيقاظ الذاكرة وصقل المرايا»، «ثلاثون بحراً للغرق».
هنا حوار مع قاسم حداد حول ديوانه الجديد وهموم الكتابة:
* «بعدَ خمسينَ عاماً
كنَّا معاً نُجرِّبُ عقيدتَنا في الكتابة
ونُرمِّمُ ما أفسدتْهُ المدارس»
هذا ما تكتب في ديوانك الأخير، فإلى أي حد أصلحت الكتابة ما أفسده الدهر، وحمت مسيرة الشاعر من عثرات الطريق وأذى الماضي؟
- لا أظن أن الكتابة بوسعها فعل أي شيء، كذلك الشعر لم يعد بإمكانه مواجهة تلك الأشياء. والحقيقة التي يجب أن ننتبه إليها جميعا هي أن وتيرة الفساد أصبحت أكبر من إمكانية الإصلاح، أقصى ما يمكن أن نطمح إليه هو حماية الذات من الأذى في مواجهة العالم. شئنا أم أبينا، لكن علينا الاعتراف أن الكتابة صارت حماية ذاتية فحسب. قلت أيضا إن الشعر حصني ضد العالم. وأنا بدأت رحلتي مع الكتابة والشعر محملاً بهواجس معرفية وبحثية وليس بالضرورة نوعا من العفوية أو الخواطر التلقائية. وهذا ما تردد صداه في كثير من أعمالي ومنها على سبيل المثال ديوان «أخبار مجنون ليلى» الذي يستلهم قصة الحب الذي عاشها قيس بن الملوح في صياغة عصرية ويعيد استنطاق الأسطورة على نحو خاص.
* «إننا أسف الأمس والبارحة
على لبن ليس ينفعنا في التراب
مثلنا
نحن في قلعة حرّة
ومن دون باب
تلك قصتنا الجارحة».
كيف تنظر خلفك، في غضب أم لا مبالاة، وهل الذاكرة حبلى بالجراح؟
- سبق لي وعبر محطات عديدة في مسيرتي أن نظرت خلفي بغضب. الآن أميل إلى اللامبالاة. لديّ تاريخ كثيف من الجراح. وبشكل عام أنا من المؤمنين بأن الشاعر يجب ألا يتورط في واقعه أو ينشغل بمتغيراته الآنية. عليه أن يبقى على مسافة بين نصه وبين الواقع الخارجي. من هنا فقط يمكن للقصيدة أن تعكس ما هو جوهري وليس سطحياً من أمور الحياة.
* «يدخل قصيدته بالخطوة العسكرية
يؤدي التحية
يرخي لجام الحصان
ويتركه
يجوس السهول بحرية الريح»
تستهل بهذه الأسطر قصيدة «الشاعر»، التي أهديتها إلى محمود درويش بلا مناسبة، فما الذي استدعى هذا الشاعر المدهش إلى حديقتك، وكيف ترى علاقتك به إبداعيا وإنسانياً؟
- لا أزعم أنني كنت صديقاً لمحمود درويش، التقيته منذ سبعينات القرن الماضي، في بداياته مع بيروت، وفي تسعينات القرن الماضي في ألمانيا. لم أتوقف عن معرفة شعره طوال الوقت... من يعرفه يدرك أن خطواته كانت عسكرية في الواقع، رأيت ذلك وهو يذهب إلى الموت ببسالة، كما كان يدخل إلى القصيدة.
* توظف التراث كثيراً في أعمالك. كيف تنظر لعلاقتك بالتراث؟
- علاقتي بالتراث العربي قديمة ومتجددة باعتبارها تجربة إنسانية وجمالية تخضع للنجاح والفشل، لكني لا أتخذه نموذجاً لما نكتب ولا أتعامل معه بتقديس وأدعو إلى مساءلته بحرية كاملة وبآليات وحساسيات جديدة طبقاً لقوانين العصر ليس قوانينه القديمة هو. من وقت إلى آخر أعود إلى النصوص القديمة وأكتشف في كل مرات جماليات جديدة مدهشة.
* خمسون عاماً من الشعر ومراودة القصيدة عن نفسها، هل خذلك الشعر أحياناً؟
- خمسون عاماً ليست وقتاً طويلاً. أتمنى أن يمتد بي العمر لكي أكتب ما أحب. الشعر لا يخذل، الواقع هو الذي يفعل ذلك. من دون شرط الحرية لا يستطيع المرء أن يتنفس، فما بالك أن يبدع. لا بد من الحرية للمبدع إذا ما أردنا له أن يكتب رأياً أو يحدد موقفاً. لا يمكن أن نستمتع بموسيقى الطيور أو غناء العصافير وهي في القفص.
* مارست في سنوات صباك الأولى العديد من الحرف اليدوية مثل الحدادة والنجارة والبناء... كيف انعكس ذلك على حساسيتك الخاصة في تشكيل قصيدتك؟
- الحياة مع الناس هي يوميات جديرة بالتجربة الإنسانية في رعاية الشعر. لقد تعلمت دروسي الإنسانية المبكرة من هذا النوع من يوميات العمل. وربما كانت تجربتي الشعرية مدينة لحياتي المشحونة بالعمل. كنت زاخراً بالأمل يوم كنت في العمل، كل الكل في اليدين.
* ربما لا يعرف كثيرون أن اسمك الحقيقي المثبت في أوراق الهوية هو «جاسم الحداد»، لكنك جعلت اسمك الأدبي «قاسم حداد» افتناناً بالشاعر الجزائري «مالك حداد» الذي عاش في الفترة من 1927 حتى 1978... ما سر هذا الافتنان وهل لا يزال قائماً؟
- تعرفت على ذلك الشاعر من كتابه «الشقاء في خطر». وقتها كان الشقاء قانون حياتنا، وربما لا نزال، وأظن أن علاقتي بالشعر في بلاد المغرب العربي كانت مكوناً أساسياً من مكونات التحولات العديدة التي طرأت على حياتي الأدبية. وسوف أعتز بهذه العلاقة وهذه التحولات غنية الدلالات. أشكر مالك حداد على ما ألهمني به من تسميات، وأعتقد فعلاً بأن «قاسم حداد» أفضل من «جاسم محمد محمد حمد الحداد» وإن كنت أحب «جاسم» أكثر من «قاسم».
* من جائزة «المنتدى اللبناني في باريس» عام 2000 إلى «ملتقى القاهرة للشعر العربي 2020... مشوار حافل بالجوائز وأوجه التكريم، ماذا تعني الجوائز بالنسبة لك»؟
- الجوائز محطات مسؤولة عن تفاقم مشكلة أن تكون شاعراً. مسؤولية هي، يجب تهنئة الجوائز بفوزها بالشعراء. يظل الشاعر كذلك قبل الجائزة وبعدها.
* كيف تتابع الجدل الدائر حول ما يقال عن تراجع الشعر في الثقافة العربية، وعدم حماس دور النشر له، وكيف أن الرواية أصبحت ديوان العرب... هل بات الشعراء - على حد تعبير البعض - مثل الأيتام على موائد اللئام؟
- تلك مسألة أطلقها صديقنا الناقد المرحوم جابر عصفور، وأخذتها الصحافة بوصفها حكماً قيمة. لسنا في حلبة سباق. فالعالم يتسع لكل أشكال التعبير الأدبي. خصوصاً وأننا صرنا بمعزل عن التصنيف الفني منذ زمن. صارت الكتابة الأدبية حرة من التوصيف. لكل كاتب حرية أن يكتب ما يريد. ويزعم تصنيف ما يكتب، لكن الأكيد أنه لا يستطيع حجب شطحات الآخرين.
* بتعبير آخر، هل الشعر العربي «مأزوم»... هل يعاني من أزمة ما؟
- لا أعتقد أن تعبيرات من نوعية «مأزوم» أو «أزمة» تصلح لوصف المشهد الشعري الراهن، فالشعراء يتحركون بحريتهم، حريتهم الداخلية على الأقل، ويتحررون من شروط الواقع ويصنعون إمكانات إبداعية هائلة للتجاوز والمضي قدماً. والشعراء الجدد تحديداً يمنحون المشهد حيوية ويقترحون علينا إعادة النظر فيما نكتبه. وإذا كانت هناك أزمة، فهي ليست في الشاعر أو القصيدة، بل في الواقع العربي، الذي لا يأمن جانباً للثقافة ويرى فيها نوعاً من العداء أو التهديد، وهنا أقصد الثقافة بمعناها الجوهري، أي رؤية الواقع بنظرة نقدية.