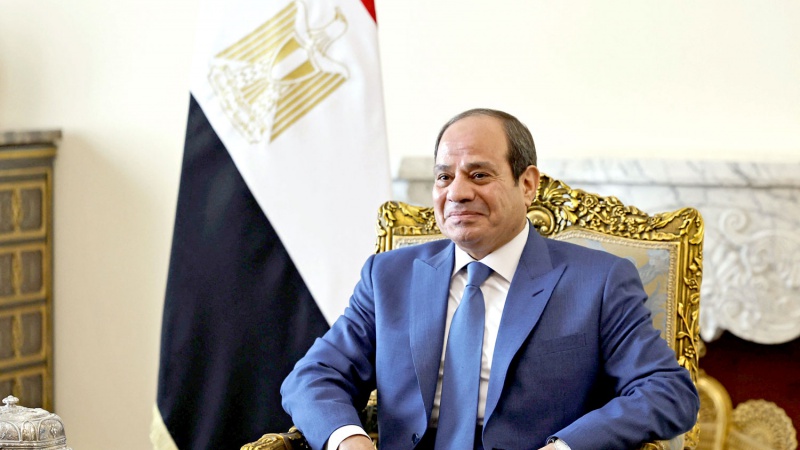دفعت التحديات المتسارعة التي تواجهها الدولة المصرية في الداخل والخارج بعض المؤسسات الدينية إلى زيادة حضورها السياسي، في محاولة تستهدف التماهي بشكل أكبر مع الحكومة وقت الأزمات، ما وضعها في مآزق عديدة مع الشارع، سواء كانوا المؤيدين أو المعارضين للقرارات السياسية.
القاهرة – أضحى تركيز المؤسسات الدينية على الحديث في قضايا سياسية أمرا معتادا، وهو توجه قد يكون غريبا على المجتمع، حيث كانت كل هيئة دينية تقف على الحياد، وترفض إقحام نفسها في موضوعات لها علاقة بالأوضاع السياسية، خشية ردة فعل الشارع، لكن تغيرت المعادلة وصار الخطاب الديني مسيسا بشكل لافت، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية فتوى تحدد الحلال والحرام في تهديد أمن البلاد عبر المياه.
ووصل الحضور السياسي للأزهر، لما هو أبعد من قضية سد النهضة، وأصبح تركيزه على الصراع الليبي من خلال التأكيد على حتمية الوصول إلى تسوية للأزمة، ثم زاد على ذلك بمناقشة آليات الحفاظ على الأمن القومي، ومتى تتدخل الحكومات للدفاع عن نفسها وحقوقها ومكتسباتها.
ركزت دار الإفتاء على الشأن الداخلي بإصدار فتوى أحدثت جدلا مجتمعيا وسياسيا، عندما أفتت بأن التنمية هي الطريق الأمثل لمحاربة الإرهاب، في تأييد غير مباشر للحكومة على التوسع في المشروعات القومية، رغم الانتقادات التي تتعرض لها بين الحين والآخر، لتركيزها على الإنجاز في ملف التعمير، وتجاهل محاور أخرى مثل التعليم والصحة ومحاربة الغلاء.
تشرعن الفتاوى الدينية للحكومة المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية، وتطالب بحتمية مساندة الحاكم في القرارات المصيرية، والخروج عن طوعه يخالف الشريعة، ما وضع دار الإفتاء في مرمى النيران من قبل جمهور التواصل الاجتماعي حتى عجزت عن تبرير موقفها.
أعاد مناهضون لهذه الفتاوى، وأكثرهم من المؤيدين للحكومة، تذكير المؤسسة الدينية بأن جماعة الإخوان المسلمين عندما كان نظام حكمها يترنح خرج قادتها لترهيب الشارع باسم الدين، واستخدمت نفس النبرة في تحريم عصيان قرارات وسياسات الحاكم والدعوة لمساندة شرعيته، وهو ما رفضته آنذاك الأغلبية المجتمعية وتمسكت بالتمرد على الرئيس الإخواني محمد مرسي، ولذلك يأبى الكثيرون وضع النظام الحالي في الدائرة نفسها ولو بحسن نية، حيث يمنح المتطرفين فرصة للقفز على خطاب السلطة، وتفسيره بصورة خاطئة.
يمكن من خلال نوعية الفتاوى التي تحمل صبغة سياسية اكتشاف أن هناك توزيعا للأدوار بين المؤسسات الدينية، فالأزهر يستثمر ثقله ونفوذه ورمزيته في التركيز على القضايا التي لها أبعاد خارجية، ودار الإفتاء تختص بالشأن الداخلي، ووزارة الأوقاف تناور بين ما هو خارجي ومحلي في خطابها الديني.
صحيح أن أغلب القضايا التي تختار المؤسسات الدينية دعم الحكومة فيها تتطلب حشدا شعبيا لمساندتها، وهذا منطقي ومقبول في هذه الأجواء، لكن الخطاب الديني ليس دوره إضفاء القدسية على كل قرار سياسي، لأن ذلك يوحي للبعض بأن الدولة ليست قوية بالشكل الكافي، وتحتاج إلى دعم ديني ليتقبل الشارع هذا القرار أو ذاك، في حين أن الواقع عكس ذلك، فالدولة صلبة وتمتلك أدواتها الخشنة وغير مضطرة لذلك.
يبني المعارضون لهذا التوجه وجهات نظرهم على عدة أسباب، أولها أن المؤسسات الدينية لا يجب أن تظهر بشكل يهز مصداقيتها وحيادها وثقلها في الشارع، كما تفعل نظيرتها في بلدان أخرى مثل تركيا، حتى لو كان تدخلها جاء طواعية.
ومن غير المقبول أن تبدو المؤسسة الدينية مدفوعة للتماهي السياسي مع السلطة، كما يفعل النظام التركي ويجبر الدعاة على دعمه، ليوظف حضورها ونفوذها في الشارع لإقناع مواطنيه بأنه على حق، بدليل أن الرأي الديني يصطف خلف تحركاته، فقد نبذت مصر مبكرا هذا الكهنوت.
كما أن دخول المؤسسة الدينية على خط أيّ أزمة سياسية، يثير الشكوك في توجهاتها ويعتقد البعض أنها تتحرك بتعليمات، وهناك من يرهن فتاواها بوجود مآرب غير معلومة، ما يترك انطباعات سلبية حتى لو أصدرت ذات يوم فتوى مناهضة للحكومة، ويوسع الفجوة بينها وبين الشارع، ويصبح الخطاب الديني الرسمي فاقدا للمصداقية.
يظل المبرر الأهم، أن المجتمع الذي ما زال يُعاني من تداعيات وصول تيارات الإسلام السياسي إلى الحكم قبل ثماني سنوات وتوظيفها للدين لتحقيق أغراض مشبوهة، وتدخل الملايين لإزاحتها بثورة عارمة في يونيو 2013 بعد مرور عام واحد، لا يريد إعادة المشهد باستخدام الخطاب الديني كأداة لتمرير أو إقناع الشارع بقرارات أو توجهات حكومية، لاسيما أن أغلب الناس أصبحت مقتنعة أكثر من أيّ وقت مضى بأن هناك حاجة ملحة لدعم الدولة بقوة، ولا يحتاج الأمر لإقناع ديني.
لا ينكر الكثير من رافضي انخراط المؤسسة الدينية في الشأن السياسي أن أهدافها نبيلة في هذه المرحلة الحرجة، كنوع من التعبئة العامة، لكن الخطورة أن الشارع سيتعامل مع رؤوس المنظومة الدينية على أنهم جزء من السلطة، ما يعني أن الناس يعطون لأنفسهم حق قبول أو رفض الفتاوى، والشك في أهدافها وتوقيتاتها ودوافعها، مهما بلغت نزاهتها.
ولطالما تنامى شعور العامة بأن رجل الدين يخلط بين الدعوي والسياسة، فإن فقدان الثقة في نواياه سيكون أمرا متوقعا، وهي التحذيرات التي أطلقها مؤيدون للحكومة قبل سخرية المعارضين من هذا التوجه. فرجل الدين ليس مطلوبا منه أن يتحول إلى عالم في السياسة والاقتصاد والإعلام، لأن ذلك يعرقله عن مهمته في محو الأمية المعرفية بالدين، ويجمد الخطاب عند القصص والحكايات التراثية، ويصبح في نظر البعض تاجرا يسّوق لبضاعة حكومية.
الأدهى أن شعور شيوخ السلفية الشغوفين بالقفز على المشهد، بأن المؤسسة الدينية منشغلة أكثر بالسياسة، يجعلهم يوظفون الأمر للنفاذ إلى عقول الناس، بذريعة أنهم الفصيل الديني الأكثر استقلالية وحيادية، ويستغلون الموقف للتشكيك في الفتاوى الرسمية، ويقدمون أنفسهم للعامة باعتبارهم من يستحقون أن تُوجّه إليهم الاستفسارات، وتكون هناك حُجة لحضورهم، ويجد من يتوجهون إليهم أكثر من حُجة للاستعانة بهم.
وإذا كانت الأوقاف نجحت في إقصاء خطباء المساجد من السلفيين والمتطرفين لمنع تسييس الخطاب الدعوي، فإن انخراط الوزارة ومعها الأزهر ودار الإفتاء في قضايا شائكة، قد يُعطي الكثير من أئمة دور العبادة المبرر لتكرار نفس الفعل من أعلى المنبر، بذريعة أن الجهة التي تضع الضوابط الحاكمة للخطاب الديني لا تطبقها.
غير أن المؤيدين لانخراط رجال الدين في ملفات لها علاقة بالسياسة، لديهم مبررات يمكن أن تكون مقبولة نسبيا، ومن هؤلاء النائب البرلماني والباحث في شؤون العقائد محمد أبوحامد، الذي قال لـ”العرب”، “المؤسسات الدينية جزء من كيان الدولة، ويجب عليها دعم الحكومة في القضايا القومية الوطنية، وغير مطلوب منها الوقوف على الحياد والتزام الصمت”.
وأضاف أن مهمة الخطاب الدعوي في ذروة التحديات الداخلية والخارجية، أن يصحح المفاهيم الدينية الخاطئة التي يروج لها سياسيون لشرعنة تدخلاتهم المشبوهة في تهديد الأمن القومي للدول، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتصرفاته المزعجة للأمن القومي المصري، لكن لا يجب تخطي هذا الدور لأي مؤسسة دينية بأن تقحم نفسها في معارك سياسية مباشرة.