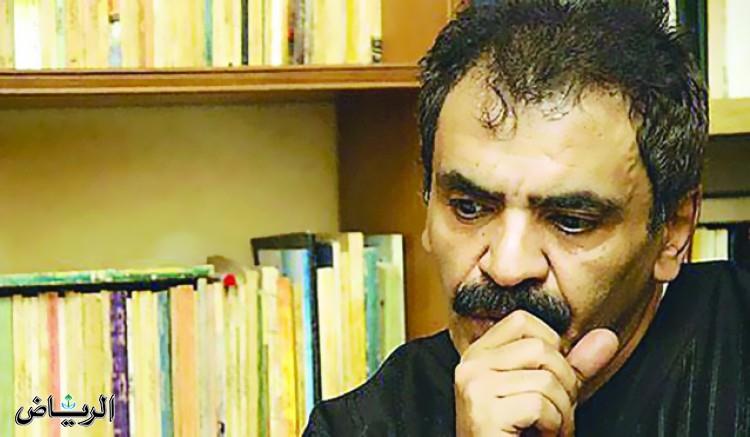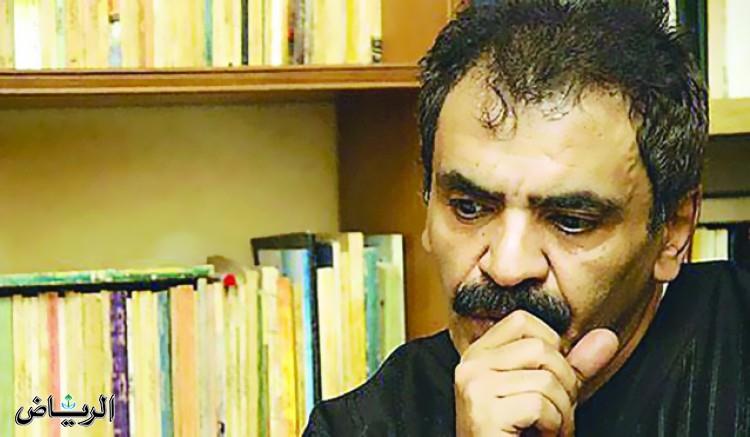
تكتنف قصيدة الشاعر محمد الثبيتي مسحة حنين شفافة إلى المكان، باعتباره الرحم الرمزي والمستقر الأخير لكينونة الشاعر الباحث عن الدفء والألفة والأنس، وهو ما يجعل المكان في مدونته يخسر هويته الهندسية الفيزيائيّة الإقليدية التي تجعله وعاء أجوف تحدّه الأبعاد وتسيّجه الحدود، وبهذا الخسران يكتسب طابعه الرمزيّ والذاتي، ويلتبس بتجربة الشاعر فيغدو ذلك المستقر الرحم الذي يقضي الشاعر في نشدانه العمر الشعري كله، في محاولة منه لإبعاد الوحشة التي تتراءى كالذكريات المُسنة. ذكريات تتقادم أوقاتها كلما ابتعد الشاعر عن مكان البدايات الأولى، وكأن روحه مغروسة في تربته كالشجرة التي تتشبث بجذورها في شرايين الأرض التي انشق عنها إيقاع أشعاره المترقرق في الصحارى، ترقرق ريح على قافية.
فالمكان هو الملاذ الأول والأخير للروح التي تتقاذفها طرقات الضياع البعيدة، وإذا الحنين إلى المكان، هو توق إلى الماضي البعيد بكل ذكرياته المحمولة كالنعوش على أكتاف الغرباء إلى مقبرة الحياة التي تولد كل يوم ولا تبلى مراثيها، وعلى هذا النحو ندرك أن الفضاء في شعر الثبيتي لا يقبع في مرمى العيان وإنما هو فضاء لا مرئي لا ندركه إلا من خلال جغرافية النفس وما يعتريها من أشواق ورغبات، وإذا كانت أفضية النفس لا تدرك إلا من خلال ما نفعله في حياتنا اليوميّة فإنّ هذه الجغرافية تدرك في مدوّنة الثبيتي من خلال جدل الحجارة والعبارة.
ويؤكّد لنا الشاعر دائما أن المكان قطعة من لحم ودم، وما فيه قلب يتدفق بالدم باستمرار ليعيد إليه الحياة التي انصرمت، يقول الشاعر:
وأفقت من تعب القرى/
فإذا المدينة شارع قفر/
ونافذة تطل على السماء/
وأفقت من وطني
فكانت حمرة الأوقات مسدلة/
وكان الحزن متسعا لأن نبكي/
فيغلبنا النشيد/
وتسيل أغنية بشارعنا الجديْد.
وحين يكسو اللحم الحجارة ويتدفق في شريانها الدمّ يغدو المكان لامكانا، فتنبجس رؤية شعريّة "ثبيتيّة" تجاوز بالقارئ عتبة الإدراك الحسيّ للأشياء، فإذا المكان يتحوّل من المستوى المرئي إلى اللامرئيّ فإذا هو عوالم سريّة ممكنة تتخطى عاطفة الاغتراب التي تقترن عادة بتلك المفارقة المرة التي ترهق إحساس الشاعر، هي المقارنة بين مناخ القرى والمدينة التي تمثل صورة الاغتراب بالنسبة إلى صوت الشاعر الراخم في إنشاد مراثيه.
فكأن الشاعر وريث معلقة الغربة في مطلعها الطللي المحمول على الحسرات والشجن والندب الراثي لطفولة القرى القديمة وشيخوخة المدينة الحديثة في تطاولها العمراني الذي يصل إلى مصاف السحاب، إلا أن نفس الشاعر التي ترزح تحت عبء هذا الشعور الثقيل بالاغتراب، ترجع القهقرى إلى مفردات الطبيعة والمكان الأول، كي تحنو على محنتها وتضمد جراحها النازفة، فالشاعر يشكو انحسار الفضاء الخاص الحميمي أمام اتّساع الفضاء العمومي وهو في الحقيقة أمر مردود إلى سطوة مجتمعات المدنيّة الحديثة التي جدّت في انتزاع الفرد من عوالمه الخاصّة لتؤثّث به أفضيّة الاستهلاك، إلاّ أنّ الثبيتي يواجه فعل التضييق هذا بالرحيل والسفر، فتغدو حركة المرور عبر المسالك والممالك برّا ولملة شتات الأشرعة بحرا شبيهة بالرحلة الروحيّة أو بالأحرى بالحجّ الحقلي نحو أعماق الذات وتفاصيلها البعيدة، يقول الشاعر:
وأمرّ ما بين المسالك والممالك/
حيث لا يمٌّ يلمُّ شتات أشرعتي/
ولا أفق يضمُ نثار أجنحتي/
ولا شجر يلوذ به حمامي/
وأجوب بيداء الدجى/
حتى تباكرني صباحات الحِجَا/
أرقاً وظامي.
إن افتقار روح الشاعر إلى الأنس والاخضرار تحيله إلى مخاطبة المكان القديم حتى لو كان صورة صخرية تخددها الرياح، أو تجريد جريح للقفار، لأن برهة وردية تتفتح في إيقاع الشاعر ونبرته الحزينة وداخل سيرورة الإنشاء التصويري حين يأتي ذكر الديار المكان المفقود أو المحلوم به عبر استحضار مكونات المكان الأول وإضاءته بضوء الشعر المجروح على المستوى الحلمي. ومن ثم نعدّ هذا الاستحضار فعلا شعريّا مؤسّسا للفضاء التخييليّ، فرمزية النخيل والبيداء وما تحيل إليه المسالك والممالك ليست إلا نشداناً للخلاص من المكان المغلق والانتماء إلى الإيقاع الحركي للحياة، وبالتالي الخلاص من قبضة اليباس والتصحر الروحي، ويبدو أن الأماكن لا تموت حتى ولو تصرمت أوقاتها وترحّل عنها ساكنوها، بل كلما أوغل ساكنوها بالرحيل عادت تصاويرها إلى خيال الشاعر، وانتظمت في شريط حريري من الرموز يمرُّ عبر شاشة الذاكرة، وكل ظهور لصورها المفقودة هو نوع من وصل خيوط القطيعة التي تتكرر عبر صحراء الشاعر بالرحيل والهجران، يقول:
متى ترحل القافلة/
سترحل تواً/
فهيئ لنفسك زادك والراحلة/
لقد نامت القافلة/
ونامت لها أعين الراحلين/
وأقفر وجه الطريق من السابلة.
هو هاجس الرحيل عن المكان أو التغريب الذي يصيبه بفعل التحديث والحضارة، هو الذي يهدد تماسك كينونة الشاعر واستقرارها.
أما ملاحقة الزمن الهارب، فتتمثل بقوة في قصائد الشاعر التي تمثل راسب النزوع لكل ما هو تراثي يتبين ذلك من سؤال الشاعر عن القافلة والراحلة الذي هو بمثابة ردّ فعله الذاتي على مصادر التخوّف من المجهول وسرعة زوال الإنسان، فكأن الراحلة هي أمان الشاعر من أهل الأرض، وتهيئة الراحلة وسيلة دفاعية أنتجتها القصيدة العربية في لحظات ازدهارها وتوهجها وكمالها، ولعلّ تكرار هذه التيمة (الغرض) يعبّر عن رحلة القصيدة ذاتها والركبان تجول بها من ربض إلى آخر لكنّ الحنين ما يلبث أن يعاودها إلى رحمها الأوّل.
هناك دائما غائب في نص الثبيتي، وهذا الغائب المضمر يحرك حجرة الحنين إلى المناجاة والإنشاد، يقول:
هجرناها/
ديار سلمى وملعبها ودنياها/
واخضلال أغانيها/
التي كانت ترددها/
والنغمة البكر/
كم نحن افتقدناها.
إن الحنين بحسّه الغنائي وإشباعه الشجي، يُلطّفُ تباريحَ الشوق ويجعلها مغنّاة وموقّعة، وهي السمة الأهم في الشعر الجميل، وفي تجربة الشاعر محمد الثبيتي.
هكذا تجول بنا قصائد الثبيتي بين أفضيّة متعدّدة، من امتداد إلى آخر، ما يوقفنا على شعريّة خاصّة نسمها بشعرية الفضاء في شعر الثبيتي لا سيّما أنّه جعل من القصيدة الواحدة فضاء أو بالأحرى امتدادا، ما إن يحلّ فيه ويستقرّ حتّى تطوّح به عصا الترحال نحو امتداد آخر وتتحوّل الحجارة تحت وقع حجرة الحنين وجدل القرية والمدينة والديار العامر والأفضية المقفرة، إلى عبارة يجد فيها الشاعر ملاذه فتنشأ الألفة بين الفضاء الوجداني والفضاء الشعري وتغدو القصيدة الواحدة في مدوّنة الثبيتي دورة من دورات مسار خلاّق تتحوّل فيه الحجارة إلى عبارة تفيض على كينونة الثبيتي الشاعر- الإنسان.