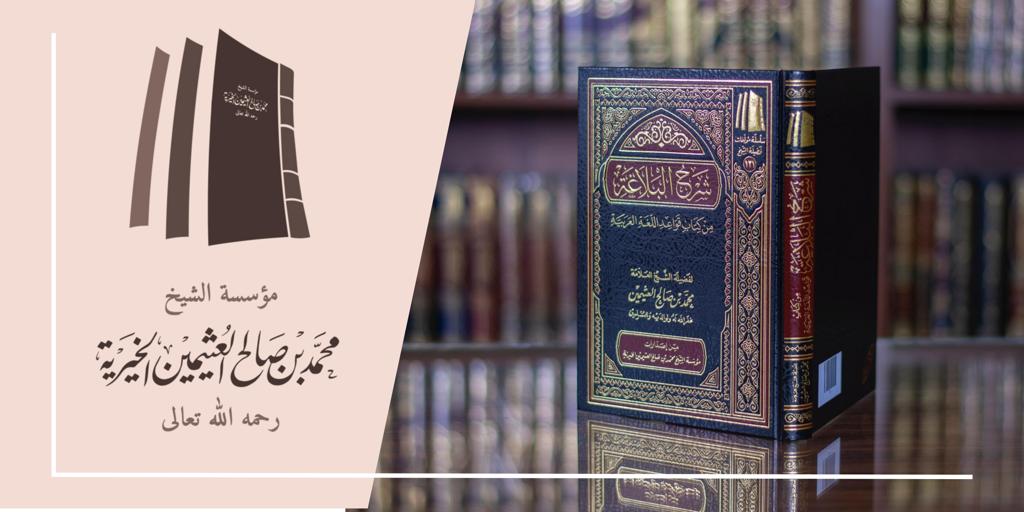عطفاً على ما ذكرته في المقال السابق؛ أقول: لقد تعرفت على مصر كلها من خلال بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بداية التسعينيات من القرن الميلادي المنصرم. وإذا كان السيكولوجيون يقولون إن الانطباع الأول هو الذي يبقى في الذاكرة، ويصنع المعالم الأساسية للتصور الأوليّ، فإن لقائي الأول بمصر، اللقاء المادي المباشر الذي أعقب اللقاء اللاّمباشر: الأدبي/ الفكري، حدث في صالات وساحات معرض القاهرة للكتاب.
لم أحضر أية فعالية من الفعاليات الثقافية التي كانت تقام على هامش المعرض (وقد ندمت على ذلك فيما بعد)، إذ كان الكتاب هو هدفي الأول والأخير من المعرض، وكنت أخرج منهكا في حدود الخامسة أو السادسة مساء.
وإذا كنت قد اقتطعت يومين أو ثلاثة لزيارة معالم القاهرة: الأهرام والحسين والأزهر والمقطم والقلعة وحلوان وبرج القاهرة..إلخ، فإن سبعة أيام كاملة كانت من نصيب المعرض الذي وجدت فيه كثيرا مما كنت أبحث عنه في سالف الأيام.
لم أحضر أية فعالية من الفعاليات الثقافية التي كانت تقام على هامش المعرض (وقد ندمت على ذلك فيما بعد)، إذ كان الكتاب هو هدفي الأول والأخير من المعرض، وكنت أخرج منهكا في حدود الخامسة أو السادسة مساء.
وفي إحدى الأمسيات زرت المكتبات الموجودة في ميدان طلعت حرب والشوارع المتفرعة منه (منطقة وسط البلد)، بعد أن ذكر لي أحد المصريين المتسوقين أهمية زيارتها؛ لأنها تتوفر على بعض الكتب التي لا يُحضرها أصحابها إلى المعرض لضعف رواجها. وفعلا، وجدت بعض ما أعتقد أنه مهم بالنسبة لي، لا لشيء إلا لكونه يقع في دائرة الممنوع المرغوب، وإلا فقيمته المعرفية قد لا تستحق كل ذلك العناء.
كانت المعاناة الحقيقية في معرض القاهرة للكتاب تكمن في عدم توفر عربات تضع فيها الكتب (وهذا حدث في بدايات معرض الرياض). قد يكون هذا نابعا من سوء التنظيم، وقد يكون بسبب أن جماهير المعرض - رغم كثرتها - لا تشتري الكتب بهذه الأعداد التي تتجاوز خانة العشرات إلى خانة المئات.
نادرا ما كنت أشاهد في معرض القاهرة من يحمل بيديه عشرة أكياس من الكتب، وتتمزق أصابع يديه وهو يقطع بها المسافة الطويلة التي تفصل بين صالات الكتب وبوابات المعرض؛ حيث تقف سيارات الأجرة، التي ما أن تصل إليها حتى تحس بأنك وصلت إلى شاطئ الأمان!.
من يعاني هذه المعاناة هم قلة من زائري المعرض، وفي الغالب هم من خارج مصر، ممن يرون المعرض فرصة سنوية لتعويض أشهر الحرمان. ولا شك أن القائمين على المعرض لن يلحظوا معاناة هذا (النادر)، وسيكون اهتمامهم منصبا على ما يهم عشرات الألوف من جماهير المعرض الذين يخرجون بكتابين أو ثلاثة، أو ببضعة كتب، وقد يخرجون بلا شيء في بعض الأحيان.
كانت مدة مكوثي في المعرض تبدأ من الساعة العاشرة صباحا، إلى الخامسة أو السادسة مساء. وبما أن محل إقامتي في الدقي، وهي منطقة بعيدة عن أرض المعارض التي تقع على طريق المطار، فقد كنت أخرج من سكني في حدود التاسعة صباحا، بعد أن أتناول وجبة إفطار خفيفة. ولهذا، كنت أضطر إلى تناول أي شيء في حدود الثانية أو الثالثة بعد الظهر؛ لأستعيد نشاطي، خاصة وأني أقضي كل هذه الساعات واقفا، إلا في لحظات استثنائية، أجثو فيها على ركبتي لاستعراض بعض الكتب الملقاة على الرصيف.
في تلك السنوات لم تكن تتوفر مطاعم حقيقية داخل المعرض. ولهذا كنت آكل مضطرا، وعلى مضض، ورغم "وسوستي" في هذا المجال من بائعي (سندوتشات الكبدة)، أولئك الذين يقفون بعرباتهم الصغيرة على الأرصفة داخل المعرض. وبهذه الوجبة الدسمة!؛ مع كوب من الشاي الأسود المعتق الذي تَذهب حلاوتُه الشديدة بمرارته، كنت أستعيد نشاطي كاملا، وأبدأ من جديد في التنقيب وسط الكتب المستعملة التي كانت تملأ بعض الساحات، معروضة بأبخس الأثمان؛ فكانت تمثل إغراء، وأي إغراء!.
من المواقف التي لا تزال حاضرة في ذاكرتي، موقف حدث لي مع أحد الأساتذة التونسيين. ففي أحد أيام المعرض وقفت على مكتبة من هذه المكتبات (مكتبات الكتاب المستعمل)، وكانت الكتب تتراكم فيها أكثر من غيرها. وهذا أغراني بالبحث فيها، وبدأت أعثر على كثير مما أظنه جديرا بالاقتناء، وكان كل كتاب أكتشفه يُغريني بمزيد من البحث وسط هذا الركام المُغبر من الكتب. وبعد عناء ثلاث ساعات تقريبا، كنت قد وضعت حوالي عشرين كتابا بعضها فوق بعض؛ بوصفها أصبحت من مقتنياتي حتى قبل أن أدفع ثمنها. لكن، وبينما كنت منهمكا في التنقيب، لاحظت رجلا أنيقا يضع يده عليها، ويبدأ في استعراضها، ثم يعيد ترتيبها وكأنه يختارها لنفسه. كانت عيني عليه، وعيني الأخرى تبحث فيما هو أمامي. وبعد أن أحسست بالخطر على ثروتي الصغيرة؛ تركز اهتمامي عليه، وكنت أنتظر اللحظة الحاسمة التي تستوجب التدخل الحاسم.
أتت اللحظة الحاسمة، عندما اختار كل كتبي التي اخترتها. لقد وضعها بين يديه مغتبطا ومعتقدا أنه ظفر بها بجهده وبحظه، ثم احتضنها يريد حملها إلى البائع ليدفع ثمنها، ويحقق ملكيته لها. وهنا، ورغم حيائي منه، أمسكت به، وقلت له في توتر ظاهر - وكأني أنقذ جواهري من يَدي لص: هذه لي. ابتسم، وقال بأدب جمّ: آسف، لم أعرف، واضح أن اهتماماتك أدبية ونقدية. قلت: نعم، أنا مهتم بالأدب أصلا، ثم أنا طالب في كلية اللغة العربية. وهنا، أثنى على اختياري، ثم أدخل يده في جيبه، وأخرج (كرتا تعريفيا) مكتوبا عليه د.عمر مقداد الجمني، وعرفني بنفسه أنه ناقد أدبي من تونس، وبدأ يثني على بعض النقاد لدينا، وذكر أنه تعرف عليهم من إصدارات النادي الأدبي بجدة، وخاصة مجلة (علامات)، ثم أشاد بدور نادي جدة الأدبي، متوهما أنه النادي الوحيد لدينا، فلما ذكرت له وجود أمثاله في كل منطقة؛ تعجب وقال: إذن، لماذا لا نرى أي شيء من جهودهم؟!.
لم نتحدث أكثر من ربع ساعة، وكان في غاية التهذيب، بل كان يتحدث معي عن الأدب وهمومه بابتهاج واضح. ولهذا أحسست أن من لوازم التقدير لمن هو في مكان أساتذتي علما وسنا، أن أترك له الكتب التي اخترتها عن طيب خاطر. لكن، آنذاك، لم تطب نفسي بمثل هذا الكرم. وبهذا كنت بخيلا؛ ولم أندم. وإلى اليوم، ورغم إحساسي بالواجب التقديري تجاهه، لا أتوقع أنني كنت سأخلو من إحساس شديد بالندم لو تركتها له، فقد كان إغراء اقتنائها أكبر من أي إحساس بالواجب.
كنت قد حددت أن أعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء المعرض بيومين. بعد انتهاء المعرض كنت قد ملأت بالكتب أربعة كراتين وحقيبتين من الحقائب التي تُعلق على الكتف، والتي تتسع الواحدة منها لما يناهز الثلاثين كتابا. في غمرة تلك اللحظات الساحرة، لم تخطر مسألة الوزن على بالي إطلاقا، بل عندما أتذكر تلك الذكريات، أظن أنني لم أعرف عنها شيئا، إذ كانت كل رحلاتي السابقة رحلات داخلية، وكنت لا أحمل أكثر من حقيبة اليد. كنت رأيت بعضهم في الرحلات السابقة يضع حقائبه الكبيرة في الشحن، ويحمل المتوسطة والصغيرة معه، ولم أرَ أحدا يدفع مالا. ومن هنا كنت أتخيل أنك كراكب مستضاف، يحق لك أن تحمل كل حقائبك، وإلا فأين تضعها؟
لم أتخيل أن ثمة مبلغا إضافيا يُدفع، ولا أين يدفع. وكانت خطتي المبدئية أن أضع الكراتين الأربعة في الشحن، والحقيبتين - إضافة إلى حقيبة الملابس الصغيرة - معي؛ رغم ثقلهما الشديد؛ لأني وضعت فيهما أهم الكتب التي لا آمن عليها عندما تغيب عن عيني. أوليتُ الحقيبتين اهتماما زائدا؛ لأني كنت سأحس بشيء غير قليل من الذعر، وربما الهلع، لو تركتهما تذهبان بعيدا عني؛ على أمل اللقاء بهما في مطار الوصول. كنت أتخيّل احتمال فقدهما، بعد أن تتقاذفهما عشرات الأيدي تائهتين بين عشرات الألوف من الحقائب والبضائع. وهكذا، لا أمان يصل بالقلب إلى درجة الاطمئنان 100%؛ إلا بأن أحملهما بيدي، وأرعاهما بعيني، حتى ولو أثقلتا الكاهل وأوهنتا الساعد.
وضعت التذكرة وجواز السفر أمام موظف الخطوط؛ للحصول على كرت صعود الطائرة، فطلب مني وضع الكراتين والحقائب التي في العربة على أول السير المتحرك. وضعتها وأبقيت الحقيبتين معي. نظر إلي وقال: ضع الحقيبتين أيضا. وضعتهما، فقال لي: لديك زيادة وزن 85 كيلو. قلت بحيرة ظاهرة - إذ لم يكن لدي خلفية عن حدود الوزن -: لماذا؟
وماذا أفعل، ما الحل؟، قال: تدفع ثمن الوزن الزائد عند ذلك الموظف، وأشار إلى موظف بالقرب منه. قلت: كم أدفع؟؛ فذكر مبلغا يتجاوز 2000 جنيه!. بمجرد أن ذكر 2000 أمسك وعيي بهذا الرقم وأفلت بقية الرقم، فقد كان هذا المبلغ كافيا لإحداث الصدمة المفاجئة. بمجرد أن تلفظ بالمبلغ؛ أحسست بما يشبه الاختناق، أحسست بأنني في تلك اللحظة أخسر كل شيء؛ إذ لم يكن معي أكثر من 400 جنيه، وهذا يعني أنني لن أستطيع أخذ أحلامي معي، ولا العيش معها في لحظات انتشاء لا أعرف لها حدودا ولا أمدا. بكل مشاعر الإحباط واليأس، أحسست أني لن أستطيع مكافأة نفسي على تعب أسبوع كامل ظننت أنني كنت فيه محظوظا بما ظفرت به بعد طول عناء.
مرّت بضع ثوانٍ فاصلة، تذكرت فيها بشكل مكثف وحاد ومُمِضّ؛ كيف كنت أحلم بهذه الرحلة منذ سمعت بمعرض الكتاب، تذكرت الساعات الطوال التي قضيتها في صالات وساحات المعرض، تذكرت ألمَ ثقل أكياس الكتب على أطراف أصابع يدي وعلى ذراعي، تذكرت تورّم أصابعي وأنا أحملها من الصالات إلى بوابة المعرض، وتوقفي كل 50 مترا تقريبا؛ لأنفض أصابعي حتى لا ينحبس الدم في أطرافها، تذكرت فرحتي بين الحين والآخر عندما أجد مَن أستأجره من عمال المعرض ليحمل بعضها معي، تذكرت جهدي في ترتيبها وتغليفها وحملها من السكن إلى سيارة الأجرة، ومن سيارة الأجرة إلى عربات المطار، والعبور بها من نقاط التفتيش، والإجابات المتكررة عن أسئلة هذا وذاك، وفي كل خطوة من هذه الخطوات تدفع لهذا وترضي هذا..إلخ، تذكرت نفسي عائدا لمنزلي بالرايات المنكسة، مكللا بالهزائم المعنوية، استشعرت هول الانكسار الذي سأشعر به أمام نفسي وأنا أدخل غرفتي بالحقيبة التي خرجت بها منها، تذكرت كيف سأواجه الرفوف الفارغة التي كنت أحلم بها لهذه الكتب.. إلخ، حتى بلغ اليأس مداه.
أخرجت المبلغ القليل من جيبي، وقلت لموظف الخطوط: لم يبق معي إلا هذا، فكيف أتصرف. قال: خذ المبلغ من أي أحد من ركاب الرحلة، ثم سدده له بعد وصولك؟ قلت: لا أعرف أحدا. ثم، وفيما يشبه انتحار اليائسين، قلت له بلغة حاسمة وقاطعة كحد السيف، وكأني أحرق كل سُفني من ورائي: انظر، ليس لدي إلا هذا المبلغ، وبه سآخذ الحقيبتين، أما الكراتين الأربعة، فسأتركها هنا...!.
(وللحديث بقية)
ma573573@hotmail.com