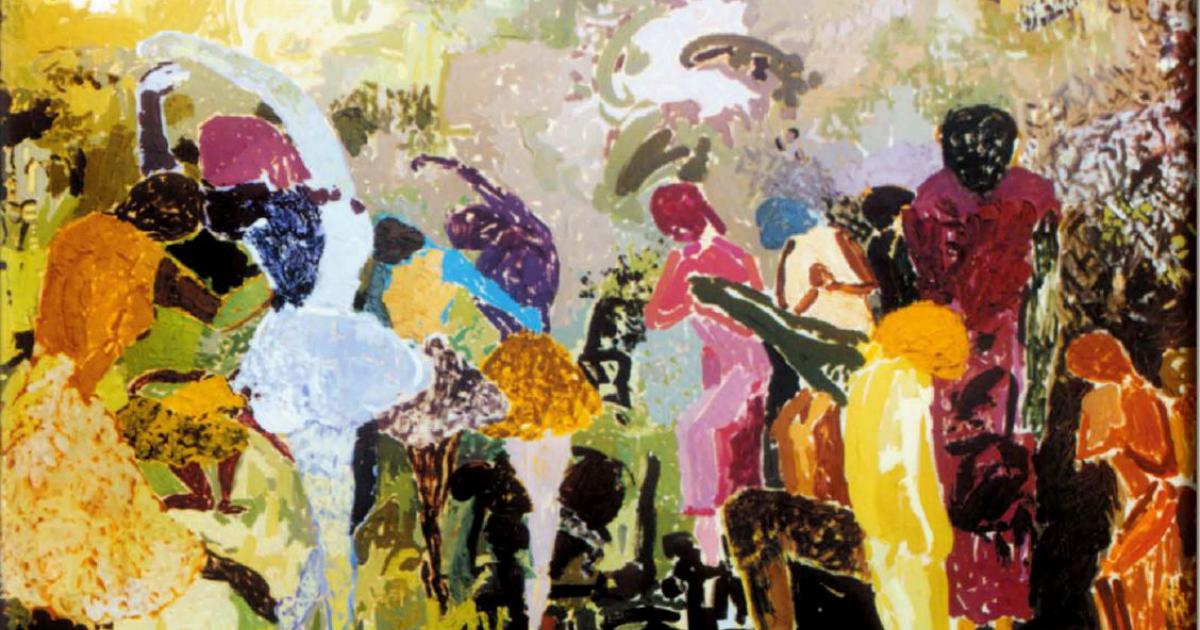النقد الأدبي في المغرب لم يُولِ القصة القصيرة ما تستحقه من عناية وتمحيص، خلا ما هو مبعثر في الصحف والمجلات من كتابات انطباعية، ولم يأخذ بمهمة تأصيل هذا الفن الأدبي والبحث عن جذوره التي ستكبر وتينع، فيما بعد، لتقدم أنضج الثمار، انطلاقا من هذه الرؤية تأتي دراسة الروائي والناقد د.أحمد المديني 'فن القصة القصيرة بالمغرب' بحثا وتحليلا لأسس ومصادر نشأته الأولى وملامح تطورات هذا الفن على مدار ثلاث عقود، وصولًا إلى المرحلة الحاسمة التي تبدأ مع مَطلع الستينيات؛ حيث أفصحت القصة القصيرة عن مَسالك فنية ومضمونية متعدِّدة تتضمَّن اتجاهات تمثِّل وَحدة الشكل والمضمون.
الكتابه الصادر عن مؤسسة هنداوي جاء في أربعة أبواب ضمت 17 فصلا ، وذلك فضلا عن (ملحق) دليل القصاصين، يقول المديني "اتجه القصد في هذه الدراسة إلى تحصيل نشأة فن القصة القصيرة، ظاهرة، وأسبابًا، ومكونات، فيكون هذا العمل بمثابة القاعدة يقوم عليها باقي البناء. من مواصلة النظر في مرحلة النشأة وتتبع وجوه تبلورها، وأنساق سيرها تبدأ ملامح التطوُّر في الظهور وتأخذ في الانسياب، ويشرع في وضع اليد على سمات هذا التطور إلى أن نصل إلى المرحلة الحاسمة لما ظهر لي أنه منعطف وانتهاج لخط التطور العميق، كما سيبدأ مع مطلع الستينيات، ليستمر، بعد ذلك، في آفاق واسعة. وقد تم حصر هذا التطور، والبحث عن أسبابه، مثلما ظهرت في الواقع المادي، أو حملتها رياح التأثير والفعل الخارجي، منقحة ومكملة، كما تم استقصاء عناصره حيثما ظهرت في النسيج الجمالي أو تقنية القص وطرق العرض الفني أو محتوى المادة القصصية وما بشرت به من معاني وقيم أو انتقدته من ضروب الفهم والسلوك لدى الأفراد أو في الظواهر التي انشغلت بها القصة القصيرة. وقد رأيت أن المادة القصصية، لفترة الستينيات، وعند القصاصين الذين انتظموا في كتابتها، قد سلكت مسالك فنية ومضمونية متعددة، أو أنها قابلة للخضوع والتعدد، ففرزتها فيما لمست أنها تمثِّله من اتجاهات تمثل وحدة في الشكل والمضمون؛ أي تقوم على أساسٍ من تجانُس العناصر والأدوات الفنية المستخدمة، وكذا من تماثل في الرؤية المطروقة. وهكذا، فإنني أعتقد أن إعطاء صفة أو تسمية الاتجاه ليست إسقاطًا أو وضعًا مسبقًا ولكنها تعني الوحدة، أو على الأقل، التقارب في الرؤية الفنية والفكرية.
ويتابع "تتم هذه العملية متوافقة مع التسلسل الزمني لقصص الستينيات، على الأغلب، بما يجعل بروز الاتجاهات وتواترها يجري على نسق زمني متتابع، وإن كانت الفواصل فيه غير متباعدة أو شديدة السعة، وخلال الرصد والتصنيف والتقييم تزداد أمامنا خطوط التطوُّر وملامحه اتضاحًا، ويكون رسم الاتجاه، ومن شارك فيه، والقيم الأساسية المتولدة داخله، جزءًا من توضيح التطور العام الذي عرفته القصة القصيرة بالمغرب في أنسجتها الفنية وشواغلها المضمونية، وبذلك فهي عملية تعتمد التقابل والالتحام الحميمين وتستبعد الفصل والعزل المتعسفين. وإن هذه الرسالة، التي اعتمدت القصة القصيرة المغربية موضوعًا لها، كان لا بد أن تُحصر في إطار زمني محدَّد. وقد وجهت، في هذا الصدد، بمسألة تحديد المسافة التي ستمتد فيها الدراسة، وبما أنني رغبت في إنجاز عمل يكون من مهامه الأولى تأصيل جنس أدبي حديث، فقد كان لا بد من الشروع من البدايات حتى يستقيم لنا معرفة الأصول، تربةً ومنبتًا، ويكون تعرُّفنا على الخطوات اللاحقة والتطوُّر المحسوس وشبح الصلة بما قبله فما بعده".
يرى المديني إن الربع الأخير من القرن التاسع عشر هو المدخل الطبيعي لمعرفة المغرب الحديث، في جميع ميادينه، وإبرام معاهدة الحماية في 1912م ستكون تتويجًا لإطلاق يد فرنسا وحلفائها في ثروات المغرب والتحكم في سيادته، وحركة بن عبدالكريم تجسيم فعلي لإرادة رفض المستعمر في شمال المغرب ودليل حيوي على استمرار وهج النضال الشعبي. أما الظهير البربري لسنة 1930م فقد كان بداية قاصمة الظهر للمستعمر الفرنسي، ينطلق إثره المد الوطني، عفويًّا مرتبكًا، ثم منتظمًا، ليصبح منسقًا في حركة مطلبية تعلن عن نفسها في 1944م، ويتواصل الصدام الوطني والاستعماري عبر حلقات وأشكال مختلفة ليفرز المحصلة الأولى وهي استقلال 1956م، ثم بعد هذا الصدام تبدأ المجابهة بين الغانمين من الاستقلال والمسلوبي الحقوق من عامة المواطنين، وهي مجابهة انطلقت من ذلك التاريخ وما تزال تفعل فعلها إلى وقتنا الراهن. داخل هذه الشبكة التاريخية وفي إطار بيئة ثقافية تقليدية، مرتكنة إلى الماضي متوجسة من الحاضر، انتفض الفن القصصي شبحًا، غائر الملامح إن لم نقل عديمها، في مساحة من الكتابة الشعرية والنثرية التقليدية بالأساليب والمعاني والقيم التي يتضمنها التراث الكلاسيكي.
ويتساءل: هل كانت هذه الانتفاضة من عدم أو وجدت بعض ما ولدها ودفع إليها في المحيط الأدبي؟. ويقول "إزاء هذا السؤال امتد رأينا الذي يذهب إلى أن الفن القصصي في المغرب، شأنه في المشرق، ظهر منبت الجذور، ومن أين له عكس ذلك؟ وإن الأخبار والحكايات ومختلف الكتابات التي تتوفر على العنصر الحكائي، هذه كلها، إلى جانب المقامة، أيضًا، لم تفرز الفن القصصي، عندنا، كما نعرفه بأصوله وعناصره الفنية. وإن هذا الرأي يجعل الباحث يتلمس ويحاول أن يدرك الأصول والقواعد الفنية التي قام عليها هذا الجنس الأدبي، والتي لا بد من الوفاء لها واستيعابها، وإلا أخذت الكتابة نحوًا شططًا ومن هنا فإن استعراض القيم الفنية والفكرية لفن القصة القصيرة بعد، ولا ريب، أمرًا مطلوبًا يستند عليه في معرفة الأدوات التي ستتخذ للتقويم والتقييم. والقصة القصيرة في أبسط تعريف لها هي اقتطاع لحظة عرضية من حياة فرد أو مجموعة من الأفراد، والعمل على إبراز أو اكتشاف عنصر الصدم أو التضاد أو المفارقة — قطعة نثرية تحتفل، بالأساس، بأزمة الفرد، في منطلقها وتعقدها وانفراجها يستخدم القاص لذلك عناصر السرد والوصف والحوار، وتمثل الشخصية عنصرًا مركزيًّا في تكوينها وهي تعتمد الإيحاء والتلميح وتتجنب الأصوات المرتفعة.
ويشير إلى أن القصة القصيرة الأولى جاءت بعيدة عن هذا كله، ولم تملك هذا التصور، فقد كانت الأخبار والحكايات القديمة تروى، ولا بد من استخلاص العبرة منها، فجاء كتابنا وهم في تمزق وتعثر بين قديم ملحاح وحديث مستورد ما يزال مهيض الجناح وإن توجيه العبرة والوعظ هي الخدمة الجليلة التي لا مناص من أدائها، ولأن القص الفني لم يكن هدفًا متقصدًا ولا مشروعًا سديدًا فإن الشكل الأول الذي ظهر به هذا القص في الأدب المغربي الحديث هو ما اصطلحنا على تسميته ﺑ «المقالة القصصية»، أي، هذا النص النثري الذي يقع وسطًا بين المقالة والأقصوصة يستخدم إمكانيتهما، معًا، بصورة شائهة، أو على الأقل متذبذبة وغير واعية وتكون الحصيلة إننا أمام شكل هجين يتلمس طريق القص الفني فلا يطاله فيما يتهافت فيه الأسلوب المقالي ومقاصده. لكن هذه الصورة الأولى للقص ما كان ليغمط حقها أو تضيع مناقبيتها، وهي قائمة، بالفعل، فقد كان للمقالة القصصية ولمن سعوا لكتابتها، في الأغراض المختلفة، التي توجهوا إليها، قصب السبق وفضل الريادة ومحمدة اقتحام المجهول وكتابها مهدوا الطريق لغيرهم وبمحاولاتهم القصصية الأولى التي تبعثرت بين أواخر الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات يبدأ فن القصة القصيرة في الأدب المغربي، بدايته البدائية، العفوية، المتعثرة تلك، نعم، لا تعد شيئًا إذا ما قيست إلى ما وصل إليه تطور هذا الفن وتشعب فيه من مسالك، ولكنها بالنسبة للباحث نقطة انطلاق وعلامة رائدة."
ويوضح "حين تأتي المرحلة الثانية من الكتابة القصصية القصيرة التي أسميناها "الصورة القصصية" فإنها لا تكون، بالضرورة، تطويرًا جذريًّا بحيث تتخذ شكل قطيعة مع النهج القصصي البدائي، من جهة، وهي في الآن عينه، ليست متأخرة عنها زمنيًا بحيث نستطيع القول بوجود تسلسل زمني بين الشكلين. إن مجهود الصورة القصصية الأساسي انصب على محاولة تفكيك الشكل الهجين السابق وتنحية العناصر المقالية من المقالة القصصية، بالمحتويات المتباينة التي اشتملت عليها. فهي، إذن، عملية صقل وتشذيب، ولكن، دائمًا، في خط السعي والمحاولة، وهي هنا محاولة جادة، لأن القاص أخذ يلقي ببصره وحس تطلعه على مرمى رؤية محددة، نسبيًّا، قادرة على الانضباط، في حدود، داخل الإطار القصصي، ومحاور هذه الرؤية تتوزعها الذات والمجتمع والتاريخ، وقد ترتبك وتتزحزح لتتعامد فيها، هذه، جميعًا. إن القصد هنا ليس الوعظ أو الخطابة بل التقاط الصورة الدالة بنفسها وليس بإطلاق العنان لعقيرة الكاتب لتصرخ وتبلح بين السطور، وفوقها، ولكن بشيء هو كالحدث أو ما يشبهه وللشخصية القصصية، وهي تخرج من ذهن كاتبها ورؤيته المشوشة، تتجسد حية تحاول الجهر بصوتها الخاص بدلًا من الضياع في صوت القاص نفسه، وما دامت الغاية ريادة ومحاولة لاقتطاع لقطة أفقية وعمودية، في آنٍ واحد، وتعميمية، في كل حال، ثم لا تستطيع الانفلات من مزلق النبرة الخطابية وعسف الكتابة التقريرية وإيصال الغرض، أجل الغرض المستهدف، والحاضر بإلحاح في ذهن الكاتب، فإن الصورة القصصية، حينئذٍ تكون قد اقتطعت رقعتها الخاصة في المساحة القصصية الشاسعة ووجد بعض البون بينها وبين المقال القصصي أو القصة المقالية، ولكنها، في ذلك كله بقيت لا تملك خيوط القص الفني الكلاسيكي. إن شخصية وقصة "مجذوب زلاغ" لعبد الرحمن الفاسي خير حجة ومثال لما نذهب إليه.
ويؤكد أن التطور الذي لحق القص القصيرة في المغرب لم يكن، بالحتم، أكيد الارتباط بالأحداث أو التحولات التاريخية، على الرغم مما سيطرا، فيما بعد، من صميم التفاعل والترابط الجدلي بين الواقع والنص، لهذا فلم يكن ينتظر أن ينجم عن حصول المغرب، مثلًا، على استقلاله بروز ملامح تطور أو تجديد حاسمة تلحق المعمار القصصي أو مدار الكتابة القصصية، ولعلنا سنجانب الصواب ونطال محالًا لو توقعنا حدوث مثل هذا، لأنه، انطلاقًا من الاعتقاد الراسخ بالتفاعل الحي بين الواقع الفني والواقع الموضوعي، فإن المغرب لم يحصل على استقلال حقيقي ولكن على استقلال شكلي في إطار معاهدة إكس ليبان، والتي ظهر فيها شبه تفويت للسلطة، أجل، تبدلت الحالة الخارجية، ولكن البنيات والركائز والهياكل استمرت هي ذاتها، ومن الهيمنة الاستعمارية انتقل الاستغلال إلى حفدته ونوابه وإلى عناصر البرجوازية والإقطاع تحصد الفنيمة. لم تتزحزح علاقة النص بالواقع، تبعًا لهذا، وبالتالي، فإن ما كتب في السنوات المباشرة للاستقلال دار من حيث المحتوى على اجترار المضمون الوطني وتسجيل صفحات "البطولة"، أو في رصد النتوءات الأولى، التي أخذت تبرز على سطح الحياة اليومية للجماعات المغبونة، مما بدأ يمثل حلقة أولية في النقد الاجتماعي الذي ستخوضه القصة القصيرة عندنا، أو بعضًا من الهموم الذاتية للقاص، والتي راحت تتولد من انعدام التوافق مع الوسط الذي يعيش فيه. وقد كان هذا يقود، بطيئًا، إلى بروز الأزمة على صعيدي النص والمعاش، وانقشاع التضاد المخفي، وبداية ولادة اليد الصناع التي ستمتد لالتقاطه فيكون بذلك الدخول من الباب الواسع للفن القصصي القصير. وبما أنه البدء ليس غير، مع رصيد من التشذيب، لا يستهان به في تمثل في التخلص التدريجي من أوشاب النص السابق، فقد كانت مرحلة وسطى بين الصورة ومدخلًا للقصة القصيرة الفنية. ثم تنهض بعد ذلك، تدريجيًّا، وبالتعاقب، الأسس والحوافز والتي تجعل فن القصة القصيرة يولد الولادة الطبيعية والشرعية، وإذا كان جيل الخمسينيات في مصر هو الذي بلور الفن القصصي القصير بصورته الصحيحة، والجادة، والتي وضعت يدها على جوهر الفعل والعالم القصصيين، فإن جيل الستينيات أو بالأحرى كتاب الستينيات في المغرب، هم الذين قدحوا زناد الخلق القصصي وعبدوا طريقه، بالكيفية التي نقلته من البدائية والتشوش إلى بداية امتلاك الصنعة واتضاح الرؤية، الفنية والاجتماعية، معًا، ومن صعوبة المرأس إلى يسر التناول واحتذاء خطى التقعيد القصصي الكلاسيكي.