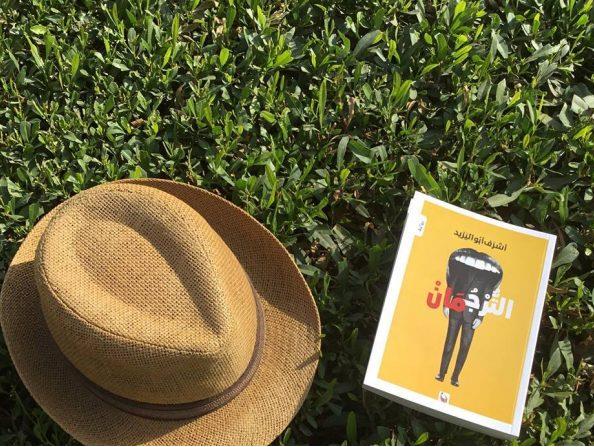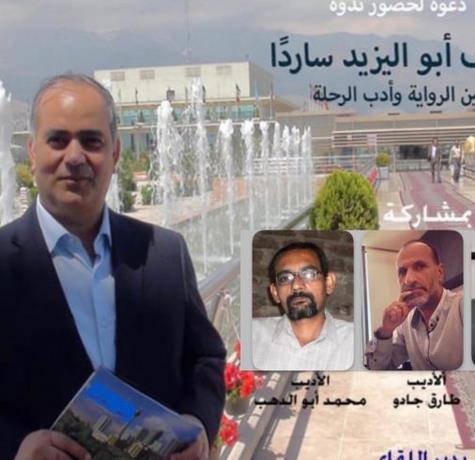هذه لعنة “مُصطفى سَنَدْ” يا تُرجمان. اللعنة التي تحل بمن يكسّر كلمتي. قلت لك يا بخت العارفين بالجميل، ولكن لم أرَ منك غير النكران والجحود. لقد زكّيتك عند المدير، فأنا أعرفه منذ كان يدرس الماجستير في القاهرة، وكلمتي مسموعة لديه، حتى لو سأل سواي، فستكون توصيتي هي المرجّحة، وما سبقتك إلى العمل في الكويت إلا امتنانا منه بفضلي في تقديمه إلى أساطين الأدب وعمداء الجامعات ومؤسسي المراكز البحثية.
قلت لك أن من يعصاني لن يصعد إلا على جثتي، نعم، حرفيا، على جثتي، والآن، أنت مجرد جثة، لا يمكنك حتى التحرك، ناهيك عن الصعود.
تذكر أني قلت لك إن هناك كنزا كبيرا اسمه لجان التحكيم، وأننا يمكن أن نتفق معا على عدة أسماء، نشكِّل منها لجانا وهمية، سترضى بالفتات، ونأكل نحن الشهد، وهكذا نختصر سنوات العمر الضائعة هنا … لكنك عملت لي فيها شريفا، وقلت لي أن هذا أسلوب الوضعاء.
عذرتك، فأنت لم تعمل بالصحافة الحقيقية في مصر، لكنني ابن المؤسسات هناك، وأعرف مَنْ يكتب لمَنْ، وبكم. وأعرف أن لدينا في مصر كتاب صحف عدد محرري زواياهم أكثر من عدد قرائها. ليس كل الكتاب مثل “طارق البشري” و”جلال أمين” و”محمد حسنين هيكل”، وجبال الورق تحتاج إلى بحار من الحبر، وأقلام لا ينفد مدادها.
بعد عام من مجيئك هاجر زميلنا “ناصر حسن” إلى ملبورن بعد حصوله على جواز السفر الأسترالي.
هل تعرف كيف استطاع تسديد فواتير مكتب المحامي المكلف بإعداد أوراقه على مدى ست سنوات كاملة؟ هل تدري من أين دبر نقود السفر وحكاية “اللاندنج” لأكثر من مرة، هو وزوجته وولده وابنته؟ هل تعتقد أن الراتب الذي نتقاضاه هنا يكفي الحياة الغالية التي يشتكي منها الكويتيون أنفسهم؟وهل توازي تلك الملاليم التي يدفعونها لنا جهدنا المبذول هنا؟ بالطبع لا!
من أجل هذا كله كان “ناصر حسن” يكتب يوميا أعمدة صحفية لأكثر من عشرة أسماء، منهم المحامي والنائب والتاجر … وفيهم الدكتورة والمهندسة والصحفية … جميعهم يريدون أن يتباهوا بأسمائهم وصورهم في الصحف اليومية، بل وكان يحرر جريدة المتأسلمين الجدد، من الصفحة الأولى للأخيرة، وهو لا يعرف عدد ركعات صلاة المغرب.
هذا زمن لم يعد الكيف فيه مهما يا ترجمان، وإنما الكم هو المهم. كان الدكتور “سلمان الإبراهيم” يعرف ما يفعله “ناصر حسن” في أوقات الدوام ولا يمت بصلة لأعمال المؤسسة، لكنه ما كان يلتفت إليه، لأنه كان يوكل له بين حين وآخر مهاما قذرة، لذلك أبقاه على الدكة، ليكون جاهزا حين يحتاجه لنزول الملعب.
ولكن مع الأعمدة الصحفية كان “ناصر حسن” يكتب أبحاث الدكتورة “نورية بدري”؛ أستاذة المسرح. لقد لجأتْ لي بعد سفر “ناصر حسن” المفاجيء للاستقرار في أستراليا، وكانت في حيرة شديدة، طمأنتُها وقلت لها أن الشخص المناسب موجود.
لم أكن أشك لحظة في قبولك المهمة، فقد كانت ستدفع لك ما يوازي راتب شهر مقابل كم ورقة فولسكاب، مذيلة بكم هامش توثيق، وأنت تحتاج لكل دينار، لأنك تتأنق في ملابسك الثمينة، وتسكن في السالمية الغالية، وتصرف الكثير على ابنتك المرفهة في مدرسة خاصة، لكنك حرنت، مثل جحش عنيد، وصفعتني بكلماتك:
“ما هذا الذي تسألني أن أفعل يا “درش”؟ أنا لا أبيع قلمي لأحد. أنت عرضت علي فكرة الأعمدة الصحفية قبل ذلك، ورفضت”.
حرفيا، عرفت أنك لن تظل هنا إلا على جثتي، لكنني اتخذت طريق اللين، وأنا أحاول ألا أغضب، وأسعى لكي لا ترفض، كنت أعلم أن باب الدكتورة “نورية”، لا شك، سيفتح أبوابا أخرى، وأن الخير سيعم ويخص:
“اسمع يا تُرجمان، الأعمدة الصحفية أمرها مختلف. أنا ساعتها وافقتك حين قلت إن الأمر لا يعنيك وأن هذه اليوميات ستشغلك عن مشروعاتك الكبرى، وأنها شؤون تافهة لمجتمع لا تخالطه، وأن عمل المؤسسة، وترجماتك، تشغل وقتك ليل نهار. لكن الأمر هنا مختلف. هذه ورقة نقدية في مؤتمر مسرح. أعرف أنها لن تأخذ منك غير هرش شعر رأسك دقائق، ولكن أعرف أيضا أنها ستفتح أمامك أبوابا كثيرة. ربما تجد نفسك عضو لجنة تحكيم هنا أو هناك. ومن يعرف، ربما فزتَ بجائزة في الترجمة، تكون محكّمتها الدكتورة نفسها. يا أخي شغّل مخك، وانظر إلى تجربة “ناصر حسن”، وتعلم”.
“يا “درش” افهمني؛ أنا لست “ناصر حسن”، وما رضي أن يفعله، لا يعنيني، وليس بالضرورة يرضيني، أو أكون مجبرا على فعله!”
“لكنني أعطيتُها رقم موبايلك، وستتصل بك مساء. قلتُ لها إنني سأخبرك، وأنها ستتصل بك لتعطيك المحاور…”
“لن أرد عليها!”
“وما الفارق … بين أن تكتب للدكتور “سلمان الإبراهيم” دراساته ومقالاته … وبين أن تكتب كل حين دراسة للدكتورة “نورية”؟ على الأقل هي ستكافئك، بينما لن يعطيك الإبراهيم فلسا واحدًا”.
ربما كنت صفيقا حين واجهتُك بسؤالي الأخير، لكنك كنت وقحا ونذلا حين أجبتني:
“اسمع يا “درش” … هل تريد أن أخبر “سلمان الإبراهيم” عن طلبك هذا؟ بالنسبة لكتابتي له فهي ضمن حدود العمل المؤسسي. الرجل لم يكذب عليّ حين جلسنا معا على شاطيء النيل قبل قدومي إلى هنا. هناك قال لي بالحرف الواحد: أنا أحتاج لمن يصوغ أفكاري قبل نشرها، فهل بإمكانك تعديلها، بالإضافة والحذف، حتى تأخذ شكلها النهائي؟ أجبته إن هذا من صميم عمل المحرر والمراجع والمترجم، وسأفعل ذلك بكل رضى. وحين جئت لم يطلب مني “سلمان الإبراهيم” أن أكتب لسين أو صاد، وأنا أفخر بأنني أصوغ عقل مؤسسة عربية مرموقة يتخطى تأثيرُها مجالَها الجغرافي، فالومضات الحضارية على مر التاريخ لم تنهض إلا على أكتاف الترجمة والمترجمين. لو كان لدي مال يكفي لأنشأت مؤسسة مماثلة، ولكن بما أنني هنا، فأنا أعمل كما لو كانت هذه المؤسسة هي مؤسستي. أنا لا أعمل عند “سلمان الإبراهيم”، بل أعمل معه لصالح المؤسسة العربية للترجمة”.
صحيح أنك أفحمتني ساعتها يا تُرجمان، لكنك لم تطفيء النار التي اشتعلت في قلبي تجاهك. أنت جرؤت على أن تتحداني، وجعلت رقبتي مثل السمسمة أمام الدكتورة “نورية”. وأقسمتُ ساعتها ـ بيني وبين نفسي ـ أن أنهي عملك بالمؤسسة بأية وسيلة، وأنك لن تستمر إلا على جثتي.
ثم سريعا ما بان لي السر، وكُشف المستور. لقد ظننتُ باديء الأمر أنك تسلُكُ دربَ العفة والشرف، والحقيقة أن طريقك حرير في حرير، وهو طريق المستغني. لقد أخبرني الدكتور ” الإبراهيم” بعظمة لسانه، أن بينك وبين الكاتبة “فوز العبدالله” حكاية غرام. وبالطبع يا عَمّ الترجمان، من وقع على جبل ألماس، لن ينظر لتراب الفلوس.
كنت خذنا تحت جناحيك يا ترجمان!
يعني مثلا … أنت تعرف علاقتي بالناشرين، فلماذا لم تعرض على دجاجتك التي ترقد على بيض الذهب أن أعمل لها طبعات ثانية من أعمالها المنشورة؟ كانت ستطلع لي لقمة حلوة، حين أكون همزة وصل بينها وبين الناشرين. الدينار داخل على العشرين جنيها، يعني أطبع الكم نسخة بألف جنيه، وآخذ ألف دينار، لكنك لا تطلب الخير لأحد سواك … كنت سأترك لك نسبة، أو أجعلك توقع عقود نشر لإعادة طبع ترجماتك القديمة، فتستفيد وتفيد!
وكأنك لا تعرف أن حبيتك “فوز العبدالله” ـ بجلالة قدرها ـ كانت تستعين بعمها “دانيال خيرت” في كل شغلها؟ صحيح أنني ألبس نظارة سوداء لحماية النظر، لكنها ضرورية لزوم الفضول أحيانا. إنها ثقب بابي حيث لا يرى أحد أين أتجه ببصري … وهي تريني ما لا يشاهده المحملقون بنظارات سميكة. أنا رأيتُ فوزك هذه بنفسي تُسلم لعم دانيال أوراقا في ظرف، وتتسلم أخرى منه، ولا شك أن هذه النصوص إما كتبها لها “دانيال خيرت”، أو على الأقل وضع بصمته عليها.
قل لي؛ لماذا يحلّ للسيدة “فوز العبدالله” ما لا يحل لغيرها؟ ولماذا يرضى “دانيال خيرت” بما لا ترضى به أنت؟ هل أنت أكبر قامة منه، أو أشهر؟ يا تُرجمان، بعض التواضع كان سينجيك.
لكنني أكلم نفسي، فلم يعد يفيد الندم الذي كنت ستبديه شيئا، هذا إذا استطعت أن تندم يوما. لقد قاطعتُك منذ صددتني، ولم أذهب لرؤيتك منذ نقلوك إلى المستشفى الأول، وحتى حين ذهب الزملاء لزيارتك في المستشفى الثاني لم يطاوعني قلبي على أن أغفر لك. وقلت لمن ذهب:
“وماذا يفيد ذهابكم أوعدمه؟ إنه لا يعي شيئا، ولن يسمحوا لمعظمكم بالدخول”.
لقد أخذ بعضهم على خاطره، حتى أن “أدهم” الشاب الغَرّ قال لي إن قلبي أسود. وهناك من وقف بصفك ولا يكلمني منذ ذلك اليوم، رغم أن الحي أبقى من الميت، ومصيره سيأتي لأعلمه درسا، ولن يبقى له مستقبل إلا على جثتي، وربما تحل عليه لعنتي التي حلت عليك؛ لعنة “مصطفى سند” التي لا تبقي ولا تذر.
المهم، الآن بدأ عهد آخر بعدك، حل مكانك شخص جديد، وأصبحت أنت سطرا من الماضي، وسأكتب أنا السطور التالية في المؤسسة. غدا سألتقي الترجمان الجديد “أحمد عبد المجيد”، في المكتب الذي حرمتني من دخوله عامين كاملين. لقد كسرت قلة، بل حطمت زيرا وراءك، وكنت أحلم بأن يكون مكتبي، لأمحو ما تبقى من آثارك.
هل أبقيت صور “نجيب محفوظ” و”ماركيز” و”دويستوفسكي” في إطاراتها الداكنة على الجدار خلفك؟ هل لا زالت صور شهادات التقدير الممنوحة لك من مؤسسات الترجمة في إطاراتها الزجاجية إلى يمينك؟
كنت تضع صورة ابنتك، بجانب جهازي الهاتف، فهل أضفت إليها صورة حبيبتك جبل الألماس الست “فوز”؟ لا عليك، لقد غادر الجسد وبقيت الصور التي لا تنفع صاحبها شيئا.
لكنني لن أعدم وسيلة أجدها لأهدم تلك الصورة المثالية التي بنيتها هنا، فالإشاعات لن تقف بعد رحيلك، وإنما ستبعث، وستجد دائما من يرددها، كالببغاء. أنت بنيت مجدك من الحقائق، وأنا سأهدمه بالإشاعات. أنا درست الإشاعة كعلم، وأعرف حدودها، ومجال تأثيرها، وسطوة امتدادها، وفي مجتمعات لا تقرأ ولا تدقق ولا توثق، ستشتعل نار التنانين في أطراف أوراق الحقائق والتواريخ، حتى تذروها كالرماد.
يكفي أن تصل رسالة من متظلم إلى “سلمان الإبراهيم”، ليبدأ مراجعة رأيه فيك. لقد أخبرني ـ بعد أسبوعين من مغادرتك الدرامية ـ إنه قد يسعى لوضع اسم ابنتك في كشوف المحققين والمدققين للنصوص. طبعا هذا كرم منه، لكنه كالعادة، كرم ليس من جيبه. وأعدك أن هذا لن يحدث إلا على جثتي.
أعتقد أنه قد يغير رأيه حين يقرأ رسالة مماثلة:
“حضرة صاحب السعادة الأستاذ الجليل والمفكر الكبير الدكتور سلمان الإبراهيم، حفظه الله ورعاه.
تحية طيبة، وبعد،
أشد على أياديكم البيضاء، وأثني على فكركم المستنير، وأثمّن دوركم الفذ في قيادة ورعاية المؤسسة العربية للترجمة، في أرض العروبة، وعاصمة الثقافات العالمية؛ دولة الكويت.
وإنه ليحزنني أن أشكو، ولكنني أكتب هذه الرسالة إلى سيادتكم، بعد أن أن أرسلت أكثر من مرة، طلبا للمشاركة في مؤتمركم السنوي، على البريد الإلكتروني المنشور بموقعكم على شبكة الإنترنت، ولم يأتني رد على ما سألت، رغم أنني أرفقت فكرة البحث، بسيرتي الذاتية، وخبراتي السابقة، وفق ما حدد المنشور.
وحين أعياني الانتظار اتصلت برقم الهاتف الخاص بمنسق المؤتمر، السيد “محسن حلمي”، الذي رد علي بجفاف شديد، وقال إن سيرتي لا ترقى لمكانة المؤتمر والمشاركين فيه.
أنا أعلم مدى حرصكم على إنجاح المؤتمر، لكنني يا سيدي أشك في أنني الوحيد الذي عانى ما عانيت. كل ذلك من أجل أن يدعو السيد “محسن حلمي” ثلة أصدقائه، الذين نرى أخبار مشاركتهم، للعام الثاني على التوالي، في مؤتمركم، ونعرف أن سيرهم الذاتية التي تنشر عنهم مليئة بالترهات والمبالغات.
إنني أثق في عدالتكم، ونزاهتكم، وسماحتكم، وقدرتكم على اتخاذ القرار المناسب”
أعلم يا ترجمان أن رسالة مثل هذه ستهز أركان المؤسسة، لن يدققوا في صدق محتواها أو هوية مرسلها، بعد كل النفخ في صاحبك المدير، فهو كالغانيات يغرهن الثناء، وقد يلجأون إليّ كي يسألونني عن اسم موقِّعها، بحكم خبرتي، وساعتها ستحين ساعة انتقامي منك.
أنا لا أفعل كل ذلك بسبب ما بدر منك تجاهي، فقد كان ذلك مجرد موقف، ولكنني أحسست أنه بداية لمواقف صدامية أخرى، وأنك اتخذت موقفا عدائيا مني، فأصبحت نفقا مظلما سيعترض طريقي، وإذا كان ما حدث لك انتقاما إلهيا، فأنا أعددت الانتقام الأرضي الذي لا يقل إيلاما.
لقد تحدثت مع خائب الرجاء، “محيي صابر”، بعد عودته من زيارته لمرقدك يا إمام المترجمين، وصدق ما أخبرته عن علاقتك الغرامية حين رأى السنيورة تغادر المستشفى، وأعتقد أنه مثلي، لم يكن يحبك، رغم أنه تعود الجبن فصار يبدي عكس ما يضمر، وهو يردد جملته الحقيرة:
“اليد التي لا تستطيع قطعها، قبِّلها”.
كم من الأيادي قبّلها “محيي صابر” في أربعين سنة؟ منذ جئت الكويت قبل أربع سنوات، وهو يقول إنه ملّ الغربة، وقد حان وقت نزوله مصر، نهائيا. وكان زملاؤه الأقدم مني يبتسمون، وهم يسمعون قراره، لأنهم منذ رأوه وهو يعلن القرار نفسه مطلع العام، ثم يؤجله للعام التالي.
حين قال ذلك لك يا ترجمان، سخرت منه وأنت ترد عليه:
“السفر بحيرة رمال متحركة، كلما أوغلت فيها عزّ عليك الخروج منها، وتمنعت طرق النجاة عليك. فكن دائما عند الشاطيء، ومثلما يحرص سائقو السيارات على ترك مسافة بينهم وبين من أمامهم، على المرء أن يحتفظ بمسافة مماثلة، حتى لا يصطدم بالمجهول.
لا تأخذ قرارا لا تستطيع تنفيذه، ولا تتراجع عن قرار أعلنته، حدث نفسك قبل أن تخاطب الآخرين، وحين تقول لهم شيئا كن متأكدا من صدقك، وإلا فقدت مصداقيتك. نحن أسرى زلات اللسان”.
يا لها من حِكَمٍ عطائية توزعها بسخاء، يا حكيم الترجمة، لكنك ـ كمتخابث ـ لم تَزَلْ بلسانك أمامنا لتخبرنا بالحقيقة عن حبيبتك الكويتية. ربما اعتقدت أن كتمانك الأمر سيخفيه عنا، للأبد. ولكننا يوما ما كنا سنعرف، لقد أردتما الارتباط، كما أخبرني “سلمان الإبراهيم” نفسه… هل كنتما سترتبطان سرا؟ ربما كنت ستخدعها، وتتركها معلقة، وتسافر، بعد أن حافظت على المسافة التي أردتها بينك وبين البقاء هنا.
المؤسسة مثل قاعدة الحمام البلدي، صغيرة لا تخفي شيئا من قذارتها، وما لا نراه، تصعد رائحته، وقد فاحت الرائحة الآن، وعلي أن أضرب بالقاضية.