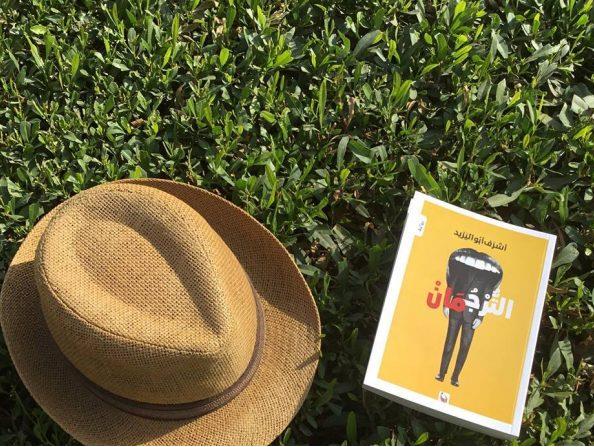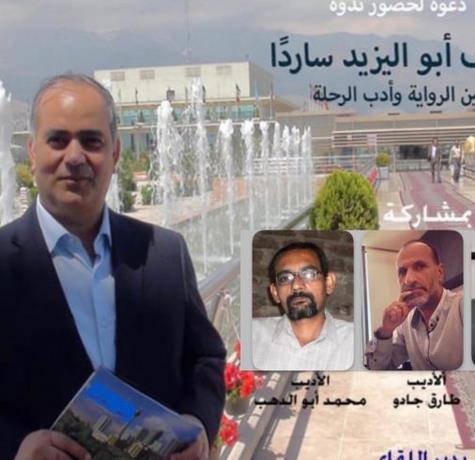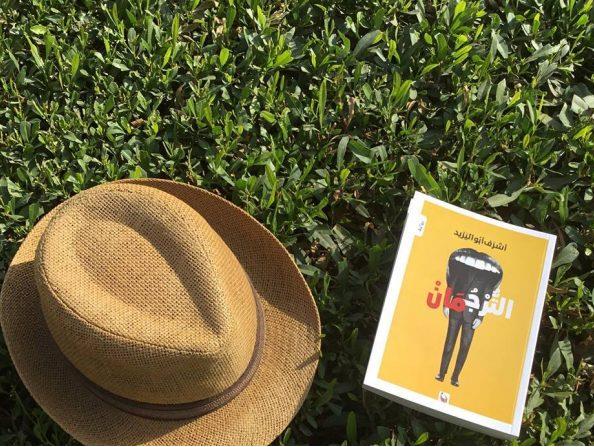
“ما جمعنا أكثر هو ظلم الرجال والقدر معا”
“فوز العبدالله” امرأة ملعونة. لم تعرف رجلا إلا وأصابته في مقتل. أبوها مات في حادث أثناء رحلة صيد، وزوجها اختفى منذ الغزو، والشاعر اللبناني إياه لم تلمس قدماه أرض الكويت بعد فضيحتها معه، وأستاذها في الأسكندرية أصابه ألزهايمر، وأخيرا ختمت بهذا المسكين الذي أتت به من مصر فطاح بالمستشفى، وما عاد يرى أو يسمع أو ينطق.
ظنت “فوز” أنها أفلتت بكل شيء، وأنها أفضل منا في كل أمر. إرث بلا حدود، فيلا في الجابرية، وشاليه في الخيران، ومزرعة في العبدلي، وشقة في القاهرة، وبيت في لندن، وابن يحضر الماجستير في الولايات المتحدة، وناس تكتب لها، شعر مرة ورواية مرة. ولما يطلع في دماغها ترسم … يسوون لها معارض في الدِّيْرَة. ونفتح الراي، أو نشوف القبس، أو نتصفح السياسة، وجهها يطالعنا؛ كأنه لا أجمل منها، وكأن ما في الكويت غيرها، وكأن العالم ملكها وحدها.
أنا نصحتُها، كصديقة لها منذ كنا ندرس في المتوسط، يا “فوز” لا تلعبي بالنار. أنت امرأةُ شهيد. تأخذين معاش شهيد. هل تعرفين ماذا فعلت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين حين عرفت بزواج “سعاد” السري، لقد رفعوا عليها قضية وأخذوا منها ما تقاضته طيلة سنوات منذ اعتماد اسم زوجها بين الشهداء، هذا غير الفضيحة جابتها لأهلها. لكنك يا “فوز” بعنادك المعتاد قلت:
“ما بي حاجة لدنانيرهم، ولن أتزوج في السر”.
ها أنت يا “فوز” خسرتِ الرهان، فقد تسربت الأخبار وقد تحقق معك اللجنة، والرجل، فارس الأحلام، يرقد قرب الآخرة.
بصراحة، لا أعرف ماذا أحببتِ به؟
شخص ثقيل الكلام، وهذا الهدوء الذي قربك إليه لا شك أنه مصطنع. أظهر لك التمسكن حتى تمكّن، فجريت إلى الدكتور “سلمان الإبراهيم”، وأنا أعرفك لا ترتاحين إليه، وأن “الإبراهيم” نفسه لا يرتاح إليك، مثلما لا يرتاح لأحد، لكنك توسلت إليه كي يلتقي الأستاذ “محسن” في القاهرة، وأن يستقدمه للعمل في المؤسسة. الآن استفاد منك الأستاذ “محسن”، جاء الكويت، واشتغل براتب كبير، وعلم ابنته في مدرسة خاصة، وأرسلها للدراسة في كندا، ثم تركك تحترقين.
قبل ظهوره في حياتك، أخبرتك برغبة أخي “نواف” بالارتباط بكِ. قلتُ لك إنه يريدك لنفسه. فاجأني قولك إن “نواف شقي، يلعب بذيله”.
أنت ساذجة يا “فوز”. وهل هناك رجل لا يلعب بذيله؟ هل تظنين أن الأستاذ “محسن” ملاك نازل من السماء؟ زوجي نفسه كان يلعب بذيله، لكنه كان حريصا على كرامتي فلم يفعل شيئا بعلمي، رغم أنني كنت أضع عليه الجواسيس. كان يلبي حاجاتي. الرجال وجدوا لهكذا مهمة؛ تلبية حاجات زوجاتهن. أنت أردت الخروج على الناموس؛ أردت أن تلبي حاجات زوج المستقبل، فأين أنت يا “فوز”؟
بالأمس التقيت الصحفية التعسة “شادن” في مجمع مارينا مول، هذه السلعوة البدون، بدا لي أنها تتلصص على أخبارك، جابت اسمك في كم جملة عرضية:
“هل قرأت شيئا جديدا لفوز العبدالله؟”
“هل توقفت فوز العبدالله عن الكتابة؟”
هل رأيت خبر الأسبوع الماضي في جريدة القبس عن فوز العبدالله؟” …
بدا لي أنها تعرف شيئا عن نقلك الأستاذ “محسن” من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى هادي، وأنك ربما تزورينه هناك. لكن أظنها لا تعرف شيئا بعد عن فكرتك الأكثر جنونا، ورغبتك بنقله إلى بيتك، فهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام. عليك أن تعودي إلى صوابك. الكويت ليست لندن أو باريس. حتى في القاهرة لا يعد ذلك مقبولا، فما بالك هنا؟
أمثال الصحفية البدون “شادن” كثيرات وكثيرون، وهي بالذات تحفر وراءك من زمن، وأصبحت الكراهية مضاعفة، لأن الأستاذ “محسن” حكى لك عن دعوتها له، وعدم ذهابه، بناء على علاقتك السيئة بها. أنتما الآن في خانة أعدائها.
لكن، دعيني أسألك، من أنت لتتحملي مريضا في غيبوبة؟ أنت مرفهة يا “فوز”، ولن تتحملي ما مررت به أنا حين مرض زوجي عامين كاملين، رغم أنني لم أكن أمرّضه بنفسي. جاءت أخته، وأمه، وخيَّمَتَا في البيت، حتى قضى ربك أمرا كان مفعولا.
كانتا تعرفان أن دمه تلوث، لا شك أنها جرثومة انتقلت له أثناء عبثه هنا أو هناك. لكنني انتقمت لنفسي. ولحسن الحظ كان عقيما، لم يكن لدينا أطفال يذكرونني به، وأحمل همهم، ولن يظهر فجأة ولدٌ له، من امرأة أخرى، يفاجئني بأنه يريد إرث أبيه.
وعلى ذكر الأبناء، ما شاء الله على “خالد”، وَلَدِك. صحيح أنه في البعثة، لكنه سيعود عاجلا أم آجلا، فهل أعددت نفسك لهكذا لحظة؟ بعد عشرين سنة من الصبر يا فوز، تصومين وتفطرين على بصلة؟
قلت لك إن الله ينذرك، وما مرض الأستاذ “محسن” إلا إشارة تحذير إلهية، حتى لا يكتمل الموضوع. لقد اعتقدت أنك فهمت الإنذار. أنت لا تعاندين لجنة الأسرى وحدها، ولا تعاندين ابنك فقط، ولا تعاندين نفسك وحسب، بل تعاندين ربك، والعياذ بالله. المؤمن يأخذ هذه الإشارات ويتعظ، ويتدبر، وأنت تمرين عليها مرور الكرام.
تذكرين حين حدثتك عن الرؤيا التي حلمت بها، ولم تتقبلي ما حكيته لاحقا عن سيرة العرافة التي فسرتها لي.
وحين استأذنت منك، وأخذت محرمة تخصك، وشالا ترتدينه، وخصلة من شعرك، ذهبت إليها، عرافتي “سر العيون”، فهذه المرأة لم تسقط نبوءاتها أبدا. لقد التقيت مغربيات كثيرات، وتعرفين عمق صداقتي بهن، وحين عرّفْنَني على “سر العيون” ظننت أنني سأقضي وقتا مرحا، أسمع منها طرائف، ونوادر، وأعود لحياتي، لكن “سر العيون” غيرت رأيي تماما.
منذ اليوم الأول قرأت أشياء في كفي لم أكن أبوح بها لنفسي. هل تعرفين أن أبي تزوج مرة سابقة في القاهرة أثناء الدراسة؟ بالطبع لا، فأنا ـ رغم عشرة عمرنا معا أكثر من ثلاثين سنة ـ لم أبُح بذلك السر أبدا. لقد كان زواج طلبة انقضى بانقضاء سنوات التعليم. وكان غارقا في أحلام القوميين العرب والنضال، وأفاق. لكن ذلك الأمر بدا عند “سر العيون” مجرد سطر مقروء في فاتحة كتاب ظاهر ومكشوف تعرفه عني.
أنا أعطيتها المحرمة والشال وخصلة الشعر، وأخبرتها بأنك لا تريدين المجيء، ورجوتُها إن استطاعت أن تقرأ شيئا من أثرك. أمسكت “سر العيون” بأغراضك، وضفرتهم معا كجديلة شعر، ووضعَتْهم على جبهتها، وأغمضت عينيها، حتى رأيت العرق يتصبب من وجهها، وفجأة رمت بهم كأنها تدفع شرا، وهي تصيح:
“هذه حرب بلا فوز!”
والله يا “فوز” ما أخبرتها باسمك، ربما كانت استقصت عني عند صديقاتي الكثيرات، لكن الأمر لم يقتصر على الاسم، لأنها قالت لي بالحرف:
“لو صاحبتك غالية عليك، انصحيها بالبعاد، إنها تقترب من النار يوما بعد يوم، وهي تدور حول شمس لا ترحم، لكأنها فراشة أسيرة اللهب … عليها أن تنجو بجناحيها”.
اليوم قلتِ لي إنك مسؤولة عما جرى للأستاذ “محسن”، فلولا استقدامك له من مصر لما أصيب هنا. عجيب أمرك يا “فوز”، هذا قضاء وقدر، فهل أنت القضاء أم القدر، أم هما معا؟ لقد شاء قدره أن يلتقيك، وكتب عليه أن يسافر، وقدر له أن يسقط بالجلطة، يعني مرّ بالطيب والرديء، وإذا كنت سببا في مصيبته، فانظري إلى ما قدمت إليه من خير.
هل كان سيستطيع أن يرسل ابنته للدراسة في كندا؟ صحيح ليس عندي أولاد، لكننني أعرف كيف يحرص المصريون على أولادهم، يأخذون اللقمة من فمهم كي يضعونها في فم عيالهم. ربما كانت رسالته في الحياة قد اكتملت، وأرسلك الله له لكي يتم رسالته بالنسبة لابنته. وإذا كنت تريدين الخير، فأرسليه لمصر، يموت وسط أهله، وخصصي نفقة لدراسة ابنته، يا بنت الكرام.
أنا زرته مرة واحدة معك في مستشفى هادي، ولم أستطع أن أكررها. كان هذا الرجل الراقد هناك غير الذي عرفته. لعن الله المرض. ذكرني برقدة زوجي. لكن زوجي كان يتكلم. كان يطالع الناس بعينيه. كان يتحرك للضرورة. أما هذا فكان كالأجهزة المتصلة به، مثل الجماد.
ظللت أياما لا أستطيع أن أقول لك ما أحسست به، وحين صارحتك غضبت مني. أعلم أن الحقيقة مرة، ولكن الكذب مرارته في القاع، وسنصل إلى الحقيقة مهما أخفيناها. الأستاذ محسن مات إكلينيكيا، ولو أنه في بلاد أوربا لطبقوا عليه نظرية الموت الرحيم.
يا ليت تتصلين بأهله، بأمه أو أبيه أو أخيه، لا شك أنهم يسألون عنه بعد أسابيع من انقطاع اتصاله بهم، قولي لهم عما جرى له، ورتبي لنقله، سيموت هناك بكرامته. أنت تعرفين المصريين حين يغيب الموت أحدهم هنا، وكيف يتكاتفون معا نقل الجثمان، ويلمون لبعض الدنانير، كأنهم يعتقدون أنه لو دفن بالصليبخات لن يدخل الجنة، وكأن كلهم فراعنة، يريدون أن يدفنوا ميتهم الملك بالهرم المخصص له!
هل كلامي قاس عليك يا فوز؟ الأكثر قسوة هو تأجيل فعل ما يجب فعله.
هل أذكرك بمشاعرك تجاه زوجك “بدر”؟ كيف كنت تعبدينه؟ كيف بدأت قصتكما في لندن؟ كيف كنت تحكين لي بالساعات عن صفاته الزين؟ السنوات فعلت ما فعلت. جعلت الجروح تندمل. غيابه كان قاسيا، لكنك اعتدت غيابه. وغياب الأستاذ محسن قد يكون أكثر قسوة، لكنك ستعتادينه.
سنشغلك عنه، مثلما شغلك عنا السنوات الماضية. سنجمع الرّبْع المشاكس مرة أخرى ونعود للنشاط. النميمة هي مذهبنا الأول، فتيات القوة؛ “فوز العبد الله” … “صباح الحمود” … “شهلاء الطايع” … وأنا، قائدتكن بلا منافس؛ “زوينة الصالح”. منذ اجتمعنا في المتوسط، والثانوي، وحتى حين فرقتنا الدراسة الجامعية، كانت لنا أوقاتنا معا. سافرنا معا. ذهبنا للأسواق معا. ونفطر على الخليج بالمارينا كل نهار جمعة، معا.
ما جمعنا أكثر هو ظلم الرجال والقدر معا. أنت فقدت “بدرا” بعد الغزو الغاشم، وأنا مات زوجي بعد مرضه الخبيث، و”صباح الحمود” أصبحت عانسا، و”شهلاء الطايع” فشلت في زواجها مرتين، قال زوجاها إنها مسترجلة. وهي الآن تربي ابنتها، من زواجها الثاني، وأشاهد فيها “شهلاء” في شبابها.
والله يا “فوز” كنت أتصور أنا وصلنا إلى سقف الخيال في الشقاوة، لكن ابنتها وصديقاتها تفوقن علينا، وأصبحنا، بالنسبة إليهن، موضة قديمة، لازم نتعلم من الجيل الجديد.
“موضي”؛ ابنة “شهلاء”، كانت تقيم حفلا في حديقة الفيلا كل أسبوع، تعزم فيه صديقاتها. المهم كانت البنت تمنع أمها من التواجد في الخيمة التي تجتمع فيها البنات. “شهلاء متحررة”، وقالت ما المانع، أتركها بحريتها مع زميلاتها، بنات مع بعضهن. لكن الفضول كان يقتلها. كانت تتمنى أن تعرف ماذا يدور في خيمة دارها ولو دفعت مليون دينار.
قبل الحفلة الأسبوعية الأخيرة الأسبوع الماضي راحت اشترت كاميرات صغيرة، كالتي يعلنون عنها لمراقبة الأبواب. وجابت المتخصص يركبها ويخفيها.
لما البنات اجتمعن، شغلت “شهلاء” الكاميرات. وأخذت تتفرج وتسجّل. المصيبة أنه البنات كان معاهم شنطات اعتقدت صاحبتنا أن بها عصائر ومأكولات، كما كنا نفعل أيام زمان. لكن الملعونات كن يخفين بالحقائب ملابس تنكرية، وفي نصف ساعة، بقى عندك في الخيمة ثلاثة أولاد وثلاث بنات. وبدأن يتصرفن معا كما يفعل الأولاد والبنات بعيدا عن عيون الأهل!
“موضي”، كما تذكرينها، مسترجلة قليلا، مثل أمها، وإذا بها في الخيمة تلبس كالرجال، وترسم فوق شفتيها شاربا. وهات يا قبلات في فم صديقتها السمينة. كانت تقبلها، وهما تتقلبان وتتدحرجان معا. تشابكت أيدي البنات في شهوة، وأخذت أياديهن الصغيرة تضرب الأثداء بعنف. ثم قامت إحداهن بوصل هارد ديسك في شاشة التلفزيون، وشغلت فيلم بورنو. بعدها أخذن يقلدن اللقطات الماجنة، حتى لقد أحضرت إحداهن عضوا بلاستيكيا بالفعل، ربطته حول خاصرتها، ثم أخذت الفتيات يضعن عليه العسل والقشدة، قبل أن يتناوبن لعقه!
في اليوم التالي نادتني “شهلاء” أشوف معها الكارثة المسجلة بالصوت والصورة. بكت “شهلاء” في صمت وأنا أراقبها. أخذتها في حضني، وذكرتها بأوقاتنا معا. صحيح أننا كنا شقيات، لكننا لم نكن أبدا فاحشات. كان أقصى شيء ماجن نفعله حين كنا نشتري المجلات اللبنانية والمصرية المصورة من المباركية، ونقص صور نجومنا المفضلين، ونقبل وجوههم. حتى حين دخل الفيديو كاسيت استهوتنا أكثر الأفلام الهندية التي لم يكن يسمحون فيها آنذاك بالقبلات. وكنا نقلد رقصات البنات وهن يكشفن عن بطونهن.
انفجرت “شهلاء” بالبكاء. ظنت أنها السبب، لأن “موضي” تعيش مع أمها في بيت بلا أب. وماذا كان سيفعل الأب يا “شهلاء”؟ هل كان سيقتحم الخيمة على البنات؟ هل كان سيفكر في مراقبتهن كما فعلت؟ الرجال لا يريدون تحمل أي مسؤولية. يرمون في وجوهنا بالدنانير، ويعتقدون أنهم أتموا مهمتهم. يلفون يعبثون، ويعودون لمصالحتنا بعطر غال أو قطعة أثاث نادرة، يرمونها في ركن هنا أو هناك، مثلما يتركونك وحدك.
ثورة الإنترنت يا “شهلاء” ضربتنا في مقتل. كل يوم نقرأ عن أشياء عجيبة غريبة. هذا الفضاء المفتوح صب علينا زيت العهر. صناعة الجنس، كما قرأت، لا تقل إيراداتها عن الصناعات الكبرى. أفلام، وأغراض، ومنشطات، وخدمات جنسية. تصوري حكى لي زوجي مرة أن الحلاقين في الكويت الآن يقدمون خدمات جنسية بشكل مستتر. أندية المساج أصبح عددها أكثر من المساجد. لكن علينا أن نفكر كيف نبعد موضي تدريجيا عن هذا الجو الشيطاني.
فكَّرت “شهلاء” أن نسافر معا، ونأخذ “موضي”، نفرجها على الدنيا، ونفرحها. لكنني أخبرتها أن الصبية سيصيبها الضجر، فنحن بالنسبة إليها عصابة من العجائز اللائي أجهضت أحلامهن. لقد اقترحت عليها أن تشركها في نادٍ للفروسية. وأن تعدها بشراء خيل إن هي أحبت الرياضة. تعرفين كيف يمكن أن تهذب الرياضة النفس، ويمكن تكون صحبة الخيل أفضل من صحبة بنات الشر.
فكري معنا يا “فوز”، كما كنا نفعل دائما، ولا تنسي أنني ذات مرة قلت لك إن أنسب شيء لخالد أن يرتبط بابنة “شهلاء”، على الأقل ستكون حماته صديقة عمرك. هل لا تزالين تفكرين بالأستاذ “محسن”؟ لا أعتقد أن الحب الذي كنت تكنين له هو نفسه ما تشعرين به الآن. هذا الذي تفعلين ليس سوى إحسان، ولا يمكن أبدا أن يكون حبا. ما لديك هو مزيج من العطف، والكرم، والمواساة، مثلما تشعرين حين تلتقين بائسا، وليس حيا.
الحب ـ وأنت سيدة العارفات ـ عطاء متبادل، وأنت تحبين بلا أمل، وليس لدى الطرف الثاني أدنى فكرة عن مشاعرك. ليست لديه القدرة على مبادلتك أي فعل أو إحساس. أنت أصبحت مثل الفراعنة الذي يقدسون المومياوات. ليست هذه قسوة قلب خاو يا “فوز”، ولكنها الحقيقة التي لا تودين سماعها، والواقع الذي لا تريدين الاعتراف به، والمستقبل الذي لا ترغبين بالنظر إليه.
لقد أخذت لك موعدا مع “سر العيون”. لا شك أنها حين تراك ستتبحر أكثر. ربما تنبأت لك بخير، من يعلم؟ لكن يجب أن تأتي معي، ولو على سبيل أن تفرّجي عن نفسك. لا يجب أن يقتلك اليأس، أو يطفيء نور عينيك الألم. سنواتنا الطويلة معا علمتنا أنه ما في حال يبقى على ما هو عليه، وسبحان مقلب الأحوال والقلوب.