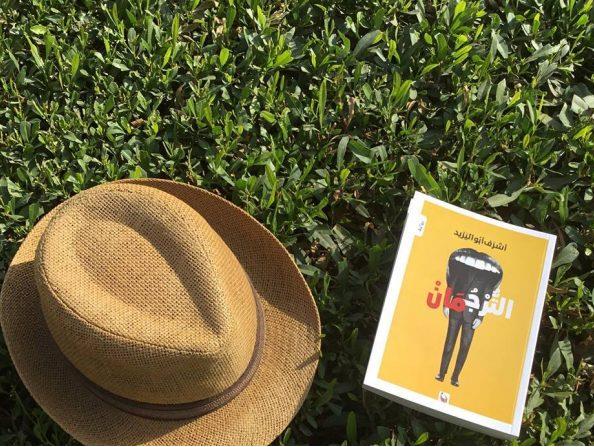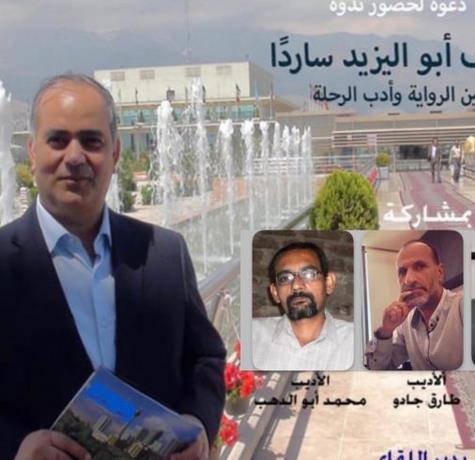لماذا شعرتُ نحوَه بتلك الكراهية، منذ اليوم الأول؟ يبدو أن هذا الشخص أخبث مما ظننت. اعتقدت أنه لن يأخذ مني غلوة، لكنه تملص كثعبان متمرس.
منك لله يا دكتور “سلمان”، أين تجد مثل هؤلاء؟
أنا صاحب العشرة الطويلة الذي لم تأتمنني حتى اليوم، رغم كل ما قدمت إليك، ولا تزال تذكّرني بالمرة الأولى التي التقينا فيها في جاليري الشاهر.
صحيح أنا كنت أصنع الإطارات للأعمال الفنية، لكنني كنت قبل ذلك، ولا أزال، وسأظل، فنانا تشكيليا. لقد رضيت بعقد عمل كمدرس رسم هنا لأن الحياة في مصر قاسية بالنسبة لرسام مبتديء. لم يكن معي مال لأشتري مساحة خاصة بأستوديو حلمت به. غرفتي في بيت أبي ضاقت علي، وخاصة حين علمت أن أخي الأصغر يريد أن يتزوج بها. هربت إلى الكويت، وأحلم بالعودة يوما إلى الساحة التشكيلية في مصر، حلم عمره خمس وعشرون سنة.
ماذا أقول لك يا دكتور “سلمان”؟
أنا الذي عرَّفتُك على الفنان الكبير في وزارة الثقافة، والآن أصبحتما سمنا على عسل. استطعت أن أدعوه إلى الكويت، عبر المؤسسة، وقدمت له خمسة معارض، باع فيها بالملايين، وأنت عمولتك كانت المكانة المحفوظة لك في مصر تنزل معززا مكرما، حتى أنك قلت لي، حين عرضت عليك شراء شقة في القاهرة:
“يا محيي، أنا أملك مصر كلها، فما حاجتي فيها إلى شقة بها؟”
أذكر أنك حكيت للرجل الكبير عن عشقك لجمال عبد الناصر، باعتبارك قوميا وعروبيا عتيدا، ولم يكذّب الرجل خبرا، وجدته يتصل بي ذات يوم، قائلا إنه يعد مفاجأة لك، وحين التقيته بعدها في إجازة بالقاهرة، وكنا في فيلته المطلة على النيل، نادى على “نمر”؛ خادمه الأسمر، وهمس له بأمر ما .
غاب النمر وعاد بفريسة في صندوق ضخم … فتحه، ولم يكن داخله غير التمثال النصفي لعبد الناصر، المصنوع من البرونز، للفنان “جمال السجيني”، وقال لي:
“هذه هدية للدكتور سلمان، ومهمتك الآن أن يصله هذا التمثال النادر صاغا سليما”.
أذكر أنني أعطيتُ قاعدة التمثال لأحدهم، يسافر بها إلى الكويت، وسافرت أنا برأس “جمال عبد الناصر”، لتحتفل أنت به، كما لو كان عبد الناصر نفسه قد عاد للحياة مرة أخرى، وقلت لي ساعتها:
“كان الأمير آخر من رأى عبد الناصر حيا في مطار القاهرة، وأنا الآن أول من يراه يبعث من جديد هنا في الكويت”.
أنت نسيت ذلك، أو تتناساه، حتى لا تحس بأي واجب تجاهي، لذلك حين قلت لك أريد المكتب بجوارك، رددت:
“ومن سيأخذ باله من هؤلاء الجرذان؟”
حاولت أن أفهمك أنني لست قط شوارع، أتلصص على جرذانك، لأنقل لك ما تيسر، رغم أنك لا تأخذ رد فعل، كأنك تتلذذ بتلك اللعبة بين القط والفئران. لا أنكر أنك أعطيتني علاوة مئة دينار، ولكنك احتفظت بالخصوصية لشخص لم تعرفه إلا منذ أيام، اسمه… “أحمد عبد المجيد”.
ربما كنت تظن أنه سيظل مثل الترجمان، كاتم سرك، وكاتب أوراقك، وخبيرك الأدبي. أنا أشك في ذلك.
حين هاتفتك أخبرك عن لقائي به، وتحرزي منه، ضحكت طويلا، وتمثلت أمامي صورتك وبطنك الصغيرة تهتز، وأسنانك الصفراء تبتسم في خبث، وتقول لي:
“يا محيي، ما من نخلة إلا وهزتها الريح، أنا أعرف مربط فرس عبد المجيد، مثلما كنت أعرف مربط فرس الترجمان. هنا لا أحد ينجو من بحر الرمال، وإلا، فالباب يتسع للجمل وما حمل”.
أعرف كيف تكره الجمال، وتغضب حين يرمزون للمنطقة بالجمل، لكن غضبك الخفي لم تكن تقصد به “أحمد عبد المجيد”، وإنما كنت تقصدني أنا. كم من مرة حين غضبت قلت لي ذلك. الباب يتسع للجمل وما حمل!
لكني أذكّرك بما قلته لك سابقا عن تخوفي من “مصطفى سند”. هذا الضفدع الماكر بشَوَّافتيه السوداوين، وقلبه الأكثر سوادا. كنت تقول لي، إنه بوابتك إلى كل باحثي مصر الذين تحتاجهم في عمل المؤسسة. ثم أغدقت عليه، قبل أن أكتشف أنه يبيعك حرفيا للآخرين. هؤلاء الذين يقترحهم عليك للمجيء في الندوة السنوية مجرد أنصاف باحثين. علاقاته معهم هي المفتاح الذهبي لحضورهم.
تأمل يا دكتور قائمة الضيوف في ثلاث سنوات اقترحها عليك:
“رجاء المنياوي؟” إنه الناشر الذي يطبع له كتبه.
“هند القدوسي؟” إنها شقيقة زوجة أخيه، التي قال لك عنها إنها تعمل في التلفزيون، وهي لم تُعِد سوى حلقة يتيمة عنه هو شخصيا في برنامج مجهول تبثه القناة الثانية في الثالثة صباحا.
حتى أنك حين اقترحت عليه تكريم الناقد الكبير “دانيال خيرت”، بعد ترشيحه من الكاتبة “فوز العبدالله”، قال لك إنه مسيحي، وهذا سيثير عليك غضبا كبيرا في البلد لتي يتحكم فيها المتشددون بمجلس الأمة، وأن الرجل عجوز قد لا يستطيع السفر، وربما يموت على الطائرة.
ساعتها جاءتني الكاتبة، لأنها تعرف صداقتنا الممتدة لربع قرن. حكت لي كيف أنها كانت ترى “مصطفى سند” دائما على مائدة “دانيال خيرت” في الإسكندرية، يأكل ويشرب، ولا تغادر يدُه طبق المكسرات، ولا يأتي بهدية إلى الجلسة أبدا. شعاره أن يأخذ فقط. عدت إليك مجددا في أمر تكريمه، فقلت لي:
“شوف يا محيي … الست فوز تريد حضور دانيال خيرت لأنه هو الذي كان يكتب لها قصصها. أنا أعرف عنها وعنه أكثر مما لديك. ركّز أنت مع الفنانين وحسب، لأن مصطفى سند أدرى منك بكتاب مصر، مثلما أنت أعلم منه بالفنانين منه”.
مخاوفي ستصدق يا دكتور “سلمان” ذات يوم، ولكن ساعتها سيكون الوقت قد فات، ولن ينفع الندم.
لقد ناديتُ على “شنكر”، بعد ما أنهيت معك المكالمة. “شنكر” يعرف أنه لا يمكن أن يلاوعني. سألته عن “أحمد عبد المجيد”، فقال لي إنه استولى على جهاز الترجمان. أخشى أنه الآن لديه كل ما كان الترجمان يحتفظ به من كتابات وأسرار، إذا استطاع فك شفرة الكمبيوتر والملفات.
حين دخلت إلى غرفته رأيت الجهاز مفتوحا، لكن لم تتح لي فرصة النظر إلى شاشته. تعرف كان الترجمان حريصا على أن يكون وجه الشاشة له وحده، ولن يرى الشاشة إلا الجالس على مكتبه. ليتك انتظرت يا دكتور حتى تعود قبل أن يدخل “أحمد عبد المجيد” غرفة الترجمان، ويستولي على أوراقه.
أعرف أنك دخلت الغرفة مرارا، ولكنك لم تفتح الكمبيوتر، فأنت عدو هذه الأجهزة الجديدة. أنا مثلك أرى أنها حطمت الفن، وأصبح الفنانون الجدد أبناء الفوتوشوب أكثر من كونهم أبناء الطبيعة الصامتة، والموديل الحي.
لم أكن وحدي الطامع في مكتب الترجمان، كان هناك “مصطفى سند” نفسه، وألح عليك أكثر مما فعلت أنا، لكنك رفضت. وكان هناك المحاسب المخضرم ورفضت. ولم تستجب حتى لطلب “حمود المضيفي”، هذا البغل الأسترالي، الذي لم يكن لديه سبب وجيه في أن يرث المكتب سوى أنه كويتي، يحق له ما لا يحق لسواه.
نحن مخلصون لك يا دكتور “سلمان”، لكنك تشك فينا جميعا. زلات لسانك حين تشرب تكشف عن ذلك الشك القاتل. أعتقد أنك تشك حتى في نفسك. تستعملنا جميعا، مثلما يستخدم أحد المناديل الورقية، قبل أن يرمي بها بلا مبالاة.
حين نقلوا الترجمان إلى مستشفى مبارك الكبير، كنت أنت في المبنى. وصلني الخبر، فنقلته فورا إليك، ولم يبدُ عليك الانزعاج بالدرجة التي توقعتُها، لكن الأمر المأساوي ـ بالنسبة لي على الأقل ـ أنك لم تزرْه هناك، ولا حتى حين عرفت أنه نقل إلى مستشفى هادي، في العناية المركزة، بل قلت لي:
“فوز معها فلوس لا تعرف كيف تصرفها. والترجمان حالته ميؤوس منها. ولو تركَتْه في مبارك الكبير لوفرت تلك الفلوس لنقل جثمانه لأهله. لحسن الحظ أن ابنته سافرت قبل إصابته. ربنا معها. ممكن نشوف طريقة نبعث لها قرشين مكافأة نهاية خدمة أبيها، أكيد ستحتاج لمصاريف هناك.
المشكلة أن الروتين لن ينهي أوراقه قبل شهور. ولكن طالما هو حي، ويعالج، سيظل يأخذ راتبا لثلاثة أشهر، إلا إذا أبلغت أنا عن انقطاعه عن العمل. سأتريث، ربما يقضي الله أمرا كان مفعولا”.
يا لها من قسوة يا دكتور “سلمان”. هذا الرجل كان لصيقا بك، محبا لك، هكذا لمستُ في تفانيه بالعمل، وأنت الآن تتحدث عنه كما لو كان مجرد سيارة خردة حان وقت رميها في السّكْراب، أو حصان مريض وجب إطلاق رصاصة الرحمة على رأسه.
لم يعلم كثيرون أن الترجمان نقل إلى مستشفى هادي، ومن عرف لم يدرك كيف استطاع توفير ما يكفي للعلاج بمستشفى خاص.
حفنة من عرفوا لمَّحوا إلى أن الدكتور “سلمان” ربما يكون من ينفق على علاج الترجمان. لكن ذات يوم جاء “مصطفى سند” إلى مكتبي، وخفض رأسه وصوته، ومال على أذني هامسا:
“عرفت يا محيي الحكاية برمتها. صحيح، ما الحب إلا للحبيب الأول!”
حكى لي “مصطفى سند” عن قصة حب الترجمان والأديبة “فوز العبدالله”:
“أنا صحيح هنا من أربع سنوات، لكنني كنت شاهدا على الغرسة الأولى. كنت في أجازة، ورحت أزور الأديب السكندري دانيال خيرت، لأنني ما كنت أترك مجلسه الأسبوعي قبل السفر. هناك جاءنا الترجمان، وكانت فوز العبدالله معنا. وأنت عرفت الترجمان … لسانه حلو. يقول كلاما كبيرا وفضفاضا. وشكله شبَك مع فوز، فهو خبيث، وهي أرملة، وجميلة، ووحيدة، وكويتية، وثرية. ويبدو أن الشرارة كانت سريعة جدا. لأنه بعد هذه الحكاية بأسابيع قليلة من عودتي للكويت وجدت الدكتور سلمان يسألني عن رأيي في الترجمان.
بصراحة قلت له كلاما جيدا. فأنا أعرف أن الدكتور سلمان يشكّ في ظله، ومعنى أنه يسألني، سيسأل عشرة غيري. وقعدت أفكر لماذا بالذات سأل عن الترجمان. وجاءتني الإجابة على طبق من ذهب، فمنذ وصول الترجمان بدأت قدما فوز تأتيان بها إلى باب المؤسسة، وتعتادان دخول مكتبه هو شخصيا.
ربطت الخيوط. وحين سألته مباشرة أنكر. رغم أنه يدرك أنني أوصيت به عند الدكتور سلمان، لكن ماذا تفعل بنكران الجميل؟”
في المرة الوحيدة التي ذهبتُ فيها لرؤية الترجمان في غرفة العناية المركزة بمستشفى هادي، لمحت طيف “فوز العبدالله” تغادر المصعد في طريقها للخروج، وتأكد لي آنذاك صدق وسوسة “مصطفى سند”.
المؤسسة أصبحت دارا للوساوس، طالما يقودها الشكاك الأكبر. الكل يمثّل على الكل. تمنيت أن يأتي يوم أفتح فيه الباب بغضب، لأصرخ في وجه الدكتور “سلمان” بالحقيقة التي أخفيها منذ عرفته على حقيقته:
“أنا لم أعد أطيق هذا الوضع. يكفينا خداعا. أريد حريتي التي استلبتها مني حين انتقلت للعمل تحت إدارتك. لم يعد هذا وضعا محتملا. نظام الكفيل في القطاع الخاص أهون من وضعي؛ الخليط من العمل بالحكومة والسخرة لدى كفيل.
أنت كنت تحلم وكنت أنا من يحقق هذه الأحلام. انظر إلى مقتنياتك. لم يبق اسم لم تأخذ منه لوحة. أنت تزيد رصيدك من الأعمال الفنية، وأنا أخصم من رصيد ثقة الفنانين بي، حتى كاد رصيدي أن يصبح صفرا. سأتركك أنت ومؤسستك وبلدك كلها…”
لكنني ـ كما تأكد لك يا دكتور “سلمان” ـ أكثر جبنا منك. لقد خضتُ في الرمال المتحركة حتى وصلت إلى منتصف المسافة بين بري الأمان، ليس في العمر ما يكفي لأكمل حتى النهاية، وليست لدي الشجاعة الكافية حتى أسبح عائدا إلى البداية، هذه الرمال ستبتلعني، كما ابتلعت الذين سبقوني.
سنغرق رافعين أيادينا بحفنة من الدنانير، لكنها لن تصبح طوق نجاة أبدا.
هذه التقارير التي تجبرني على روايتها عن زملائي أصبحت تأتيني كل ليلة مثل الخفافيش الملطخة بالحبر الأسود. الكلمات تحولت إلى بقع سوداء، وأنت تبتسم، تفرح كروماني يراقب المتصارعين في ساحة الكوليسو، أنت أشبه بهؤلاء المتحلقين حول لوحة الجورنيكا، يتأملون المأساة المفجعة وهم يرتدون ملابسهم الأنيقة، يتحدثون عن القتلى بدماء باردة، وبعضهم لا يتذكر من بابلو بيكاسو سوى صلعته الشهيرة.
كلما حدثتك عن بيكاسو قلت لي:
“لكنه كان يماثل ثورا في ممارسة الجنس!”
أعرف أنك كنت تفضل الحديث مع “منصف أنور” لعشقه تلك اللغة المبتذلة. يحكي لك النكات الجنسية الفجّة، وأنت كعنِّين تقهقه بصوت عال، كأنه يدغدغ لك خصيتيك. تعيد رواية نكاته الأخيرة حتى يأتي لك بالجديد، ويوهمك أنه يشتري النكات خصيصا لك. وكنت تصدقه، فأنت لا تصدق سوى الترهات.
إن “منصف أنور” نفسه مجرد مسخة. مازوخي حتى النخاع. لا يسخر من الآخرين وحسب، وإنما يمعن حتى في السخرية من نفسه. يضحك حين تسأله عن علاقاته الزجاجية المهشمة على حجر الخيانة. أنا والآخرون شاهدون على صمته المريب حين تتحدث عن زوجته الأولى، لكنك قد لا تعرف أنه لا يزال يحبها. لا تعرف أن السخرية قناع كبير يخفي به مأساة أكبر. فكل امرأة أحبها خانته، وهو نفسه الذي قال لنا ذات لحظة مكاشفة:
“أنا جئت الكويت لأنسى. ماء الكويت لا يسقط الشعر فقط، ولكنه يسقط الذكريات في بالوعة السنوات… علينا ألا نبحث في المجاري أكثر مما يجب. تكفي الرائحة”.
لا شك أنه كان يشير إلى ما يتناهى إلى سمعه من تلاسن عن مآسيه في الهوى. كان يريد منا أن نكف. يبدو أنه كان يعتقد أن السخرية منه ميزة غير متاحة إلا لكفيله فقط.
ماذا فعلت بنا يا دكتور “سلمان”، جئناك مرضى لدينا أمل بالشفاء، وتتركنا موتى بلا رحمة وتضن علينا بالكفن الكريم.